التعليم الالكتروني هو التعليم المعتمد على التقنيات الالكترونية وبواسطة شبكات الاتصال العالمية، ويمكنك البدء بالتعلم عن بعد مع منصة مكان التي توفر لك كل ما تحتاجه للوصول الى العلم والمعرفة.
يتضمن تقرير فحص التربة خرائط تبين مواقع نقاط الفحص
يقدم الاستشاري (۳) نسخة من تقرير فحص التربة إلى رب العمل
اعداد التقرير الأولي – preliminar report ويتضمن مايلي :-
- دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة ومتكاملة عن مشروع مجاري القضاء أو الناحية وفق أحدث خرائط التصميم الأساسي.
- للقضاء أو الناحية والمسوحات والمعلومات والبيانات والاحصائيات السكانية .
- ارفاق خرائط تبين موقع القضاء أو الناحية بالنسبة للمحافظة وأخرى بالنسبة للعراق.
- تحديد سنة الهدف التصميمية وبيان الكثافات السكانية للمناطق المطلوب تصميم شبكات مجاري الصرف الصحي التي تخدمها بموجب الطرق الاحصائية.
- دراسة واقع حال القضاء أو الناحية من الناحية الطبوغرافية والمناخية ودرجات الحرارة والرطوبة وزمن وشدة تساقط الأمطار على مدى فصول السنة وكذلك دراسة الرياح السائدة.
- دراسة المسوحات التي تجري للقضاء أو الناحية وللاحياء مع تحديد B.M لكل حي وتوضيح ذلك بمخطط على الصورة الجوية للقضاء او الناحية
- يجب أن يتضمن التقرير كافة الجداول والبيانات والمنحنيات والاحصائيات والمعادلات العلمية التي يتم الحساب بموجبها لتصاميم شبكات مجاري مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ويشار الى المراجع العلمية التي تستند اليها الحسابات في تصميم وحدات محطة المعالجة.
- يتضمن التقرير مخططات اولية تبين المسارات الرئيسية لشبكات مجاري مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي وتقيم المساحات (Catchments areas) لغرض الحسابات الهايدروليكية.
- يتضمن التقرير شرح لشبكة المجاري الموجودة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة وطاقاتها وحالتها التشغيلية ومشاكل اعتراضها التصاميم الجديدة وكيفية الربط عليها لاكمال تصميم الشبكة
- يتضمن التقرير دراسة لانواع ومواصفات الانابيب المستخدمة مع نسخة من المواصفة المعتمدة وملحقات الانابيب واطوال الانابيب المستخدمة للمشروع.
- دراسة بتفاصيل احواض التفتيش والمنشات والتفاصيل التي تخص شبكات المجاري.
- دراسة بتفاصيل انواع محطات الصخ لشبكات المجاري وتقديم مخططات أولية تبين مواقع المحطات.
- يتضمن التقرير مخططات اولية تبين مواقع محطات المعالجة وتوزيع وحدات محطات المعالجة.
- وصف طريقة التصفية التي تم اختيارها لكافة مراحل محطة معالجة الصرف الصحي ومدى كفائتها في إزالة مياه المجاري ولكل مرحلة لحين الوصول الى المعايير المطلوبة مع شرح طريقة معالجة الخبث معزز ذلك بمخطط يوضح موقع محطة المعالجة.
- تقديم بدائل لطريقة التصفية التي تم اختيارها وبيان أسباب اختيار الطريقة المذكورة في الفقرة أعلاه من الناحية الفنية ولاقتصادية.
- اعداد دراسة تفصيلية لكلف تنفيذ شبكات مياه الامطار وشبكات مياه الصرف الصحي ووحدات الضخ ووحدات المعالجة لمياه الصرف الصحي والمراحل التنفيذية لها وتحديد مقدار العملة الصعبة اللازمة للاستيراد الانابيب وملحقاتها وكافة المعدات الميكانيكية والكهربائية.
- تقديم نسختين من تقرير الأثر البيئي لغرض المصادقة.
- دراسة مقدار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروع وكذلك الطاقة الكهربائية البديلة (Diesel Generators) اللازمة لتشغيل محطات الضخ ومحطات المعالجة.
- دراسة كلف التشغيل السنوية وعدد الايدي العاملة.
- يتضمن التقرير الاولي الموافقات الرسمية للدوائر المعنية الى موقع محطات الضخ وموقع محطة معالجة الصرف الصح ومواقع نقاط التصريف ومسارات الخطوط الناقلة.
- تقديم نسخة واحدة من مسودة التقرير الاولي الى المديرية المجاري لغرض المصادقة.
- تقديم 4 نسخ من مسودة التقرير الاولي الى المديرية المجاري لغرض المصادقة.
- تقديم نسختين من تقرير الاثر البيئي.
.قصيدة من فاتَهُ منك وصْلٌ. لسِيْدي علي بن وفا رضي الله عنه.
.ُمن فاته منك وصْلٌ حظُّه الندم. * ومن تكن همه تسمو به الهمم
.ُوناظرا في سوى معناكَ حُقَّ لهُ. * يُقتَصُّ من جفنه بالدمع وهو دم
.ُوالسمعُ إن جالَ فيه من يحدثُهُ. * سوى حديثُك أمسى وقرُهُ الصَّمَم
.فما المنازلُ لولا أن تَحِل بها. * وما الديارُ وما الأطلالُ والخيم؟
.لوْلَاكَ ما شاقَنِي رَبْعٌ ولا طَلَلُ. * ولا سَعَتْ بي إلى نحو الحِمَى قَدَمو
.في كل جارحةِ عينٍ أراكَ بها. * مِنِّي وفي كُلّ عُضو للثَناء فَمو.
.فإن تكلَّمْتُ لم أنطِقْ بغيركم. * وإنْ كَتَمْتُ فشُغلي عنكم بِكُمُو
.أخذتم الروحَ مني في ملاطفة. * فلست أعرف غيرا مذ عَرَفْتُكُمُو
.نَسِيتُ كُلَّ طَرِيقٍ كُنتُ أعرِفُها. * إلا طريقا تؤديني لرَبْعِكُمو
.وقفتُ بالذُّلِ في أبوابِ عِزِّكمُ. * مُستَشفعاٌ مِنْ ذُنوبي عِندَكم بِكُمو
.أُعَفِّرُ الخَدَّ ذُلّن في التراب عسى. * أنْ ترحموني و تَرضَوني عُبَيْدَكُمو
.فإنْ رَضِيْتُم فيا عِزِّي وياشَرَفِي. * وإن أبَيْتُمْ فمنْ أرجوه غيرَكمو.
.لا غَيَّبَ اللهُ عَنِّي طِيْبَ رؤيتِكم. * ما طابَ للسَمْعِ يوما غَيْرَ ذِكركمو
.إن مِتُّ في حُبِكم شوقا فيا شرفي. * ويا سروري من موتي بِكُمْ لَكُمو
أنا المُقِرُّ بذنبي فاصفَحُوا كرما. * فبانكِسَاري وذُلي قد أتيتُكُمو.
لا تطردوني فإنِّي قد عُرِفتُ بكم. * وصِرتُ بين الوَرَى أُدْعَى بِعَبْدِكُمو.
وصلى اللهُ على سيدنا محمد وآله وسَلَّم
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
Chapter One
The Twilight of the Idols
Chapter One
The Twilight of the Idols
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter One
The Twilight of the Idols
التعليم الالكتروني هو التعليم المعتمد على التقنيات الالكترونية وبواسطة شبكات الاتصال العالمية، ويمكنك البدء بالتعلم عن بعد مع منصة مكان التي توفر لك كل ما تحتاجه للوصول الى العلم والمعرفة
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter One
The Twilight of the Idols
The old order changeth, yielding place to the new… lest one good custom should corrupt the world. Alfred, Lord Tennyson.
DIPLOMATS, HISTORIANS, POLITICIANS, OR PHILOSOPHERS rarely identify technological change as a decisive force in the rise and fall of nation-states, preferring to explain the course of history by the efforts of men and women like themselves. In ancient Greece, Plato tells us, the leading men of the city did not hold engineers in high regard: “You despise him and his art,” he wrote, “and sneeringly call him an engine-maker, and you will not allow your daughter to marry his son or marry your son to his daughter.” Little has changed. In today’s world, many would have to concede that important technological breakthroughs may temporarily change the military or economic balance of power. Even the most jaded diplomat would agree that the balance of power in the world altered decisively on July 16, 1945 on the desert of Alamogordo, New Mexico when the first atomic explosion took place. Relations between nations were instantly altered, and the very survival of our planet came into question. Yet many of us assume that however much technology may alter the means by which nations pursue their basic geopolitical interests, those interests themselves will remain the same. This is not always the case.
(page 2).
The additive developments in science and technology that are often summed up in the phrase “the information revolution” are altering the shape and direction of national and international events in fundamental ways. We are witnessing a revolution in the relationships among sovereign states, in the relationships between government and citizens and between those citizens and the most powerful private institutions in society. And the “engine makers” are the leading revolutionaries. The information revolution is profoundly threatening to the power structures of the world, and with good reason. The nature and powers of the sovereign state are being altered and even compromised in fundamental ways. The geopolitical map of the world is being redrawn. The elements of the balance of power that has prevailed for the last forty years have already been permanently disturbed and may soon be irretrievably altered or lost. Other institutions of our world, the business corporation chief among them, face equally powerful challenges to their modus operandi and will undergo profound changes that will affect all who are associated with them. The information revolution, despite being the most frequently announced revolution in history, is still little understood. Many of the innovations that were trumpeted the loudest and earliest have never arrived: the checkless society, the paperless office, newspapers over cable TV, a helicopter in every backyard. Many of them may never arrive. But revolutions are not made by gadgets but by a shift in the balance of power. The underlying forces of the information revolution are causing such a shift in the balance of economic, political, and military power. The information revolution is usually conceived, quite rightly, as the set of changes brought on by “information technologies,” the two most important being modern communications technologies, for transmitting information and modern computer systems for processing it.
(page 3).
The marriage of these two technologies is now consummated. It is impossible to tell where communication stops and where computing begins. After years of study, in an attempt to determine which bureaucracy should have regulatory power, the federal government gave up on efforts to draw this distinction. In addition to powerful effects on culture and the pace of life, this revolution has changed what we do for a living. It has made many or most of us into what Peter Drucker long ago called “knowledge workers” and is changing the way the rest of us do such traditional jobs as mining and manufacturing, selling and shipping. Most of us would probably be inclined to say that such dramatic changes are quite enough of an accomplishment for any revolution and that this one could retire from the field with a good day’s work done. But underlying and driving the information revolution are two powerful tides that are rocking the power structures of the world: The first is the vast increase and swift and widespread dissemination of knowledge and of information of all sorts. The second is the increasing importance of knowledge in the production of wealth and the relative decline in the value of material resources. From the beginning of time, power has been based on information. Someone learned to use a burning glass to start a fire; someone was able to find out where enemy troops were. Someone knew how to build a castle wall strong enough to withstand a siege, until someone else learned how to build a catapult or a cannon. Some politician found a pollster who gave notice of what the citizens really worried about. Timely information has always conferred power both in the commercial and the political marketplace. The dissemination of once closely held information to huge numbers of people who didn’t have it before often upsets existing power structures. Just as the spread of rudimentary medical knowledge took away the power of the tribal witch doctor, the spread of information about alternate life-styles in other countries threatens the validity of some official political doctrines, the credibility of the leadership, and the stability of the regime.
(page 4).
The marriage of the computer with telecommunications, resulting in movement of information at the speed of light and to enormous audiences, tends to decentralize power as it decentralizes knowledge. When a system of national currencies run by central banks is transformed into a global electronic marketplace driven by private currency traders, power changes hands. When a system of national economies linked by government-regulated trade is replaced ( at least in part) by an increasingly integrated global economy beyond the reach of much national regulation, power changes hands. When an international telecommunications system, incorporating technologies from mobile phones to communications satellites, deprives governments of the ability to keep secrets from the world, or from their own people, power changes hands. When a microchip the size of a fingernail can turn a relatively simple and inexpensive weapon into a Stinger missile, enabling an illiterate tribesman to destroy a multi-million dollar armored helicopter and its highly trained crew, power changes hands. The dictionary defines knowledge as the “acquaintance with facts, truths or principles, as from study or investigation.” But knowledge can also be thought of as what we apply to work in the production of wealth. Knowledge is the ultimate source of value in work. A rabbit running free through the meadow is not wealth. It becomes wealth as a result of information applied to the work of a hunter: information about where to find game, how to stalk it, how to throw a spear or shoot an arrow, how to make the arrow, the bow, or the spear. All these bits of information taken together and applied to the hunter’s work produce value, that is, dinner for the hunter, his family, or the whole tribe. Economists have a name for the work the hunter does to turn rabbit into roast: value-added.
(page 5).
Even in ancient days a considerable portion of that value-added was intellectual: the hunter’s knowledge and skill. Nevertheless, in those days the bulk of the value-added was physical , long days in the field pursuing the rabbit, long and arduous efforts in shaping spear or bow, sharpening arrow or spearhead. And, of course, the original value in the deal was supplied by the rabbit, which fattened itself up in the meadow in pursuit of an agenda somewhat different from the hunter’s. Economic progress is largely a process of increasing the relative contribution of knowledge in the creation of wealth. The value of an ear of wild grain harvested by hunter-gatherers was almost entirely material, a gift of nature. Come the agricultural revolution, and an ear of hybrid corn grown in carefully fenced, rotated, fertilized, and irrigated fields is to a very considerable extent the product of mind. The industrial revolution advanced the process further still as men greatly increased their capacity to manipulate matter and shape it to their needs. In our time, the knowledge component of nearly all products has vastly increased in importance. As George Gilder has pointed out, the fundamental product of the information age, the microchip, the key component of all modern communications and computer technology, consists almost entirely of information. Raw materials account for about 1 percent of its costs; labor of the traditional sort for another five percent. A majority of the cost — and value — comes from the information incorporated into the design of the chip itself and into the design and development of the highly specialized equipment used to manufacture it.
The information technologies made possible by the chip have a profound effect on the rate of advance of all science since calculations that used to take years can now be done in minutes. Scientific knowledge is currently doubling about every fifteen years. This vast increase in knowledge brings with it a huge increase in our ability to manipulate matter, increasing its value by the power of mind, generating new substances and products unhinted in nature and undreamed of but decades ago.
(page 6).
The effort to find, secure, and transport relatively rare natural resources — minerals, metals, coal, and oil — has been a key theme of economic production since the onset of the industrial age. Yet the value of all these materials is declining as the power of mind, enhanced by the intellectual hydraulics of information technology, is employed to replace them or economize on their use. Plastics replace metal and stone, fiber optic cable replaces copper. Microchips are made from virtually worthless sand, and superconducting ceramics, from common clay.
As computer-assisted calculations speed scientific investigations, so do they accelerate and simplify engineering and design. Better designs produce more efficient products, from airplanes to ovens, reducing energy needs and conserving on coal, oil and other fuels. Indeed, prices of raw materials have been slumping worldwide for several decades, with only occasional and short-lived exceptions produced by OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) or other political cartels.
The old industrial age is fading and being slowly replaced by a new information society. This transition does not mean that manufacturing does not matter, or that it will disappear, any more than the advent of the industrial age meant the disappearance of agriculture. What it does mean is that the relative importance of intellectual capital and intellectual labor will increase as that of physical labor and material capital declines. Knowledge applied to work has always created value, although many economists have tended to overlook its vital significance. In the world we are building, such an oversight will be increasingly difficult.
In sum, the world of work, the drama of economic production, the essential basis of our material existence, which for several centuries has been dominated by the brute forces of industry, is now dominated by products and processes that consist more of mind than of matter.
(page 7).
These products and processes are faster more mobile, have less need of centralized support, and are less dependent on natural resources, physical plant, or human labor than those of the recent past and thus are becoming far more difficult to regulate or control.
Sovereignty, defined by the , as “the supreme undivided authority possessed by a state to enact and enforce its law with respect to all persons, property, and events within its borders,” is one of the most important ordering ideas of the modern world, a bulwark of modern power structures. Yet it is a relatively recent idea, first given to us in a full-bodied form by the great Dutch jurist Hugo Grotius in his seminal work (Concerning the Law of War and Peace) in 1625. It is certainly possible to imagine a world in which state sovereignty as we know it did not exist or existed in substantially altered form.
As the dictionary definition implies, sovereignty has always been, in part, based on the idea of territoriality. The extent of sovereign’s reach has usually been defined by geographic borders. Even the immunities enjoyed by a foreign embassy are expressed in part geographically, by defining an area into which the host country may not intrude.
The control of territory remains one of the most important elements of sovereignty. But as the information revolution makes the assertion of territorial control more difficult in certain ways and less relevant in others, the nature and significance of sovereignty is bound to change.
As recently as World War II, armies fought and men died for control of the iron and steel in the Ruhr basin because ownership of those assets conferred real economic and political power. Today these once fought over assets may be a liability. To the extent that new technology replaces onceessential commodities with plastics or other synthetic materials, the relative importance of these areas to the vital interest of nations is bound to change.
(page 8).
In 1967, Egypt closed the Suez Canal, and conventional wisdom told us that the lights would go out all over the world if this waterway between the Mediterranean Sea and the Gulf of Suez were ever closed. The power of a sovereign state, Egypt, to block the flow of oil to Europe was believed to be absolute short of war or other hostile action by the Western powers. The conventional wisdom did not take into account the technology that would allow the building of supertankers that could carry oil around the Cape of Good Hope economically. This feat was achieved by relatively simple technology, but it decisively altered the geopolitics of the Middle East. Similarly, advances in military technology are making once vital strategic “choke points” steadily less relevant. The velocity of change in economics, technology, science, and military capabilities is shifting the tectonic plates of national sovereignty and power.
One traditional aspect of sovereignty has been the power of nation-states to issue currency and mandate its value. Of course, the claims kings made for the worth of their currency did not always square with the facts. In the seventeenth century the Amsterdam bankers made themselves unpopular in the royal chambers by weighing coins and announcing their true metallic value. But those bankers spoke to a small audience and their voices were not heard very far beyond the city limits. Despite the power of a righteous market, until very recently governments retained substantial power to manipulate the value of their currencies. As the information revolution has rendered borders porous to huge volumes of high-speed information it has deprived them of that power.
The new international financial system was built not by politicians, economists, central bankers or finance ministers but by technology. Today, information about the diplomatic, fiscal, and monetary policies of all nations is instantly transmitted to electronic screens in hundreds of trading rooms in dozens of countries.
(page 9).
As the screens light up with the latest statement of the president or the chairman of the Federal Reserve, traders make a judgement about the effect of the new policies on currency values and buy or sell accordingly. The entire globe is now tied together in a single electronic market moving at the speed of light. There is no place to hide.
This enormous flow of data has created a new world monetary standard, an Information Standard, which has replaced the gold standard and the Bretton Woods agreements. The electronic global market has produced what amounts to a giant vote-counting machine, that conducts a running tally on what the world thinks of a government’s diplomatic, fiscal and monetary policies. That opinion is immediately reflected in the value the market places on a country’s currency.
Governments do not welcome this Information Standard any more than absolute monarchs embraced universal suffrage. Politicians who wish to evade responsibility for imprudent fiscal and monetary policies correctly perceive that the Information Standard will punish them. The size and speed of the worldwide financial market doom all types of central bank intervention, over time, to expensive failure. Moreover, in contrast to former international monetary systems, there is no way for a nation to resign from the Information Standard. No matter what political leaders do or say, the screens will continue to light up, traders will trade, and currency values will continue to be set not by sovereign governments but by global plebiscite.
The new global market is not limited to trade in financial instruments. The world can no longer be understood as a collection of national economies. The electronic infrastructure that now ties the world together, as well as great advances in the efficiency of conventional transportation, are creating a single global economy.
Commerce and production are increasingly transnational. The very phrase “international trade” has begun to sound obsolete. In the past, companies generally exported and imported products. On a national level, these transactions were aggregated and balanced according to the rules of a zero-sum game. Today this is no longer the rule.
(page 10).
A product may have value added in several different countries. The dress a customer purchases at a smart store in New York may have originated with cloth woven in Korea, finished in Taiwan, and cut and sewed in India. Of course, a brief stop in Milan, to pick up a “Made in Italy” label is de rigueur before the final journey to New York. Former Secretary of State George Schultz recently remarked in a speech:A few months ago I saw a snapshot of a shipping label for some integrated circuits produced by an American firm. It said, “Made in one or more of the following countries: Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Mauritius, Thailand, Indonesia, Mexico, Philippines. The exact country of origin is unknown. That label says a lot about where current trends are taking us.
Whatever the correct word for these phenomena, “trade” certainly seems an inadequate description. How does one account in the monthly trade figures for products whose “exact country of origin is unknown?” How are national governments to regulate transnational production with anything like the firmness with which they once regulated international trade? How are politicians to whip up nationalist fervor against foreign goods when American car companies build cars in Mexico for export to Japan and pay the profits to pensioners in Chicago and the Japanese build cars in Tennessee for export to Europe and use the income to refinance real estate in Texas? On the global business front, the new word is “alliances.” Almost every day one reads about an American company and a Japanese company or a Swedish company and a German company — the list of combinations is endless — forming an alliance to offer a new product in a multinational horizontal integration of manufacturing, marketing, finance, and research.
(page 11).
As these alliances grow and strengthen over time, it will become harder and harder for politicians to unscramble the emerging global economy and reassert their declining power to regulate national life.The global market has moved from rhetoric to reality almost before we knew it. The old political boundaries of nation-states are being made obsolete by an alliance of commerce and technology. Political borders, long the cause of wars, are becoming porous. Commerce has not waited for the political process to adjust to technology but has tended to drive it. This is especially noticeable in Europe, where the new generation of business managers is bound and determined that the integration of the Common Market in 1992 will arrive on schedule, even though political leaders often seem reluctant to see their power compromised.
Within national borders, sovereignty has traditionally entailed the government’s power to regulate the leading enterprises of society, from health care to heavy industry. In an economy dominated by products that consist largely of information this power erodes rapidly. As George Gilder has written “A steel mill, the exemplary industry of the industrial age,” lends itself to control by governments.
Its massive output is easily measured and regulated at every point by government. By contrast, the typical means of production of the new epoch is a man at a computer work station, designing microchips comparable in complexity to the entire steel facility, to be manufactured from software programs comprising a coded sequence of electronic pulses that can elude every export control and run a production line anywhere on the globe.
The information revolution not only makes the microeconomy more difficult to regulate; it makes the macroeconomy — the world of gross national product (GNP) aggregate demand, and seasonally adjusted statistics — harder to measure and therefore harder to control.
(page 12).
Many of the terms we use today to describe the economy no longer reflect reality. Everyone knows, for example, that all the lights would go out, all the airplanes would stop flying, and all the financial institutions and many of the factories would shut down if the computer software that runs their systems suddenly disappeared. Yet these crucial intellectual assets do not appear in any substantial way on the balance sheets of the world. Those balance sheets, however, do all reflect what in the industrial age were tangible assets — buildings and machinery — things that can be seen and touched.
How does a national government measure capital formation when much new capital is intellectual? How does it measure the productivity of knowledge workers whose product cannot be counted on our fingers? If it cannot do that, how can it track productivity growth? How does it track or control the money supply when the financial markets create new financial instruments faster than the regulators can keep track of them? And if it cannot do any of these things with the relative precision of simpler times, what becomes of the great mission of modern governments? Controlling and manipulating the national economy? Even if some of these measurement problems are solved, as some surely will be, the phenomena they measure will be far more complex and difficult to manipulate than the old industrial economies.
The single most powerful development in global communication has been the satellite, born a mere thirty-one years ago with the launch of Sputnik. Satellites now bind the world, for better or worse, in an electronic infrastructure that carries news, money, and data anywhere on the planet at the speed of light. Satellites have made borders utterly porous to information. Geosynchronous satellites can and do broadcast news over curtains of iron, bamboo, or adamant to anyone with a hand-held transistor radio.
(page 13).
One of the fundamental prerogatives assumed by all sovereign governments has been to pursue their national interests by waging war. Today this prerogative is being severely circumscribed by information technology. No one who lived through America’s Vietnam experience could fail to understand the enormous impact that television had in frustrating the government’s objective in Southeast Asia. Knowing in a general way that war produces violent death is one thing, but watching the carnage of a battle or the body bags being unloaded at Dover Air Force Base, on your living-room television set is quite another.
We have seen in the United States an organization publish the names of American agents in place overseas; we have read accounts in national newspapers detailing American naval and troop movements at a time of national emergency. Recently, a private company forced a superpower to change its policy. This occurred when the government monopoly on photographs from space was broken by the launching, in February 1986, of the privately owned French satellite, SPOT. When the pictures of the Chernobyl nuclear disaster taken by SPOT appeared on the front pages of the world’s newspapers, the Soviet Union was forced to change its story and admit that the event was much more serious than it had previously claimed. In this instance the technology was not new, but the power to use information shifted from the government to the private sector. The event posed a continuing dilemma: What SPOT revealed about Chernobyl, it can also reveal about American military sites. There is no American censorship of SPOT pictures as there had been on a de facto basis of photos taken from the American government’s Landsat satellite.
While the resolution of SPOT’s picture is only ten meters, it will undoubtedly be improved. The next logical development might be for an international news agency to purchase its own high-resolution satellite. Such a purchase would be a good deal less expensive, for instance, than the cost of cov-ering the Olympics.
(page 14)
If this happens, the guardians of national security will clash in space with the defenders of the First Amendment.
If democratic societies will have difficulty adapting to what amounts to a whole new definition of sovereignty, closed societies such as the Soviet Union, will have a much more difficult time. Communist regimes have always based their power in part on their ability to control what their citizens see and hear. That control was seriously eroded by technology. News of the in Eastern Europe was instantly relayed by radio and TV to the people of the former Soviet Union. The number of VCRs available in Moscow has been growing daily. Satellites are no respecters of ideology. Even the most draconian measures would be unlikely to halt the trend.
Nor can the former Soviet Union afford draconian measures. On the contrary, it faces an economic imperative to loosen controls further. Modern economies require access to huge amounts of information and the computer power to manipulate it. The free flow of scientific and technological knowledge is essential to innovation and continued productivity. Millions of researchers, scientists, and citizens in the United States now have access through their personal computers (PCs) to more than three thousand publicly available data bases, some storing billions of bits of technical, demographic, or scientific data. The Soviet Union, in which information is the monopoly of the state and where even the GNP is a classified number, handcuffed itself. If the Kremlin wishes to keep up with pace with the West, it must allow its people to participate in the information revolution. But if it does so it will lose an essential tool of state control. It is a Hobson’s choice, and it will get more difficult over time. Indeed, history has resolved the dilemma with a swiftness that took all pundits by surprise.
The satellite, for all its power, is but a subset of a whole new class of “information weapons,” weapons whose value is supplied largely by information technologies. As a rule, information weapons are equalizers that help small nations against large and favor defender over invader.
(page 15)
Perhaps the most dramatic current example is the use of the Stinger by the Mujahedin against the Russian invaders. The Stinger is one of the first truly “smart” missiles to be used extensively in battle. It has demonstrated decisively that “artificial intelligence” can make a weapon costing but thousands of dollars, and affordable to even guerrilla armies, the superior of multimillion-dollar aircraft affordable in any considerable quantity only to the superpowers.
A less violent, but perhaps more destructive information weapon is the “software virus,” dramatically illustrated in November 1988 by the invasion of a Department of Defense computer network by one such destructive program. Scott A. Boorman and Paul Levitt, have argued that “with computer software now eighty percent of U.S. weapons system in development, attacks on the software…may be the most effective, cheapest, and simplest avenue to crippling U.S. defenses.” Such sabotage may be within financial and technical reach of the smallest nations.
The challenge to national sovereignty poised by the information revolution is being replicated in various ways throughout most of the institutions of the modern world. In the business organization, the person who truly understands the impact of technology has become a vital part of the whole strategic business process. We see new corporate structures developing to manage new manufacturing methods, products, and delivery systems. Management structures are already changing dramatically. Layers of managements that used to do nothing but relay information from one level to another are beginning to disappear. Business is learning that these positions are no longer needed now that information technology allows the rapid transmission of vital information to all levels of management without human intervention. Instead, the old military mode of hierarchical organization is giving way to flatter structures designed for the faster response times needed to serve dynamic global markets. (page 16)A walk through a modern factory makes the point. Manufacturing plants are being run by computer hardware and software. The man with the clipboard who makes sure the widgets are in the right place on the shop floor at the right time is disappearing; the computer does it. The task of transmitting upward information on the state of the business is even more thoroughly automated. And more people in the system now have access to that information. Reports that used to take days or weeks to prepare, as well as the considerable support staff available only to senior management, are now available throughout the system at the stroke of a few computer keys. Plato wrote that democracy cannot extend beyond the reach of a man’s voice, a limitation that provided a pretty good justification for the old system. In the new world, we may not see corporate democracies, but we will see the skills of command outstripped by the demand for leadership.
This sea change in our most important economic institutions (indeed in any of our great bureaucracies) will affect our daily lives and work in important ways. But as we shall see, the effects on society as a whole, while more subtle perhaps than those brought about by a revolution in the meaning and practice of national sovereignty, may be every bit as profound.
One of the recurring themes of history is our apparent inability to credit information that is at variance with our own prejudgments. Examples abound. The great historian Barbara Tuchman uses the Japanese attack on Pearl Harbor to illustrate the point. Though Japan had opened the Russo-Japanese war in 1904 by a surprise attack on the Russian fleet, American authorities years later dismissed the possibility of a similar maneuver.
We had broken the Japanese code, we had warnings on radar, we had a constant flow of accurate information … we had all the evidence and we refused to interpret it correctly, just as the Germans in 1944 refused to believe the evidence at Normandy… Men will not believe what does not fit in with their plans or suit their prearrangements.
(page 17).
This phenomenon, unfortunately, is not limited to discrete events. Few members of the current power structure wish to contemplate its decline, preferring to cherish the plans they have made, the strategies for victories economic, political or military. But the contests for which they have faithfully prepared may never come, at least in the form expected, because the rules have been changed forever.
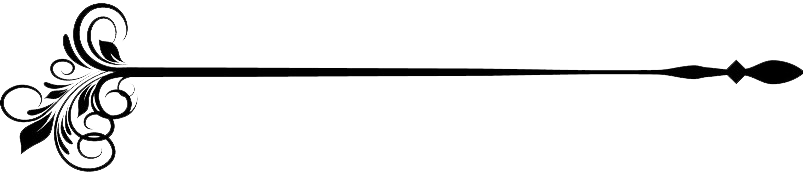
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World.
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Two.
A New Source of Wealth.
We might say that in the nineteenth century the wealth in California came from the gold in our mountains; today it comes from the silicon in our valleys.
William J. Perry
DESPITE ALL THAT IS WRITTEN AND SAID ABOUT THE INFORMATION Revolution, many people still have not faced how it has changed the economy. While they understand that computers and telecommunications have become powerful economic forces, what many do not seem to realize is that these technologies have done far more than speed up the industrial economy or enrich it with new conveniences — or overload it with new gadgets. The difference between the old industrial economy and the new information economy is quantitative, not merely qualitative. The world is changing not because computer operators have replaced clerk-typists and can produce more work in less time but because the human struggle to survive and prosper now depends on an entirely new source of wealth; it is information, knowledge applied to work to create value. Information technologies have created an entirely new economy, an information economy, as different from the industrial economy as the industrial was from the agricultural. And when the source of the wealth of nations changes, the politics of nations change as well.
The Industrial Revolution changed the source of wealth, transforming once useless piles of rock and ore into riches of steel and steam. Even as it gave value to once neglected natural resources, industrialization dramatically increased the power of the nation-state, not only by enhancing its revenues but also by expanding its regulatory power and the armaments needed to control those resources and the territory that embraced them. In the last few decades the information revolution is again changing the source of wealth, and even more dramatically. The new source of wealth is not material; it is information, knowledge applied to work to create value. The pursuit of wealth is now largely the pursuit of information, and the application of intellectual capital to the means of production. This shift in perception of what constitutes an asset, poses huge problems in expanding or even maintaining the power of government. Information resources are not bound to a particular geography or easily taxed and controlled by governments. A person with the skills to write a complex software system can walk past any customs officer in the world with nothing of “value” to declare. An information economy diminishes the rewards for control of territory and reduces the value of the resources that can be extracted through such control.
As a source of wealth, information comes in various forms, from streams of electronic data briefly valuable, to years of accumulated research embedded in computer memories operating automated factories, to the intellectual capital carried in the brain of an engineer, a manager, or an investment banker. The world desperately needs a model of economics of information that will schematize its forms and functions. But even without such a model one thing will be clear: When the world’s most precious resource is immaterial, the economic doctrines, social structures, and political systems that evolved in a world devoted to the service of matter become rapidly ill suited to cope with the new situation. The rules and customs, skills and talents necessary to uncover, capture,
page.20.
produce, preserve, and exploit information are now mankind’s most important rules, customs, skills, and talents.
The information economy changes the very definition of an asset, transforms the nature of wealth, cuts a new path to prosperity. The information economy changes everything from how we make a living to how and by whom the world is run. The competition for the best information is vastly different from the competition for the best bottomlands or the best coalfields. Companies or nations competing for information will be vastly different from those that once competed primarily for material resources. The nature of information — how it is traded and produced, the scope, shape, and protocols of information markets, and the other institutions of an information economy — will impact government policy, set the limits of government power, and redefine sovereignty.
The changes in Eastern Europe are a dramatic example of the way the political structures are altered by information. The ideas, and even more important, the aspirations of the dissidents rose on a flood of information, now flowing easily through what used to be called the Iron Curtain, about life in the West. Tactically, the revolution of 1989 made full use of modern communications technologies, from fax machines to satellite dishes to superlightweight video cameras and VCRs. But information played an even more important role in the Eastern bloc revolution. The power of information may explain the revolution’s greatest mystery: why the Soviets and their satraps did so little to resist, and even encouraged, the changes. During the 1970s the Soviet economy — as it had for years — depended on gold, gas, oil, manpower and military might, all of which were losing value compared to the resource in which, by idiotic political design, the USSR has long been poorest: information. As Gorbachev himself said: “The Soviet Union is in a spiritual decline. We have had to pay for this by lagging behind, and we will pay for it for a long time to come. We were one of the last to
page.21.
realize that in the age of information science the most valuable asset is knowledge — the breadth of mental outlook and creative imagination.”
The Soviet leaders recognized that in an information economy only nations that allow information capital to flow freely will have enough of it to compete. The free flow of information, however, means liberating not only data, but people and money, books and newspapers, and the proliferating electronic media. Free enterprise requires free expression. From the beginnings of Gorbachev’s rhetoric showed that he grasped the price of a working modern economy. In 1991 he paid it.
The information revolution is one of the most heralded events in history, yet its essential nature is little understood. As everyone knows, the revolution was touched off, shortly after the invention of the electronic compute in 1946, by the remarkably rapid progress of computing and communications technologies. Over the past three decades, computers have grown in efficiency more than a millionfold. The computers of the fifties cost millions, required teams of expensive operators, filled whole suites of offices, were cumbersome to use or reprogram, and yielded but a fraction of the computing power of today’s desktop personal computer (PC). In telecommunications the rise of fiber optics also enhanced efficiency as much as a millionfold. Today AT&T sends information between Chicago and the East Coast at the rate of 6.6 gigabits (the equivalent of a thousand books) per second. At this pace, the entire Library of Congress could be dispatched in twenty-four hours: Using conventional copper wire and a 2,400-baud modem it would take two thousand years.
In both technologies, progress was powered by the microchip, on which were integrated first dozens, then millions, of electronic switching circuits. Those switches are a computer’s calculating tools, and are also used by modern telecom systems — consisting largely of highly specialized computers — to compress and organize information and to speed
page.22.
up and direct its flow. Already the industry is placing some 10 million switches on a chip the size of a thumbnail. By decade’s end, each chip will carry more than a billion switches, each operating in trillionths of a second.
These developments not only dramatically increased the computer’s power to process and use information, but radically decentralized that power by liberating computer users from the tyranny of the million-dollar mainframe. As late as the 1970s, Soviet economic planners were still devoting enormous resources to massive centralized computer systems by which they hoped to administer the entire Soviet economy without strangling it — the elusive Communist dream. The final collapse of those efforts was a crucial factor in the ensuing demoralization of the true believers and the rise of Gorbachev. Meanwhile, in the free world, computing power was being spread throughout the economy by mini-computers, PCs, and work stations to liberate initiative and enable innovations impossible only a few years before.
These developments are as crucial as they sound. And yet they are not in themselves the information economy. The triumph of the information economy is seen not primarily in new things that are made of microchips but in the use of microchips to make the same old things out of a new resource: information. With but 2 percent of its costs attributable to energy and raw materials and but 5 percent to ordinary labor, the modern microchip is far more a product of mind rather than matter. The really remarkable thing about the microchip, however, is that it helps men turn nearly everything else they make into a product of mind and undermines every merely material advantage. The struggle to support human life in our unforgiving world still very much depends on making steel and concrete, building shelter, growing food, and moving resources from place to place. But now we build houses and offices and factories from information, we sow, fertilize, and harvest our crops with infor-
page.23.
mation, and we move our most precious — and some of our most common — possessions on highways of information.
Even steel, the paradigmatic product of the industrial age, has been transformed. A piece of steel, whether raw or as a part for a new automobile or skyscraper is very different today from what it was a generation ago: It still contains a lot of iron mixed with other metals, but it contains a great deal more information. The extra information in modern steel would not show up dramatically in a chemical analysis — though hints of it are there in the subtly changing components of the alloy, and in some special steels, the lighter weight and greater strength of the metal. But in an economic analysis of modern steel the importance of information would resound from the figures. Modern steel plants use far less labor and energy, and even less raw material, to produce a given amount of steel than did the plants of a generation ago.
The biggest breakthrough in the steel industry in the past twenty years has been the “minimill,” a new sort of steel mill using advanced melting, casting, and milling technologies. These technologies have freed steel making from its geographic ties to iron and coal deposits; have reduced capital costs for new mills by two-thirds; have reduced the minimum profitable size of a mill even more dramatically; and have doubled labor productivity. They have also, as we shall see, profoundly changed the lives of people who made their living from steel.
The minimill depends on electric rather than coal- or coke-driven furnaces. The electric furnace is not a new technology, but rapid improvements in the past few years have raised the quality and lowered the price of steel made in such furnaces. Electric furnaces primarily use scrap, which is cheaper and more abundant than raw steel, as their raw material. The huge “basic oxygen furnaces” used in the grand old integrated steel mills of the past cannot use much scrap without sacrificing quality. They must have raw steel, reduced from ore in hugely
page.24.
expensive blast furnaces, fed in their turn by massive coke ovens and ore processors. Because minimills do not depend on traditional raw materials they can be located almost anywhere there is a market for a few hundred thousand tons of steel a year. Integrated mills had to be located near their raw materials or near huge ports to which those materials could be shipped and could be profitable only by turning out millions of tons annually.
Because they use electric furnaces, minimills can also use “continuous casters,” which make basic steel shapes directly from molten steel. Old-style mills must first cast ingots, which are then premilled into basic shapes by expensive primary mills, before they can be sent to a rolling mill for final shaping. The continuous caster, like the electric furnace on which it depends, dramatically reduces both capital and labor costs.
These new technologies depend on an infusion of information into the steel making process, a quantitative increase in the application of knowledge to work. They also depend significantly and increasingly on information technologies, particularly computers. Automated processing — the actual running of furnaces and mills by computers — was rather late coming to the steel industry but is now taking over the minimills, particularly those that make the most challenging and highest-quality products. The best continuous casters are computer driven, their processes are too precise for manual control.
Even before automation came to the mills themselves, computers were vital to the design and production of new steel-making technologies and equipment. To take a new steel technology from drawing board to working mill once required more than a decade. Now, with advanced computer modeling techniques eliminating much trial and error from the design process, a new idea can bear fruit in two or three years. Computer modeling has also reduced the amount of trial and error (and the waste in materials, labor, and money) mills undergo
page.25.
in meeting their customers’ special needs for a particular run of steel.
Modern inventory control, accounting, and marketing procedures all rest on computer and telecom technologies. The greater strength per weight and volume of certain specialty steels is the result of our rapidly increasing scientific knowledge of the microstructure of materials, knowledge acquired in part by the application of computer power to research. “Computers change what we make, change how we make it, and change how we make the equipment to make it,” says Donald Barnett, a leading expert on the steel industry and consultant to many of its most important companies.
For all these reasons, a cost analysis of a given piece of steel would attribute a lot more value to information and information technologies, and a lot fewer to labor and materials, than was the case just twenty years ago. Steel is, as the philosophers might say, the limiting case. What is true for steel is even more true for the vast array of relatively traditional manufactured items that support our daily lives. For instance, even though steel is “smarter” than it used to be, newly invented plastic and composite materials containing an even greater proportion of information to matter, are often substituted for it. Engineering advances, made possible by advanced computer modeling, make planes, trains, and automobiles far more fuel efficient, thus substituting information for coal, oil, gas, and even more troublesome forms of matter such as uranium.
Even in such a classically industrial enterprise as steel making, matter has become the enemy of wealth, not its source. As one might guess from their name the outstanding feature of the minimills is that they are small — less matter goes into the making of them. That is also one key to their success. Their modest size, for instance, helps keep them technologically up-to-date. Because they require much less money ($15,000-$25,000 per employee) than traditional old-technology mills ($30,000-$45,000 per employee), they can
page.26.
be profitable investments even with an economic life of only a decade or so and then be replaced with an even more advanced technology. Technology has helped reduce not only the minimum profitable capacity of a mill (to about two hundred thousand tons a year) but even the optimal capacity, from about seven million down to one million tons, making it far easier for modern mills to weather downturns in the economy.
Part of this innovation was driven by the instinct for survival as more and more steel was replaced by engineered plastics. Indeed, over the last ten years, not only has the consumption of steel in the United States not grown, it has turned negative. The trend in Europe and Japan is similar. These new plastics are themselves an example of applying information — in this case chemistry — to make a product that has already replaced a thousand pounds of steel on most of the world’s automobiles.
By contrast, the massive integrated mills of the past were built to last indefinitely, and on the assumption that basic steel technology would be as durable as the mills themselves. Pundits opine that the great American steel companies fell on hard times because management did not reinvest and rebuild as times changed. But this is untrue. During the 1970s the classic firms spent massively to expand capacity and, within the context of the old technology, to update their plants. No new integrated mills were opened, but many firms added considerably to their existing plants. The industrial age had taught them that increased scale would bring increased efficiencies, so they built huge new blast furnaces and coke ovens. Industrial economics had taught them that massive infusions of physical and financial capital would increase productivity, so they invested heavily in the most up-to-date, best engineered, and most durable versions of an outmoded technology.
These classic strategies failed. In an information-rich economy innovations come quickly. The huge integrated steel
page.27.
plants were too big and expensive to adapt. Smaller plants are the easiest to automate; large plants can computerize only at great cost and without many of the efficiencies of smaller plants. Huge investments in industrial capital may even become a burden when information capital provides the competitive edge. Indeed, only two integrated mills have been built since 1950. In ten years, the big firms had lost much of their market and billions of dollars.
For all their ponderous mass, many of the old mills just disappeared. Their rusted hulks remain, undoubtedly to be sold as scrap to the minimills. But the essence of the huge mills — their massive capital investment, their great contribution to the nation’s wealth, the 500,000 jobs and the communities that depended on them — are no longer anchored to the earth by the imperatives of matter, and have floated away to other communities and other countries.
As the mills moved away or closed, tens of thousands of Americans saw their livelihoods, and even their identities — as men who, by the labor of their bodies, had delivered their families to the safe harbor of the middle class — vanish as well. For a variety of reasons — including the great power of a union in a union town to which the company seemed bound by nature’s distribution of iron and coal and the ports and loading docks to receive them — and its own massive investments, American steelworkers in the 1970s were paid twice the wage of the typical American industrial worker. But if the integrated steel maker could not leave town, steel making could. As the specialty and minimill technology developed, new mills were launched quickly and cheaply in towns that had never heard of the United Steel Workers and produced steel with two man-hours per ton versus three to six man-hours per ton in the old mills.
When steel mills can move to more hospitable climates, they no longer present a stationary target for government or union control. The more than sixty minimills moved not toward the coal and iron deposits in the
page.28.
ground, but toward the source of scrap and cheap electricity. The new technology moved them into the information economy, not an economy of gadgets and computer games but a fundamental upheaval by which men and nations make their living, and thus a revolution of all the rules by which we live.
Information has always been an important factor of production. The idea of substituting machines for manpower, for instance, is as old as the lever. It was the lever — in the form of a plow to turn the soil — that made agriculture possible. It was many years later that Archimedes boasted that given a lever long enough and a place upon which to rest it, he could move the earth. Of course no such lever existed, but by the thirteenth century a lever attached to a wheel produced the wheelbarrow, which did move the earth, albeit more gradually.
Until recently, however, even advanced manufacturing systems could make use of only small amounts of information. A few fairly simple instructions could be built into the mechanics of the system itself. The rest was carried around in the brains and on the clipboards and manuals of human operators. As for such questions as what to make, how to make it, what it should look like, when to schedule production, when to stock up on materials, when to draw down inventories, etc., that information was hardly integrated into the system at all. Information moved on myriad pathways and paper trails powered almost entirely by human beings, so-called service workers, who contributed mightily to the manufacturing enterprise.
Despite the intellectual achievements of the industrial age, information remained the most scarce and difficult to use of resources, which is why its use was minimized at every step. Thus, Henry Ford offered a Model T in any color the customer wanted as long as the customer wanted black: The cost of integrating into the system the information that 20 percent of customers wanted blue was too high for Ford’s low-price strategy. When Alfred Sloan’s innovations in corporate or-
page.29.
ganization allowed General Motors (GM) plants to integrate rather modest amounts of marketing feedback into production decisions, GM became the leading carmaker, and Sloan went down in business history as a management genius.
Information technology is fundamentally different from industrial technology in that it can be programmed to do the required task and, if necessary, can be continuously adjusted. Industrial technology is just the opposite: The task must be adopted to the technology. It is a difference in kind and not just in degree. In the industrial economy, manufacturing systems were based on high volume, with sustained production runs producing standardized products. It usually took a long time — with the consequent shutdown of production — to change production runs. The new technology, however, permits the almost instant resetting of specifications, thus eliminating downtime. The garment trade is a good example of the new technology. The way in which the cloth is cut can be high value-added operation or a money loser. It used to be that the great cutting machines had to be set up to cut only one size at a time, say, a size 8 regular, and the knife would slice through dozens of pieces of cloth at once to turn out fabric of the right size. If, however, the customer wanted a size 12 stout or some size 6 petites, it was a long and uneconomic job to reset the machine to turn out the odd sizes. Today, with computer-controlled cutters, the machine can be programmed to turn out any number of different sizes in any volume, thus making it economical to supply whatever the customer wants.
Although computers are thought of as operating in the service sector, they are now so integrated with manufacturing as to make separate categories useless. A walk through a modern factory makes the point. Manufacturing plants are now run by computer hardware and software that integrate huge amounts of information into the manufacturing process, and process vast amounts of “feedback” information so as to make adjustments with a minimum of human intervention.
page.30.
Digitally controlled machine tools are now linked together through communications systems and software to orchestrate entire production facilities. Human beings have found a way to apply their rapidly increasing knowledge to work to create value in ways unknown but a few years ago.
One innovation in this regard is the “expert system” by which modern technology is employed to capture knowledge so that it can continue to be applied to work and create value long after the person who acquired this valuable knowledge is gone. One famous expert system, used in GM factories, is called “Charley,” after GM maintenance master Charley Amble, now retired. Charley the computer is an interactive system into which has been programmed the distilled wisdom of a lifetime of Charley Amble’s experience in repairing machines. Over a period of twenty years Charley’s job was listening to the noises machines make and, based on his analysis of the vibrations he heard, diagnosing whether or not the machine had to be adjusted, repaired, rebuilt, or retired. The vibration pattern of each machine are as distinctive as fingerprints, and their correct interpretation can save millions of dollars by timely preventive maintenance. His skill, experience, and rules of thumb, which had served him well, were painstakingly embedded in lines of software code. Today, even though the real Charley is gone, for the cost of $15,000, the price of a 50-megabyte workstation, an old factory’s productivity is raised, and training time for maintenance people is greatly reduced. If the system cannot diagnose the trouble with certainty, it will offer a series of probabilities: a 60 percent chance the bearings are worn or a 70 percent chance that the alignment needs attention. Charley would be proud of the results.
Expert systems, artificial intelligence programs, computer aided design and computer aided manufacturing systems are now used in major companies doing everything from process planning at aircraft plants to reformatting international payments at major money center banks around the world
page.31.
to designing and processing machine parts. All of these knowledge-based systems create value. They have become the essential component of industrial success.
In a newly automated General Electric(GE) locomotive plant in Erie, Pennsylvania, integrated information systems are weighted heavily toward the improvement of the management process itself. The system includes inventory control, order-entry systems, shop-floor reporting systems employing bar codes and wand-reading devices, payroll and accounting, master scheduling work, production control, job tracking and more. Since 1984 the new systems have been largely responsible for increasing asset turnover by 50 percent. The combination of these management systems with newly automated machine tools on the factory floor has reduced by half the labor needed to make a locomotive. In an ironic footnote, it took some time for the new savings to turn into new sales. As GE chairman Jack Welch explains, the railroad companies have so improved their own efficiency by employing modern information systems that they need fewer locomotives. “Where they used to use 4,000 locomotives, the now carry the same amount of freight with 2,500.”
As information becomes the most important factor of production, there is less matter in nearly everything we make. From 1967 through 1988, the weight of U.S. product exports, per constant dollar value, fell 43 percent. The weight of U.S. imports fell even further. Japan increased its industrial production two and a half times from 1965 through 1985 while barely increasing its consumption of raw materials and energy. As Peter Drucker has pointed out, the most important manufactured product of the 1920s, the automobile, owed 60 percent of its cost to raw materials and energy. For the microchip that figure is only 2 percent, and for typical manufactured products today material and energy costs hover between 10 and 20 percent.
Labor also is being replaced by information. In the leading industrialized economies, workers today work only a bit more
page.32.
than half as many hours a year as they did in 1900, yet capacity of these economies to produce wealth has grown by at least twenty times since then. To manufacture a product in the U.S. in 1988 required, on average only two-fifths of the blue-collar labor needed just eleven years earlier.
Even factories are shrinking as machines get smaller, use less energy, and require fewer workers to tend them. Certain types of automated manufacturing systems have reduced by 60 percent the amount of floor space required to make a product compared to just a few years ago. Computer-coordinated, just-in-time production systems reduce inventory needs and waste. The average number of employees per factory, which rose steadily in the past, has been falling lately. The average U.S. factory employed fifty-one people in 1937 but only 35 people in 1982. These changes play out the central theme of the modern economy: to create value by putting more information into products and services, or by taking matter out.
Virtually every society in history has believed that wealth flowed mainly from one form of capital, or from one type of productive activity, or from one particular sector of society. Societies have often been wrong about the source of wealth, causing misery to themselves and others. But right or wrong, both a society’s beliefs about the source of wealth, and the underlying reality crucially affect political and social structures, and the allocation of power.
For thousands of years men were nomads who attached themselves to herds of animals moving from pasture to pasture. Wealth was counted in the size of the herd. Men owned nothing that could not be carried. Land was not regarded as an asset, and its permanent control formed no part of the scanty political institutions of the day. When village agriculture began to appear land became a form of wealth, as did water. Men began to lay down rules about the ownership of land and water rights, and political power began to shift away from nomadic chieftains and toward territorial rulers.
page.33.
In the last years of the twentieth century it has been popular to say that real wealth comes from industry. Industry produces things that we can handle, things that are machined and solid, that we can see and touch. Only manufacturing creates real value by producing real goods for sale. Yet manufacturing itself was seen in an unfavorable light but a few hundred years ago. Francois Quesnay, the consulting physician to Louis the XV and a founder of the so-called Physiocrat school of economics, argued that the source of all wealth was land. His disciples had a profound influence on many important figures, including Benjamin Franklin, who wrote that “agriculture is truly productive of new wealth; manufactures only change forms, and whatever value they give to the materials they work upon, they in the meantime consume an equal value in provisions.”
The cameralists, who powerfully influenced German policy in the late eighteenth century, postulated that there were three ways of increasing wealth: by increasing the population; by mining; and by controlling foreign commerce to produce an inflow of hard currency, which the state could hoard to pay for a huge army. Cameralist policies stifled German commerce, and Germany had to wait until the nineteenth century to become an explosive commercial power. Adam Smith published in 1776 largely to dissuade the British Empire from mercantilism, which similarly held that the state should firmly manage foreign trade for apparent national advantage. In arguing for the freedom of commerce, Smith showed that the ingenuity of British workers and businessmen was worth more than the hoards of gold in the king’s treasure houses.
Smith’s daunting task was to convince the ever more powerful sovereigns of his day to relinquish some of their cherished powers over trade and production for the good of their people and thus increase the rulers’ own wealth. The emergence of the information economy will require concessions
page.34.
of sovereign authority far greater than those Smith asked of the English crown.
Sovereignty is a modern institution but a few hundred years old, though like many modern institutions it began as a medieval idea, arising out of the efforts of kings to break the power of feudal lords and city-states and remove the privileges of the Church and trade guilds. By the nineteenth century, sovereignty came to mean that power by which a sovereign was empowered to act alone, without the consent of any higher authority. In international affairs, a state is sovereign if in the ordinary course of events its decisions are not legally or customarily reviewable by any other state.
In a modern sovereign state there may be many social and economic institutions that compete with the state for power — churches, universities, corporations, voluntary associations — and some of these may be powerful. Yet all such institutions live and act at the sufferance of the sovereign. Even in as liberal a nation as the United States, for example, the churches are free of government control not by virtue of ancient historical right or the force of custom or a commonly accepted view of natural law or the divine will or the protection of a rival sovereign or the churches’ own economic, political, or military power but by the sovereign’s own law, as expressed in the First Amendment.
Few modern states have been as sovereign as classical theory implies, in large part because of the power of these private institutions. Though these institutions are never any match for the state in raw power, their utility, popularity, or prestige has generally won them some degree of autonomy from the state. Nevertheless, the broad drift of political history since the waning of the Middle Ages has been toward sovereignty.
The emergence of information as the preeminent form of capital reverses this drift toward centralizing power. The nation-state will not disappear; indeed, we will see many new nations formed. Nor will sovereignty vanish either as an idea or as an institution. But the power of the state will diminish,
page.35.
particularly its sovereign power: the power to judge without being judged, the power to delimit the powers and privileges of the other institutions within society. Even Japan, which for years appeared to be in firm control of its own destiny, is seeing market forces overwhelm its bureaucratic power. After World War II, the powerful Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) proposed that Japan’s twelve automobile companies merge to create two or three companies to battle American’s Big Three. Instead, the Japanese auto companies defied the powerful MITI, and Toyota and others refused to specialize in cars of a certain size and became market driven to produce a full line of cars the customer wanted.
Information has always been power; now it is also wealth. Nonmaterial and, with the aid of modern technology, extremely mobile, information can escape government control far more easily than other forms of capital. Draconian or even merely bureaucratic systems for controlling the flow or use of information tend to destroy or waste it. Economically useful information is usually original, innovative, or at least timely, nuanced, precise, complex, and challenging. Bureaucracies and governments live for delay, blunt originality, oppose innovation, abhor nuance. Governments are good at governing matter but everywhere misrule mind, especially the best and most productive minds, minds that are frustrated and demoralized by the pretensions of the merely powerful.
Governments are good at regulating, taxing, confiscating, and controlling things that they can readily see, measure, and keep track of, things that don’t readily move out of town or across the border and cannot be concealed inside a man’s head. Governments have always sought to exact high “rents” both in the form of taxes and other government controls from businesses located within their borders. Such rents are a very important source of government power and wealth. In an information economy, government rent collectors have much less leverage because the tenants can leave town.
In the industrial era, progress was built on massive econ-
page.36.
omies of scale, which made capital easy to exploit. As firms, plants, and machines got larger they became more difficult to move in the event of government harassment or expropriation. To Karl Marx this immobility seemed an opportunity: It was possible in those days to imagine that the state really could capture the capital assets of society and manage them for the good of the proletariat — or the . This did not often happen, and certainly not in the way Marx imagined. But the great leverage governments held against nearly captive capital — mines and land, forests and factories — did allow and promote an enormous expansion of government power. As long as capital consisted largely of factories, heavy equipment, and natural resources, governments felt free to impose rules and exact payments with no fear that the nation’s capital base would steal away in the night. Extreme impositions would reduce productivity — the Communist economies never worked very well — but on the whole, government held the cards.
All this has changed. Intellectual capital will go where it is wanted, and it will stay where it is well treated. It cannot be driven; it can only be attracted. Its movement across borders or around the world cannot be stopped, and even the most totalitarian governments can do no more than temporarily impede it. As Gorbachev discovered, states that impose exorbitant rents on information enterprises, either in taxes, regulation, or simply in political control and repression, soon will not have enough information capital to compete. Such societies are generally run by people who simply do not understand the power of information capital or the workings of a modern economy; if they had understood, they would not have imagined that police and military might could build or sustain a nation. The economic history of Easter Europe stands witness to this truth.
Under the strain of a global competition for information capital, governments are more likely to reduce rents than raise them. They will compete to cut taxes and deregulate — as
page.37.
most of the industrialized and industrializing nations have been doing for more than a decade — and they will knock down the Berlin Wall. Not all governments will move at the same speed; Tiananmen Square is but one reminder that the record is not and will not be perfect. We are speaking of a political trend, not a law of physics; but in politics, powerful trends are made by slight changes in what the Soviets used to call the “alignment of forces.”
When natural resources were the dominant factor of production, the conquest and control of territory seemed a reliable way to enhance national power. Today conquest of territory is rarely worth the cost to the nation. War and long years of pacification and repression almost inevitably destroy or scatter intellectual capital, and the material resources that might be gained by conquest are everywhere declining in value. Size can still be an advantage — the United States. will probably always be a greater power than Singapore — but imperialist adventures now have a far higher “hurdle rate of return.”
The information economy, as we shall see in greater detail later, is intractably global. In part this is because trade in information, now little bound by geography or burdened by matter, is global. A truly global economy, as opposed to the multinational economy of the recent past, will require concessions of national power and compromises of national sovereignty that seemed impossible a few years ago and which even now we can but partly imagine. Such an economy cannot be readily contained or controlled by mercantilist or protectionist strategies. The attempts of sovereign states to cut off and control little bits of the world market for their own advantage will be more obviously futile than ever in the past. And yet control of international trade has been one of the most cherished of sovereign powers since well before the Industrial Revolution.
People who carry in their heads an increasing amount of intellectual capital also pose a challenge to government, since
page.38.
if the nation is to prosper, governments must court and keep their human resources. Increasingly, their specialized knowledge will make them more difficult to govern. In many areas of economic and social life in which the government once credibly professed to be the only party both sufficiently qualified and disinterested to lay down the rules, “knowledge workers” will rightly feel themselves better informed than government regulators. Government intervention, once the cherished protection of weaker parties, will be increasingly resented and opposed by an ever larger class of such workers. These citizens are a new bourgeoisie who carry the means of production in their brains. Unlike Marx’s bourgeoisie, their power and numbers are destined to grow not decrease. And they are unlikely to view the government as a natural ally.
Nowhere will the power of these knowledge workers be more evident than in those great nongovernmental institutions whose subordination to the state is essential to sovereignty as we have known it. As Drucker writes:
Theory still postulates that there is only one organized power center — the government. But both society and polity in developed countries are now full of power centers that are outside of and separate from government. Each of these institutions has to have a great deal of autonomy to produce results.
As even the communist nations seem finally to have learned, subjecting business organizations — including nonprofit business, such as hospitals and schools — to the control of a large central government bureaucracy is not a recipe for success.
These private institutions began their rapid increase in size and power long before the computer era. The growth of the great modern private organizations dates from about the midpoint of the Industrial Revolution and was prompted by the need to organize human efforts on a scale rarely attempted outside the army. In the information economy, these institutions become relatively far stronger thanks to the infor-
page.39.
mation capital that uniquely suits them to their tasks. Those tasks become more demanding and specialized, making it harder for any generalist, including those who run the government, to supervise their work without stymieing it. The people who dominate these institutions — even when they do not formally run them — are professionals, treated by their own supervisors not as subordinates but as colleagues. They do not respond well to old “command and control” styles of management, nor do they have to: They are conscious of their value. The transformation of General Electric from a huge bureaucracy to a company where the people on the shop floor are the ones whose ideas are not only heard but implemented has turned out to be the premier example of this phenomenon. What is true for the inhabitants of these institutions is true for the institutions as a whole. The information economy increases these institutions’ need for autonomy as well as the intellectual and economic leverage by which they procure this autonomy.
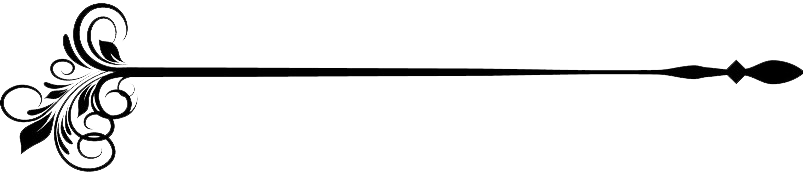
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our WorldWriston, Walter B. 1992 Chapter OneThe Twilight of the Idols | |
| The old order changeth, yielding place to the new…lest one good custom should corrupt the world. | |
| Alfred, Lord Tennyson | |
| DIPLOMATS, HISTORIANS, POLITICIANS, OR PHILOSOPHERS rarely identify technological change as a decisive force in the rise and fall of nation-states, preferring to explain the course of history by the efforts of men and women like themselves. | |
| In ancient Greece, Plato tells us, the leading men of the city did not hold engineers in high regard: “You despise him and his art,” he wrote, “and sneeringly call him an engine-maker, and you will not allow your daughter to marry his son or marry your son to his daughter.” Little has changed. | |
| In today’s world, many would have to concede that important technological breakthroughs may temporarily change the military or economic balance of power. Even the most jaded diplomat would agree that the balance of power in the world altered decisively on July 16, 1945 on the desert of Alamogordo, New Mexico when the first atomic explosion took place. Relations between nations were instantly altered, and the very survival of our planet came into question. Yet many of us assume that however much technology may alter the means by which nations pursue their basic geopolitical interests, those interests themselves will remain the same. This is not always the case. | |
| page 2 | |
| The additive developments in science and technology that are often summed up in the phrase “the information revolution” are altering the shape and direction of national and international events in fundamental ways. We are witnessing a revolution in the relationships among sovereign states, in the relationships between government and citizens and between those citizens and the most powerful private institutions in society. And the “engine makers” are the leading revolutionaries. | |
| The information revolution is profoundly threatening to the power structures of the world, and with good reason. The nature and powers of the sovereign state are being altered and even compromised in fundamental ways. The geopolitical map of the world is being redrawn. The elements of the balance of power that has prevailed for the last forty years have already been permanently disturbed and may soon be irretrievably altered or lost. Other institutions of our world, the business corporation chief among them, face equally powerful challenges to their modus operandi and will undergo profound changes that will affect all who are associated with them. | |
| The information revolution, despite being the most frequently announced revolution in history, is still little understood. Many of the innovations that were trumpeted the loudest and earliest have never arrived: the checkless society, the paperless office, newspapers over cable TV, a helicopter in every backyard. Many of them may never arrive. But revolutions are not made by gadgets but by a shift in the balance of power. The underlying forces of the information revolution are causing such a shift in the balance of economic, political, and military power. | |
| The information revolution is usually conceived, quite rightly, as the set of changes brought on by “information technologies,” the two most important being modern communications technologies, for transmitting information and modern computer systems for processing it. (page 3) | |
| The marriage of these two technologies is now consummated. It is impossible to tell where communication stops and where computing begins. After years of study, in an attempt to determine which bureaucracy should have regulatory power, the federal government gave up on efforts to draw this distinction. In addition to powerful effects on culture and the pace of life, this revolution has changed what we do for a living. It has made many or most of us into what Peter Drucker long ago called “knowledge workers” and is changing the way the rest of us do such traditional jobs as mining and manufacturing, selling and shipping. | |
| Most of us would probably be inclined to say that such dramatic changes are quite enough of an accomplishment for any revolution and that this one could retire from the field with a good day’s work done. But underlying and driving the information revolution are two powerful tides that are rocking the power structures of the world: The first is the vast increase and swift and widespread dissemination of knowledge and of information of all sorts. The second is the increasing importance of knowledge in the production of wealth and the relative decline in the value of material resources. | |
| From the beginning of time, power has been based on information. Someone learned to use a burning glass to start a fire; someone was able to find out where enemy troops were. Someone knew how to build a castle wall strong enough to withstand a siege, until someone else learned how to build a catapult or a cannon. Some politician found a pollster who gave notice of what the citizens really worried about. Timely information has always conferred power both in the commercial and the political marketplace. | |
| The dissemination of once closely held information to huge numbers of people who didn’t have it before often upsets existing power structures. Just as the spread of rudimentary medical knowledge took away the power of the tribal witch doctor, the spread of information about alternate life-styles in other countries threatens the validity of some official political doctrines, the credibility of the leadership, and the stability of the regime. | |
| (page 4) | |
| The marriage of the computer with telecommunications, resulting in movement of information at the speed of light and to enormous audiences, tends to decentralize power as it decentralizes knowledge. When a system of national currencies run by central banks is transformed into a global electronic marketplace driven by private currency traders, power changes hands. When a system of national economies linked by government-regulated trade is replaced ( at least in part) by an increasingly integrated global economy beyond the reach of much national regulation, power changes hands. When an international telecommunications system, incorporating technologies from mobile phones to communications satellites, deprives governments of the ability to keep secrets from the world, or from their own people, power changes hands. When a microchip the size of a fingernail can turn a relatively simple and inexpensive weapon into a Stinger missile, enabling an illiterate tribesman to destroy a multi-million dollar armored helicopter and its highly trained crew, power changes hands. | |
| The dictionary defines knowledge as the “acquaintance with facts, truths or principles, as from study or investigation.” But knowledge can also be thought of as what we apply to work in the production of wealth. Knowledge is the ultimate source of value in work. | |
| A rabbit running free through the meadow is not wealth. It becomes wealth as a result of information applied to the work of a hunter: information about where to find game, how to stalk it, how to throw a spear or shoot an arrow, how to make the arrow, the bow, or the spear. All these bits of information taken together and applied to the hunter’s work produce value, that is, dinner for the hunter, his family, or the whole tribe. | |
| Economists have a name for the work the hunter does to turn rabbit into roast: value-added. (page 5) Even in ancient days a considerable portion of that value-added was intellectual: the hunter’s knowledge and skill. Nevertheless, in those days the bulk of the value-added was physical , long days in the field pursuing the rabbit, long and arduous efforts in shaping spear or bow, sharpening arrow or spearhead. And, of course, the original value in the deal was supplied by the rabbit, which fattened itself up in the meadow in pursuit of an agenda somewhat different from the hunter’s. | |
| Economic progress is largely a process of increasing the relative contribution of knowledge in the creation of wealth. The value of an ear of wild grain harvested by hunter-gatherers was almost entirely material, a gift of nature. Come the agricultural revolution, and an ear of hybrid corn grown in carefully fenced, rotated, fertilized, and irrigated fields is to a very considerable extent the product of mind. The industrial revolution advanced the process further still as men greatly increased their capacity to manipulate matter and shape it to their needs. | |
| In our time, the knowledge component of nearly all products has vastly increased in importance. As George Gilder has pointed out, the fundamental product of the information age, the microchip, the key component of all modern communications and computer technology, consists almost entirely of information. Raw materials account for about 1 percent of its costs; labor of the traditional sort for another five percent. A majority of the cost — and value — comes from the information incorporated into the design of the chip itself and into the design and development of the highly specialized equipment used to manufacture it. | |
| The information technologies made possible by the chip have a profound effect on the rate of advance of all science since calculations that used to take years can now be done in minutes. Scientific knowledge is currently doubling about every fifteen years. This vast increase in knowledge brings with it a huge increase in our ability to manipulate matter, | |
| increasing its value by the power of mind, generating new substances and products unhinted in nature and undreamed of but decades ago. (page 6) | |
| The effort to find, secure, and transport relatively rare natural resources — minerals, metals, coal, and oil — has been a key theme of economic production since the onset of the industrial age. Yet the value of all these materials is declining as the power of mind, enhanced by the intellectual hydraulics of information technology, is employed to replace them or economize on their use. Plastics replace metal and stone, fiber optic cable replaces copper. Microchips are made from virtually worthless sand, and superconducting ceramics, from common clay. | |
| As computer-assisted calculations speed scientific investigations, so do they accelerate and simplify engineering and design. Better designs produce more efficient products, from airplanes to ovens, reducing energy needs and conserving on coal, oil and other fuels. Indeed, prices of raw materials have been slumping worldwide for several decades, with only occasional and short-lived exceptions produced by OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) or other political cartels. | |
| The old industrial age is fading and being slowly replaced by a new information society. This transition does not mean that manufacturing does not matter, or that it will disappear, any more than the advent of the industrial age meant the disappearance of agriculture. What it does mean is that the relative importance of intellectual capital and intellectual labor will increase as that of physical labor and material capital declines. Knowledge applied to work has always created value, although many economists have tended to overlook its vital significance. In the world we are building, such an oversight will be increasingly difficult. | |
| In sum, the world of work, the drama of economic production, the essential basis of our material existence, which for several centuries has been dominated by the brute forces of industry, is now dominated by products and processes that consist more of mind than of matter. (page 7) | |
| These products and processes are faster more mobile, have less need of centralized support, and are less dependent on natural resources, physical plant, or human labor than those of the recent past and thus are becoming far more difficult to regulate or control. | |
| Sovereignty, defined by the , as “the supreme undivided authority possessed by a state to enact and enforce its law with respect to all persons, property, and events within its borders,” is one of the most important ordering ideas of the modern world, a bulwark of modern power structures. Yet it is a relatively recent idea, first given to us in a full-bodied form by the great Dutch jurist Hugo Grotius in his seminal work (Concerning the Law of War and Peace) in 1625. It is certainly possible to imagine a world in which state sovereignty as we know it did not exist or existed in substantially altered form. | |
| As the dictionary definition implies, sovereignty has always been, in part, based on the idea of territoriality. The extent of sovereign’s reach has usually been defined by geographic borders. Even the immunities enjoyed by a foreign embassy are expressed in part geographically, by defining an area into which the host country may not intrude. | |
| The control of territory remains one of the most important elements of sovereignty. But as the information revolution makes the assertion of territorial control more difficult in certain ways and less relevant in others, the nature and significance of sovereignty is bound to change. | |
| As recently as World War II, armies fought and men died for control of the iron and steel in the Ruhr basin because ownership of those assets conferred real economic and political power. Today these once fought over assets may be a liability. To the extent that new technology replaces once | |
| essential commodities with plastics or other synthetic materials, the relative importance of these areas to the vital interest of nations is bound to change. (page 8) | |
| In 1967, Egypt closed the Suez Canal, and conventional wisdom told us that the lights would go out all over the world if this waterway between the Mediterranean Sea and the Gulf of Suez were ever closed. The power of a sovereign state, Egypt, to block the flow of oil to Europe was believed to be absolute short of war or other hostile action by the Western powers. The conventional wisdom did not take into account the technology that would allow the building of supertankers that could carry oil around the Cape of Good Hope economically. This feat was achieved by relatively simple technology, but it decisively altered the geopolitics of the Middle East. Similarly, advances in military technology are making once vital strategic “choke points” steadily less relevant. The velocity of change in economics, technology, science, and military capabilities is shifting the tectonic plates of national sovereignty and power. | |
| One traditional aspect of sovereignty has been the power of nation-states to issue currency and mandate its value. Of course, the claims kings made for the worth of their currency did not always square with the facts. In the seventeenth century the Amsterdam bankers made themselves unpopular in the royal chambers by weighing coins and announcing their true metallic value. But those bankers spoke to a small audience and their voices were not heard very far beyond the city limits. Despite the power of a righteous market, until very recently governments retained substantial power to manipulate the value of their currencies. As the information revolution has rendered borders porous to huge volumes of high-speed information it has deprived them of that power. | |
| The new international financial system was built not by politicians, economists, central bankers or finance ministers but by technology. Today, information about the diplomatic, fiscal, and monetary policies of all nations is instantly transmitted to electronic screens in hundreds of trading rooms in dozens of countries. (page 9) | |
| As the screens light up with the latest statement of the president or the chairman of the Federal Reserve, traders make a judgement about the effect of the new policies on currency values and buy or sell accordingly. The entire globe is now tied together in a single electronic market moving at the speed of light. There is no place to hide. | |
| This enormous flow of data has created a new world monetary standard, an Information Standard, which has replaced the gold standard and the Bretton Woods agreements.[2] The electronic global market has produced what amounts to a giant vote-counting machine, that conducts a running tally on what the world thinks of a government’s diplomatic, fiscal and monetary policies. That opinion is immediately reflected in the value the market places on a country’s currency. | |
| Governments do not welcome this Information Standard any more than absolute monarchs embraced universal suffrage. Politicians who wish to evade responsibility for imprudent fiscal and monetary policies correctly perceive that the Information Standard will punish them. The size and speed of the worldwide financial market doom all types of central bank intervention, over time, to expensive failure. Moreover, in contrast to former international monetary systems, there is no way for a nation to resign from the Information Standard. No matter what political leaders do or say, the screens will continue to light up, traders will trade, and currency values will continue to be set not by sovereign governments but by global plebiscite. | |
| The new global market is not limited to trade in financial instruments. The world can no longer be understood as a collection of national economies. The electronic infrastructure that now ties the world together, as well as great advances in the efficiency of conventional transportation, are creating a single global economy. | |
| Commerce and production are increasingly transnational. The very phrase “international trade” has begun to sound obsolete. In the past, companies generally exported and imported products. On a national level, these transactions were aggregated and balanced according to the rules of a zero-sum game. Today this is no longer the rule. (page 10) | |
| A product may have value added in several different countries. The dress a customer purchases at a smart store in New York may have originated with cloth woven in Korea, finished in Taiwan, and cut and sewed in India. Of course, a brief stop in Milan, to pick up a “Made in Italy” label is de rigueur before the final journey to New York. Former Secretary of State George Schultz recently remarked in a speech: | |
| A few months ago I saw a snapshot of a shipping label for some integrated circuits produced by an American firm. It said, “Made in one or more of the following countries: Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Mauritius, Thailand, Indonesia, Mexico, Philippines. The exact country of origin is unknown. That label says a lot about where current trends are taking us. | |
| Whatever the correct word for these phenomena,”trade” certainly seems an inadequate description. How does one account in the monthly trade figures for products whose “exact country of origin is unknown?” How are national governments to regulate transnational production with anything like the firmness with which they once regulated international trade? How are politicians to whip up nationalist fervor against foreign goods when American car companies build cars in Mexico for export to Japan and pay the profits to pensioners in Chicago and the Japanese build cars in Tennessee for export to Europe and use the income to refinance real estate in Texas? | |
| On the global business front, the new word is “alliances.” Almost every day one reads about an American company and a Japanese company or a Swedish company and a German company — the list of combinations is endless — forming an alliance to offer a new product in a multinational horizontal integration of manufacturing, marketing, finance, and research. (page 11) | |
| As these alliances grow and strengthen over time, it will become harder and harder for politicians to unscramble the emerging global economy and reassert their declining power to regulate national life. | |
| The global market has moved from rhetoric to reality almost before we knew it. The old political boundaries of nation-states are being made obsolete by an alliance of commerce and technology. Political borders, long the cause of wars, are becoming porous. Commerce has not waited for the political process to adjust to technology but has tended to drive it. This is especially noticeable in Europe, where the new generation of business managers is bound and determined that the integration of the Common Market in 1992 will arrive on schedule, even though political leaders often seem reluctant to see their power compromised. | |
| Within national borders, sovereignty has traditionally entailed the government’s power to regulate the leading enterprises of society, from health care to heavy industry. In an economy dominated by products that consist largely of information this power erodes rapidly. As George Gilder has written “A steel mill, the exemplary industry of the industrial age,” lends itself to control by governments. | |
| Its massive output is easily measured and regulated at every point by government. By contrast, the typical means of production of the new epoch is a man at a computer work station, designing microchips comparable in complexity to the entire steel facility, to be manufactured from software programs comprising a coded sequence of electronic pulses that can elude every export control and run a production line anywhere on the globe. | |
| The information revolution not only makes the microeconomy more difficult to regulate; it makes the macroeconomy — the world of gross national product (GNP) aggregate demand, and seasonally adjusted statistics — harder to measure and therefore harder to control. (page 12) | |
| Many of the terms we use today to describe the economy no longer reflect reality. Everyone knows, for example, that all the lights would go out, all the airplanes would stop flying, and all the financial institutions and many of the factories would shut down if the computer software that runs their systems suddenly disappeared. Yet these crucial intellectual assets do not appear in any substantial way on the balance sheets of the world. Those balance sheets, however, do all reflect what in the industrial age were tangible assets — buildings and machinery — things that can be seen and touched. | |
| How does a national government measure capital formation when much new capital is intellectual? How does it measure the productivity of knowledge workers whose product cannot be counted on our fingers? If it cannot do that, how can it track productivity growth? How does it track or control the money supply when the financial markets create new financial instruments faster than the regulators can keep track of them? And if it cannot do any of these things with the relative precision of simpler times, what becomes of the great mission of modern governments? Controlling and manipulating the national economy? Even if some of these measurement problems are solved, as some surely will be, the phenomena they measure will be far more complex and difficult to manipulate than the old industrial economies. | |
| The single most powerful development in global communication has been the satellite, born a mere thirty-one years ago with the launch of Sputnik. Satellites now bind the world, for better or worse, in an electronic infrastructure that carries news, money, and data anywhere on the planet at the speed of light. Satellites have made borders utterly porous to information. Geosynchronous satellites can and do broadcast news over curtains of iron, bamboo, or adamant to anyone with a hand-held transistor radio. (page 13) | |
| One of the fundamental prerogatives assumed by all sovereign governments has been to pursue their national interests by waging war. Today this prerogative is being severely circumscribed by information technology. No one who lived through America’s Vietnam experience could fail to understand the enormous impact that television had in frustrating the government’s objective in Southeast Asia. Knowing in a general way that war produces violent death is one thing, but watching the carnage of a battle or the body bags being unloaded at Dover Air Force Base, on your living-room television set is quite another. | |
| We have seen in the United States an organization publish the names of American agents in place overseas; we have read accounts in national newspapers detailing American naval and troop movements at a time of national emergency. Recently, a private company forced a superpower to change its policy. This occurred when the government monopoly on photographs from space was broken by the launching, in February 1986, of the privately owned French satellite, SPOT. When the pictures of the Chernobyl nuclear disaster taken by SPOT appeared on the front pages of the world’s newspapers, the Soviet Union was forced to change its story and admit that the event was much more serious than it had previously claimed. In this instance the technology was not new, but the power to use information shifted from the government to the private sector. The event posed a continuing dilemma: What SPOT revealed about Chernobyl, it can also reveal about American military sites. There is no American censorship of SPOT pictures as there had been on a de facto basis of photos taken from the American government’s Landsat satellite. | |
| While the resolution of SPOT’s picture is only ten meters, it will undoubtedly be improved. The next logical development might be for an international news agency to purchase its own high-resolution satellite. Such a purchase would be a good deal less expensive, for instance, than the cost of cov- | |
| ering the Olympics. (page 14) If this happens, the guardians of national security will clash in space with the defenders of the First Amendment. | |
| If democratic societies will have difficulty adapting to what amounts to a whole new definition of sovereignty, closed societies such as the Soviet Union, will have a much more difficult time. Communist regimes have always based their power in part on their ability to control what their citizens see and hear. That control was seriously eroded by technology. News of the in Eastern Europe was instantly relayed by radio and TV to the people of the former Soviet Union. The number of VCRs available in Moscow has been growing daily. Satellites are no respecters of ideology. Even the most draconian measures would be unlikely to halt the trend. | |
| Nor can the former Soviet Union afford draconian measures. On the contrary, it faces an economic imperative to loosen controls further. Modern economies require access to huge amounts of information and the computer power to manipulate it. The free flow of scientific and technological knowledge is essential to innovation and continued productivity. Millions of researchers, scientists, and citizens in the United States now have access through their personal computers (PCs) to more than three thousand publicly available data bases, some storing billions of bits of technical, demographic, or scientific data. The Soviet Union, in which information is the monopoly of the state and where even the GNP is a classified number, handcuffed itself. If the Kremlin wishes to keep up with pace with the West, it must allow its people to participate in the information revolution. But if it does so it will lose an essential tool of state control. It is a Hobson’s choice, and it will get more difficult over time. Indeed, history has resolved the dilemma with a swiftness that took all pundits by surprise. | |
| The satellite, for all its power, is but a subset of a whole new class of “information weapons,” weapons whose value is supplied largely by information technologies. As a rule, information weapons are equalizers that help small nations against large and favor defender over invader. (page 15) | |
| Perhaps the most dramatic current example is the use of the Stinger by the Mujahedin against the Russian invaders. The Stinger is one of the first truly “smart” missiles to be used extensively in battle. It has demonstrated decisively that “artificial intelligence” can make a weapon costing but thousands of dollars, and affordable to even guerrilla armies, the superior of multimillion-dollar aircraft affordable in any considerable quantity only to the superpowers. | |
| A less violent, but perhaps more destructive information weapon is the “software virus,” dramatically illustrated in November 1988 by the invasion of a Department of Defense computer network by one such destructive program. Scott A. Boorman and Paul Levitt, have argued that “with computer software now eighty percent of U.S. weapons system in development, attacks on the software…may be the most effective, cheapest, and simplest avenue to crippling U.S. defenses.” Such sabotage may be within financial and technical reach of the smallest nations. | |
| The challenge to national sovereignty poised by the information revolution is being replicated in various ways throughout most of the institutions of the modern world. In the business organization, the person who truly understands the impact of technology has become a vital part of the whole strategic business process. We see new corporate structures developing to manage new manufacturing methods, products, and delivery systems. Management structures are already changing dramatically. Layers of managements that used to do nothing but relay information from one level to another are beginning to disappear. Business is learning that these positions are no longer needed now that information technology allows the rapid transmission of vital information to all levels of management without human intervention. Instead, the old military mode of hierarchical organization is giving way to flatter structures designed for the faster response times needed to serve dynamic global markets. (page 16) | |
| A walk through a modern factory makes the point. Manufacturing plants are being run by computer hardware and software. The man with the clipboard who makes sure the widgets are in the right place on the shop floor at the right time is disappearing; the computer does it. The task of transmitting upward information on the state of the business is even more thoroughly automated. And more people in the system now have access to that information. Reports that used to take days or weeks to prepare, as well as the considerable support staff available only to senior management, are now available throughout the system at the stroke of a few computer keys. Plato wrote that democracy cannot extend beyond the reach of a man’s voice, a limitation that provided a pretty good justification for the old system. In the new world, we may not see corporate democracies, but we will see the skills of command outstripped by the demand for leadership. | |
| This sea change in our most important economic institutions (indeed in any of our great bureaucracies) will affect our daily lives and work in important ways. But as we shall see, the effects on society as a whole, while more subtle perhaps than those brought about by a revolution in the meaning and practice of national sovereignty, may be every bit as profound. | |
| One of the recurring themes of history is our apparent inability to credit information that is at variance with our own prejudgments. Examples abound. The great historian Barbara Tuchman uses the Japanese attack on Pearl Harbor to illustrate the point. Though Japan had opened the Russo-Japanese war in 1904 by a surprise attack on the Russian fleet, American authorities years later dismissed the possibility of a similar maneuver. | |
| We had broken the Japanese code, we had warnings on radar, we had a constant flow of accurate informa- | |
| tion … we had all the evidence and we refused to interpret it correctly, just as the Germans in 1944 refused to believe the evidence at Normandy… Men will not believe what does not fit in with their plans or suit their prearrangements. (page 17) | |
| This phenomenon, unfortunately, is not limited to discrete events. Few members of the current power structure wish to contemplate its decline, preferring to cherish the plans they have made, the strategies for victories economic, political or military. But the contests for which they have faithfully prepared may never come, at least in the form expected, because the rules have been changed forever. | |
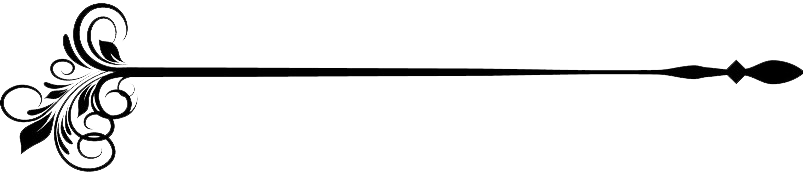
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Three
The Global Conversation
In the early years after the Russian Revolution, Leon Trotsky reportedly proposed to Stalin that a modern telephone system be built in the new Soviet state. Stalin brushed off the idea, saying, “I can imagine no greater instrument of counterrevolution in our time.”
Wilson P. Dizard and S. Blake Swensrud in
THE PHILIPPINES HAS MANY COLLEGE GRADUATES AND NOT always enough jobs for them. Until recently they faced a hard choice: emigrate to a place where they can profit from their skills or stay home in a relatively menial, low paying jobs. Today they enjoy a new option. Stay at home and export the products of their minds over the electronic infrastructure of the global economy. Several U.S.-based Big Six accounting firms, for instance, now perform computer-assisted audits for American clients using customized software programs written by Filipino programmers and shipped via satellite back to the States. For some jobs the raw financial data is put online and shipped to the Philippines, where the books are audited half a world away from the company headquarters.
The Philippines is not unique. Indian programmers write millions of lines of code for such companies as American Express for use in data centers. Meanwhile, construction and engineering firms are using computer-assisted designs made in Taiwan to build structures anywhere in the world.
Page 41
All of this work is done by skilled labor that has no occasion to apply for an immigration visa or a green card.
Geography and local conditions no longer condemn the intellectual resources of the provinces to chronic underemployment. Immigration quotas that bar physical travel have no effect on intellectual capital, since virtually the entire globe is bound together by an electronic delivery system — including not only a revolutionized telecom system but a global network of satellite and broadcasting technologies, electronic markets and VCRs — through which information, news, and money move from place to place with astonishing ease and speed.
This new electronic superhighway can transform the livelihood of a farmer in a small village on a faraway island nation or handle in a single day an exchange of financial assets that exceeds the gross national product (GNP) of most of the countries in the world. Telephones were only recently installed in several Sri Lanka villages. Until then, farmers had sold their produce to wholesalers for but a fraction of its market value in the capital city of Colombo. After the telephone came, the farmers always knew the prices in the city market and increased their income by 50 percent. Even such a simple manifestation of the power of a telecom network can change economic destinies and may start a train of political events of immense consequence.
The very same network in the past few years has revolutionized the way the world’s money is traded. As late as 1973 the world money market, such as it was, resembled a giant telephone bee. Groups of traders sitting around banks of black telephones would dial up other traders or brokers with their bids and offers, laboriously shopping for the best deal. No matter how industrious the traders were, they saw only a small part of the market. In 1973 this all changed when Reuters replaced those black telephones with a video terminal, called Monitor, that assembled bids and offers from banks
Page 42
and trading rooms all over the globe, displaying them on request for everyone on the system to see, thereby creating the first true global money market. Reuters and similar services provided by other companies have wrought a greater transformation in world financial markets in fifteen years than those markets had undergone in the previous centuries. As recently as 1980, the daily volume of trading in the foreign exchange market in the United States was estimated at only $10.3 billion. By 1989, this total had grown to an average of $183.2 billion per day. And the U.S. market is but one part of a global market, albeit a substantial one.
The telephone has been around for more than a century, and radio and television for several generations, so it is easy to imagine that the new network is not new at all and represents nothing more than a marginal, if significant, enhancement of an institution long assimilated to the economic and political structures of the world. Nothing could be further from the truth. The new global network is a radical innovation, fundamentally changed not only in quantity but quality from the system of but twenty years ago. Since our legal system is based on the written word, the telephone was viewed with some skepticism by governments and courts. The question of whether or not an oral contract, if made by telephone, was valid took years to adjudicate. Today foreign exchange contracts of up to one year — absent fraud — are routinely binding. To guard against fraud, every trading room keeps a record on tape of all conversations over the network so that there can be no dispute about what was said.
Practically speaking, even ordinary international telephone service — regular voice lines, nothing fancy — is barely more than a generation old. The first transatlantic cable capable of carrying telephone voice transmissions was not laid until 1956. It could carry a grand total of thirty-six very expensive conversations at one time. Quality was frequently poor, too poor for transmission of complex nonvoice messages, such as the computerized data used by electronic markets.
Page 43
Moreover, data transmission uses much more cable capacity than does voice; in 1956, any attempt to move data on transatlantic cable would have quickly clogged every available line.
In the 1950s and 1960s the difficulty of getting a telephone connection from Citibank headquarters in Brazil to world headquarters in New York was monumental. There were so few international lines available that it could take a day or more to get a circuit. Once the connection was made, people in the branch would stay on the phone reading books and newspapers aloud all day just to keep the line open until it was needed. The local situation was hardly better. Citibank had to hire squads of Brazilian youths, whom we called dialers, who did nothing but dial phones all day in hope of getting through.
It was not possible to build a truly global economy under such conditions. The global information economy lives on the phone: In all the leading industrialized economies telephone density now approaches one telephone per person. Yet as recently as the mid-1960s, France, West Germany, Italy, and Japan all had fewer than fifteen phones per hundred people. An American tourist might have been surprised to discover that his Naples hotel room lacked a phone or that a French acquaintance’s only home telephone was the public one on the street corner. Today over 100 million telephone calls, utilizing some 300 million access lines, are completed worldwide every hour. It is estimated that the volume of phone transactions will triple by the year 2000. As late as 1966, the transatlantic cable could still handle only 138 conversations between all of Europe and all of North American at any one time.
Then came a dramatic series of technological developments. In 1966 a new and vital satellite link in the global net was positioned in a geosynchronous orbit over the Atlantic. At an altitude of 22,000 miles above the equator, satellites take exactly one day to complete a revolution and so remained
Page 44
fixed over the same spot on earth. As both governments and private companies developed better use of the electromagnetic spectrum, the capacity of satellites has increased by a factor of about forty-five and counting. Meanwhile, back on earth we were still practicing a nineteenth-century concept of sovereignty expressed in a statute passed by Congress on May 27, 1921, mandating “that no person shall land or operate in the United States any submarine cable directly or indirectly connecting the United States with any foreign country…unless a written license to land or operate such cable has been issued by the President of the United States…”
While the president contemplates the wisdom of issuing a license, his country is “connected” to every “foreign country” by myriad channels over which he has little, if any, control.
In 1976, the sixth transatlantic cable was laid. Using new technologies, it could carry four thousand conversations at once, a real breakthrough in capacity. The first fiber-optic transatlantic cable, laid in 1988, could carry forty thousand conversations at once. In the early 1990s the world will have almost a million and a half voice-capable intercontinental circuits at its disposal.
A hefty portion of those circuits travel via geosynchronous communications satellites, which in the past twenty years have become an essential part of the world communications infrastructure. Other crucial technological advances include dramatic increases in cable capacity and switching efficiency and sophistication. Fiber-optic cable, which bears light impulses over “glass” fibers can carry far more information than copper wires bearing streams of electrons. Electronic switches — essentially specialized computers — replaced the old mechanical arrays, cutting costs, increasing capacity, and facilitating “multiplex” switching, the practice of sending several conversations over the same circuit simultaneously.
This completely new telecom system has already made a global market in such easily digitized phenomena as money and securities, computer programs and engineering designs.
Page 45
But the combination of the new global telecom system with advances in other communications media is creating a world market not only in every other sort of economic product and service but in culture and entertainment, fashion, and even government. It has made a reality of Marshall McLuhan’s global village by drawing nearly all the world into a single global conversation, one that now assesses, approves, and disapproves globally products and services, institutions and ideas, that once were evaluated primarily on local markets.
Markets are voting machines; they function by taking referenda. In the new world money market, for example, currency values are now decided by a constant referendum of thousands of currency traders in hundreds of trading rooms around the globe, all connected to each other by a vast electronic network giving each trader instant access to information about any factor that might affect values. That constant referendum makes it much harder for central banks and governments to manipulate currency values.
In the same way, modern communications technologies, including the vast expansion of the telecom network, VCRs, electronic data bases, ever cheaper and simpler techniques for collecting and broadcasting the news, and the fax machine, are creating a global market that takes constant referenda on what in many ways is beginning to look like a global culture. While hundreds of thousands of financial specialists now have instant access to economic and financial news, hundreds of millions of people around the world are plugged into a single network — albeit with local interests and subdivisions — of popular communication. All of a sudden, everyone has access to everything. CNN news is available to a huge portion of the world’s population. Tens of millions of Chinese and Indians, Frenchmen and Malays, are watching “Dallas” and the “Honeymooners,” which in their way may be more subversive of sovereign authority than CNN.
Page 46
The people plugged into this global conversation are voting — for Madonna and Benetton, Pepsi and Prince — but also democracy, free expression, free markets, and free movement of people and money. Indira Gandhi is said to have remarked that in the Third World a revolution could be started when a peasant glimpsed a modern refrigerator in a TV sitcom, a remark that almost perfectly sums up the power of the global culture market.
This market, of billions of plugged-in “culture traders,” is now the most powerful social and political force in the world. It is at the heart of the breakup of communism and the unification of Europe. The fear of global culture market is one of the powerful motive behind the emergence of the Islamic republics and their desperate drive to cut their people off from modernity.
Not everyone is fully plugged in to the global conversation or equipped to take full advantage of it. Those who fully participate in the information economy benefit most from it. The global network is the essential infrastructure of that economy, and its use promises to make its users into a single worldwide community sharing many tastes and opinions, styles of dress, forms of government, and modes of thought. These people, on the whole, will be internationalists in their outlook and will approve and encourage the worldwide erosion of traditional sovereignty. They will feel more affinity to their fellow global conversationalists than to those of their countrymen who are not part of the global conversation. These latter will have little at stake in the global conversation and may come to hate it and those who participate in it as they realize that in all this talk they are rarely mentioned and then only as a social problem. All technological progress has created social problems, and the information revolution moving over the global network is no exception. New skills and new insights will be required to survive and prosper, and those who do not or cannot adapt will be left behind with all the social trauma that entails.
The global network is often viewed as a mixed blessing by governments. Yet it is the one path to prosperity in the global information economy.
Page 47
Now that there are global markets in money, in information capital, in a steadily growing portion of the world’s products and services, and even in human intellect — all utterly dependent on the new world communications network — no nation can hope to prosper in the future unless it is fully hooked up to the network and its citizens are free to use it.
A nation can walk this path to prosperity only if its government surrenders control over the flow of information. In the world we are building today it is almost impossible to assert sovereignty over information because information and the pathways over which it travels, including the heavens themselves, are shared in common. The sovereign can, at enormous cost, cut his nation off from some of those shared pathways by shutting down the international phone circuits or shooting anyone caught with a fax machine, a radio, or a tiny satellite dish. Even then he cannot succeed entirely. When he is finished, he will be ruler of Albania.
Fax machines and computer-driven telephone switches came to China because the Chinese rulers wanted a modern economy; within months they became an infrastructure of revolution. That revolution was brutally suppressed, but the leadership has not found — and never can find — a way to build an information economy in a closed society.
In the West we are well used to a free market in public attention: Publishers, producers, and politicians all know that they must persuade the audience to lend its ears and eyes, which means giving the audience what it wants. This may not always be good for high culture, but the competition of ideas makes a propagandist’s life difficult.
Recently a young Chinese filmmaker made a documentary about the Chinese army which found its way onto cable TV. The film shows exhilarating and terrifying scenes of a tank division training in Mongolia — impressively uniformed and disciplined troops responding to the call to battle, mounting their tanks and getting a division on the roll, it seemed, in a matter of minutes.
Page 48
But the very next scene the same troops, now stripped down to T-shirts and fatigues, their change in costume revealing them for teenage boys, break dancing to American music blasting from a boom box. How well can patriotic indoctrination work when it faces such an open competition from competing entertainments? It has been said that the sixties generation sung America out of Vietnam. Will Chinese soldiers dance their way out of the next Tiananmen Square?
Satellites have been perhaps the principal force in altering the “balance of information power,” tipping it away from the state and toward the individual. Until 1986, Landsat, with its thirty-meter resolution, offered the only commercially available photographs from space. Then there was the launching in February 1986 of the privately owned French satellite SPOT, with a ten-meter resolution. The Russians then entered the fray by offering to sell to anyone with the cash their best-quality imagery with a five-meter resolution. The U.S. government was forced to reverse its policy and permit American private companies to own high-resolution satellites. This in effect removed the de facto censorship of the photos taken by Land stat and loosened one more sovereign prerogative. It is not beyond the realm of possibility for American or other new agencies to purchase their own high-resolution satellites; indeed, it would be a good deal less expensive than covering the Olympics.
Satellite communications, combined with innovations in video recording technology, are turning the entire world into a local news beat. Until the mid-1970s no one had ever heard of “minicams,” the relatively inexpensive portable video cameras that record sound and picture on a tape cassette. Minicams can and do go anywhere and have eliminated cumbersome cables, thousands of pounds of equipment, and the time needed to process film and transfer it to tape. Equally important has been the advent of the mobile satellite hookup, by which a portable camera, linked by but one cable to a mobile video truck, can send sound and picture first to a local TV station and from thence to a satellite and around the world.
Page 49
These two technologies have dramatically speeded and expanded television reportage. In the 1970s fewer than half of all television news stories were shown on the day they happened. Today, except for in-depth “magazine” features, nearly all news is broadcast the day it is taped. In the early 1970s it cost $4,000 to get a line to send television material from Seattle to New York. Today, by satellite, it costs about a tenth as much. Governments could once count on knowing more about sensitive international events than their citizens. Now they often find themselves following those events on television. A CNN monitor sits in the corner of all government crisis-management centers of the U.S. Government.
Satellites have also vastly increased the reach of television broadcasts and made it so difficult for governments to interdict suspect programming that many of them have stopped trying. CNN is now carried to one-third of the earth’s surface by Soviet-built and controlled satellite. It was available, relatively freely, in the Soviet bloc even before the revolutions of 1989.
In fact, incoming Western broadcasts reassured the dissidents in Eastern Europe that the world was following their struggles and helped them focus and amplify their message. Even state-controlled news broadcasts, in an attempt to retain their credibility and their audience, became steadily more candid. All these factors were crucial to the events of 1989. As Timothy Garton Ash, a prominent English journalist who recorded the Eastern European revolutions of the 1980s, has written: “Both externally and internally, the crucial medium [of the revolution] was television. In Europe at the end of the twentieth century all revolutions are telerevolutions.”
Despite the over-the-air broadcasts, the Ministry of Truth’s toughest competitor in the global culture market may be the VCR. These machines and the tapes that play in them have been licensed, restricted, regulated, taxed, censored and even banned by so many countries so vigorously that the campaign against them makes the history of print censorship seem like an ACLU (American Civil Liberties Union) workshop.
Page 50
Nevertheless, in almost every country in the world, including the Soviet Union and the Islamic republics, people have easy access to machines and tapes and can watch almost whatever they choose. Vigorous competition from VCRs is clearly weakening state control of broadcast television. Western movies or TV series get better audience share than endless speeches from the leader or hygienic dramas. In the early 1980s, East Germany began to show Western films so as to compete with both VCRs and West German TV. In Tanzania, which has long suffered under a particularly draconian form of socialism administered by Julius Nyerere, television was banned altogether for years, though people did tune in to foreign broadcasts on illegal sets. When VCRs came on the scene, illegally, they proved too popular for the government to control. Within a few years the government relented, lifting the ban on VCRs and permitting people to receive foreign broadcasts on their TVs.
These machines can also have more direct and explosive political effects. Within days of the 1983 murder of Benigno Aquino, the long-outlawed and exiled political rival of Ferdinand Marcos, the Philippines were flooded with smuggled videotapes of the assassination at Manila International Airport. At least one of the original tapes was smuggled in camouflaged as a pornographic film. Philippine TV and press coverage of the assassination had omitted video footage implicating Filipino security forces in the murder. The smuggled tapes carried that footage as well as investigative reportage from news organizations around the world linking the Marcos government to the murder. The tapes did much to arouse the Filipino middle class, until then fairly complacent, against the Marcos regime, demonstrating that apparent control of the nation’s broadcast system no long protects governments from the power of the video image.
Once a nation is linked to the network, it is very difficult for its rulers to control how the network is used. Stories of electronic surveillance in the now dismantled Soviet bloc are common enough. But in reality the Soviet government suppressed the flow of information not by tapping everyone’s phones but by keeping most people from having them. The Soviet phone system is dismal. Even in the cities only 23 percent of Soviet homes had telephones in 1985, in rural areas the figure was 7 percent. Even many state-operated facilities such as collective farms and rural hospitals had not a single phone. It can take hours or days to make a domestic long distance call; international circuits are scarce, expensive, and restricted, with only fifty lines to the United States as late as 1987.
There is no greater proof of the tremendous economic importance of plugging into the global network — and of building an adequate version thereof at home — than the risks the Russians now seem willing to take to rectify this situation, thereby surrendering what has been a linchpin of Soviet power for three generations. According to official figures, Russian telecom expenditures are increasing by double-digit percentages. The government has established a goal of having 90 million phones, or one for every three people in the nation, by the end of this century. In part this growth is required by the decision to move in the direction of the market economy. As centralized planning is replaced with networks of market relationships, factories, suppliers, distributors, and retailers, and their computers will have to be able to talk to each other.
When everyone in the nation, at least potentially, can join in a single national conversation, there are only two ways in which a government can maintain its power: It can allow its policies to be guided by that national conversation and so keep the confidence not only of “the people” but also of the bureaucrats and the army. But a government that consents to be so guided has become in some sense, however attenuated, democratic and is likely to keep moving in that direction.
Page 52
The other way to keep power is to revert to a level of repression that even totalitarian regimes find inconvenient, that in an age of instant information brings world opprobrium, and that over time will guarantee economic, technical, and — finally — military decline.
The control of information is the bedrock of both totalitarian regimes. The Soviets for decades devoted enormous resources to control radio and television, printing presses, photostat machines, and even mimeograph machines. Certainly some information — political ideas, news about life outside the Iron Curtain, et cetera — always circulated within the USSR. But neither the volume of the information nor the freedom of its circulation was great enough to support any coherent resistance — even peaceful resistance within the Party — to Communist dogma. As a Russian émigré friend once strikingly told me: “It is quite possible for an entire country to know it is being lied to and yet not have any clear or useful idea of what the truth might be.”
Now it is much more difficult to sustain the lie. That is the key to the events of 1989. Though Communist ideology had long lost its moral and intellectual power, as late as the 1980s people were required to pay public obeisance to it, with the result that nearly everyone was leading a double life, saying one thing in public and another in private. However the people of Eastern Europe might have despised the public lie and their own complicity in it, that lie still blocked a candid national conversation, “the public articulation of shared aspirations and common truths,” as Garton Ash puts it. That is why public witness to the truth was so critical to the revolution, why words defeated tanks: The implications of the global conversation are about the same as the implications of a village conversation, which is to say they are enormous. In a village there is if not exactly a free and efficient marketplace of ideas, then a rough-and-ready sorting of ideas, customs, and practices over time. Certainly a village will quickly share news of any advantageous innovation; and if anyone gets a raise or a favorable adjustment of his rights, everyone similarly situated will soon be pressing for the same. And why not? These people are just like you and me, the villagers say. I can see them and hear them every day. Why should I not have what they have?
The global conversation prompts people to ask the same question on a global scale. In the past the educated elites could read about democracy or capitalist prosperity. But hearing or reading of such things is not at all like having them happen in your village, happen to people you can see and hear, people just a few streets or broadcast frequencies away. A global village will have global customs. In a global village, to deny people human rights or democratic freedoms is not to deny them an abstraction they have never experienced but the established customs of the village. It hardly matters that only a minority of the world’s people enjoy such freedoms or the prosperity that goes with them. Once people are convinced that these things are possible in the village, an enormous burden of proof falls on those who would deny them.
Though the global conversation generally advances both the world economy and civil and democratic rights, all will not participate equally. Vast regions of the earth, mostly within the Third World, have been cut off from the information economy not only by political repression but also by lack of the cultural and political infrastructure of a modern society.
Page 54
Building these skills and structures is no easy task, but no more so than the transformation from an agrarian to an industrial society.
No one has to tell people in the favelas of Latin America or the huts of Africa that their authoritarian “command and control” economies have failed to give them even the hope of escaping from grinding poverty. The TV antennas that sprout from even the poorest settlement capture images from the global network of another way of life, one that promises to mitigate but not eliminate disparities of wealth and power. These people are ill equipped to participate in the miraculously powerful engine of wealth creation that is the information economy. Those who are without the education to participate in the knowledge society are not limited to the Third World. In the United States only one-fourth of the work force under forty have finished college, with another quarter having technical training. The half of the population that is not equipped to join the information society can nevertheless find jobs produced by the economy. Peter Drucker has pointed out:
There is thus a real need to make non-knowledge jobs, many often requiring little skill, as productive and as self-respecting as possible. What is needed, above all, is to apply knowledge to such jobs as cleaning floors, making beds, or helping old, incapacitated people take care of themselves.
The information economy thus poses social and economic problems for both the developed and developing nations at least equal to those faced in the last century.
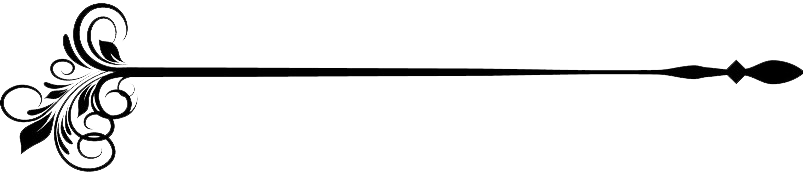
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Four
The Information Standard
How can it be that institutions that serve the common welfare and are extremely significant for its development come into being without a directed toward establishing them?
Carl Menger
ONE OF THE OLDEST ACTIVITIES ON THIS EARTH IS THE trade or barter of goods and services that one person owns for the goods or services that someone else produces. The voluntary exchange of goods and services, which benefits both parties, is the basis of profit and of wealth, of the easing of want and pain. All societies engage in this exchange on some level. Societies that arrange this exchange of value most efficiently, easing the costs of transactions and simplifying the long-term storage of value, have prospered more than those that impede such exchange.
In ancient times, as the known world became larger and more complicated, people searched for ways to settle accounts with something of value other than the goods involved. The invention of money, in all of its various forms, gave a huge impetus to the volume of trade and for the first time made capital portable. No one knows when money was first used as a store of value and unit of account, although the Code of Hammurabi, written some seventeen hundred years before Christ was born, mentions that silver was used for these purposes. Before then, a man’s wealth was expressed by the amount of land or livestock he owned, and you literally couldn’t move the farm.
page 56
The transforming power of money and the markets through which it is saved, borrowed, bought, and exchanged for other currencies can hardly be exaggerated. Money and money markets create commerce and enhance the means of production by allowing action at a distance not only of space but time. They replace the accidental order of geography with an increasingly rational network of specialized efforts, varied resources, and synergistic interests. Of course, the control of such powerful tools has always seemed essential to a sovereign. From the earliest times, governments have wished to monopolize this powerful medium and mandate its value in the markets in which it is traded. The control of currency has always given a government great leverage over the most crucial material endeavors of its citizens. The regulation of money markets is the regulation of a society’s resources in their most convenient and fungible form.
A traditional aspect of sovereignty has been the power to issue currency and to control its value. In Sparta the government forbade citizens any medium of exchange other than heavy bars of iron of relatively little worth. The sons of Lycurgus correctly surmised that with such an inconvenient currency, complex commerce would be nearly impossible. The citizenry, free from the temptations of commerce, would stick to the manly art of war.
The more usual temptation, however, has been for governments to make the currency lighter, not heavier. Clipping coins so as to make them worth less than face value is an ancient tradition. And when governments learned the wonders that could be worked by printing money, a whole new era opened up. Since paper money has no intrinsic value, only scarcity value, it was both easier (or so it seemed) and more imperative for governments to control its value.
page 57
China was the first nation to issue paper currency, in the eleventh century, but soon had to abandon the practice, as its currency was nowhere acceptable.
Since that time, almost every sovereign in the world has experimented with fiat money, very often with disastrous effects. And despite a record of continually eroding value of all the world’s currency, the right to issue and control the value of money is one of the most cherished sovereign rights and onerous political duties.
The Nobel laureate, F.A. Hayek, has pointed out that:
government’s exclusive right to issue and regulate money has certainly not helped to give us a better money than we would otherwise have had, and probably a very much worse one, it has of course become a chief instrument for prevailing governmental policies and profoundly assisted the general growth of governmental power. Much of contemporary politics is based on the assumption that government has the power to create and make people accept any amount of additional money it wishes. Governments will for this reason strongly defend their traditional rights.
Until recently, what we call money, whether a piece of paper, a bookkeeping entry, or a physical object, had been linked to a physical commodity that put some limit on the sovereign’s ability to inflate the currency. The nature of that commodity has varied with the interests of the people using it. The early American colonists used tobacco money; the American Indians favored the cowrie shells, or wampum; and of course the more familiar copper, silver, and gold in the form of coins circulated in many parts of the world. The link between commodities and money became slowly attenuated over a long period of time. On March 6, 1933, a decisive event occurred that put the world on the road to fiat money. President Franklin D. Roosevelt issued a proclamation prohibiting American citizens from holding gold. The link was further severed on June 5, 1933, when, by a joint resolution of the U.S. Congress,
page 58
the gold clause was repudiated in all private and government contracts. While various other acts were taken to weaken the tie to gold, the final blow was administered on August 15, 1971, when President Richard Nixon terminated the convertibility of the dollar into gold and the era of floating exchange rates began. Two years later, the International Monetary Fund (IMF) recognized reality and endorsed floating exchange rates. The world since that time has been operating with a monetary system for which there is no historical precedent in that no major currency in the world is currently tied to a physical commodity. The old discipline of physical commodities has now been replaced by a new kind of commodity: information.
In today’s world, the value of our currency is determined by the price that the market will pay for an American dollar in exchange for yen, marks, or pounds. Whatever the price, it is almost constantly being condemned by someone somewhere as too high and by someone somewhere else as too low. Few governments are entirely satisfied with the value the market places on their currency. Someone is always demanding that government do something to push the value of its currency up or down, depending on how ones interests are affected. The volume of the clamor, as is appropriate in a democracy, is in direct ratio to the economic pain being inflicted. It is in the nature of politics to find a villain on whom to pin the blame.
Bankers are often selected for the role of scapegoat. I have been summoned by one Congress to explain why the big banks drove down the value of the dollar — described at the time as unpatriotic — and have lived long enough to be summoned by another Congress to explain why the banks keep the dollar so high that American manufacturers can not compete abroad. In today’s world, bankers are unable to do either.
There are limits to all power. The power to control the price others will pay in their currency to obtain dollars was never an exception to this rule. But today the limits on that
page 59
power are more visible than ever before. Sovereign control over the value and trade of money has been irrevocably compromised and continues, gradually, to erode. That is not to say that governments can no longer influence, for better or for worse, the value of their currencies. They can and do, but their ability to readily manipulate that value in world markets is declining. Increasingly, currency values will be experienced less as a power and privilege of sovereignty than as a discipline on the economic policies of imprudent sovereigns.
This new discipline is being administered by a completely new system of international finance. Unlike all prior arrangements, this new system was not built by politicians, economists, central bankers or finance ministers. No high-level international conference produced a master plan. The new system was built by technology.
The new world financial system is partly the accidental by-product of communication satellites and engineers learning how to use the electromagnetic spectrum up to 300 gigahertz. Just as Edison failed to foresee that his phonograph would have any commercial value, the men and women who tied the world together with telecommunications did not fully realize they were building the infrastructure of a global marketplace. Yet the money traders of the world understood immediately and drove their trades over the new global infrastructure.
The convergence of computers and telecommunications has created a new international monetary system and even a new monetary standard by which the value of currencies is determined not by the arcane manipulations of central banks, whose total reserves are now dwarfed by a single day’s trading on the world currency markets, but by a myriad of facts which are now instantaneously available.
We sit at home and watch a live broadcast of riots in a country on the other side of the earth, and a currency falls, in minutes. We hear by satellite that a leadership crisis has been resolved, and a currency rises. Ten minutes after the
page 60
news of the disaster at Chernobyl was received, market data showed that stocks of agricultural companies began to move up in all world markets. For the first time in history, countless investors, merchants and ordinary citizens can know almost instantly of breaking events all over the earth. And depending on how they interpret these events, their desire to hold more or less of a given currency will be inescapably translated into a rise or fall in its exchange value.
The natural first response to this claim is, “it has ever been so.” The pressure of events has always been a major factor in determining the value of currencies. But the speed and volume of this new global market makes it something different in kind and not just in degree. Cherished political, regulatory, and economic levers routinely used by sovereigns in the past are losing some of their power because the new Information Standard is not subject to effective political tinkering. It used to be that political and economic follies played to a local audience and their results could be in part contained. This is not longer true; the global market makes and publishes judgments about each currency in the world every minute and every hour of the day. The forces are so powerful that government intervention can only result in expensive failure over time.
It was not always so. After World War II, the foreign exchange market in New York was conducted by a handful of traders in the big banks, a few exchange brokers, and a rudimentary telephone system. The telex was the principle means of communications overseas where trading rooms were beginning to reopen. The volume in the currency market in the late 1940s and 1950s in New York probably did not exceed $750 million a day.
The volume of trading was small partly because complex foreign exchange controls existed in most countries in the aftermath of the war. It is the nature of government never to give up controls once established, so the controls were relaxed very slowly in most cases. One finance minister in Europe
page 61
understood the stultifying nature of controls and started the train of events which has led to the present free market. Acting on a Sunday afternoon in 1948, Ludwig Erhard of Germany abolished price controls and set the German mark free. He acted on a Sunday because the occupation offices of the United States, the United Kingdom, and France were closed and so were unable to countermand the order. This action was the first of a long chain of events to abolish foreign exchange controls which made the present huge market possible.
Under the old Bretton Woods agreements a relatively small club of bankers and politicians believed it could significantly control the value of a given currency. That illusion can no longer be sustained.
When the volume of trading in anything is small, prices can be influenced dramatically by placing relatively large buy or sell orders. As the size of a market grows, the amount of orders that have to be placed to move the price either up or down becomes correspondingly larger. In the relatively small postwar money markets, central banks had enough resources to place orders large enough to influence the price of a currency. Today, with almost $2 trillion dollars changing hands in New York alone, there is not enough money in the reserves of the world’s central banks to significantly influence exchange rates on more than a momentary basis.
The new world financial market is not a geographical location to be found on a map but, rather, more than two hundred thousand electronic monitors in trading rooms all over the world that are linked together. With the new technology no one is in control. Rather, everyone is in control through collective valuations.
Technology has made us a “global” community in the literal sense of the word. Whether we are ready or not, mankind now has a completely integrated, international financial and informational marketplace capable of moving money and ideas to any place on this planet in minutes. Capital will go where it is wanted and stay where it is well treated. It will flee from manipulation or onerous regulation of its value or use, and no government power can restrain it for long.
page 62
The Eurocurrency markets are a perfect example. No one designed them, no one authorized them, and no one controls them. They were fathered by interest-rate controls, raised by technology, and today they are refugees, if you will, from national attempts to allocate credit and capital for reasons that have little or nothing to do with finance and economics. Though they got their start some years before the global telecom network became the essential medium of a global financial market, their power, size, and independence were greatly augmented by that network. The two in fact matured together, demonstrating along the way that information technology makes money far more difficult to regulate than ever before.
It was in the late 1950s, roughly 1957, that the world noticed that a new money market denominated in dollars, had begun to grow in Europe. As this market was burgeoning, government and private experts were devising schemes to improve international liquidity through various government devices. As late as 1961, Dr. Edward M. Bernstein testified before a subcommittee of the Joint Economic Committee of Congress that “while international monetary reserves are adequate at this time, it is unlikely that the growth of reserves in the future will match the greater needs of the world economy.”) Other experts, ranging from David Rockefeller to A. Maxwell Stamp, joined in expressing concern about future world liquidity. While these experts were testifying in Congress about the coming liquidity squeeze, the greatest marshaler of liquidity in history was up and functioning. It is a strange anomaly of history that the Eurodollar market was virtually overlooked at the time.
One of the first studies of the Eurodollar market was made by Norris O. Johnson, an economist with First National City Bank (now Citibank), in about 1964. He told how irritating this new market was to some European financial experts who
page 63
were accustomed to more traditional national markets. “Annoyed by imprecise usages of an undefined term, a distinguished European banker two years ago expressed the wish that he would not have to hear the word Eurodollar, ‘any more, anywhere, and in any sense whatsoever.’ He quoted a passage from Goethe: ‘Where clear notions are lacking, a word is readily invented.'” Mr. Johnson went on to say: “The banker’s wish has not been fulfilled. To paraphrase Goethe: Where clear needs are present, a practice is readily invented.” The study concluded with the words: “The important thing to remember about the Euromarkets is that these developments are responses to urgent economic needs. Maybe the word Eurodollar was an inappropriate coinage. But, by any name, the money is needed.”
How did this all come about? What were the “urgent economic needs”? In many respects the Euromarket is a monument to U.S. bank regulation. In the 1930s, the U.S. Congress, acting on the mistaken belief that high short-term interest rates were partly responsible for the 1929 crash and the ensuing depression, put legal ceilings on the rate of interest banks could pay to consumers, and stopped altogether the payment of interest by banks on deposits made by corporations. So long as interest rates remained low, corporation treasurers and consumers were more or less content to accept the system. But as interest rates began to rise, individuals and corporations looked around for a way to earn an acceptable return on idle balances.
European countries fortunately did not adopt this form of price control. On the other side of the Atlantic, markets for interest rates were generally much freer, and since capital seeks the best blend of safety and return, money, including dollars, moved to Europe. Some of this money came from behind the Iron Curtain. In the mid-1950s the cold war made Communist governments nervous about depositing their dollar reserves directly in banks in the United States for fear their funds would be seized by the U.S. government.
page 64
To reduce the perceived political risk the Russians deposited their dollars in London, mostly with British banks and with Russian-controlled banks operating in Europe.
Soon, the Soviets, in good non-communist fashion, began to shop around for a higher yield on their funds. Their search took them to Italy where it was generally believed that a banking cartel operated. Perceiving the opportunity to capitalize on this, the Soviets went to the Italian banks with an offer to place money with them if they received an interest rate higher than America’s domestic law would permit, but lower than the Italian banks were forced to pay for local deposits. It was a situation in which both the creditor and the borrower won. By initiating these transactions, the Soviets were in fact among the fathers of the Euromarket.
The market got a major boost in 1957 when the British government imposed controls on sterling credit in an effort to support the pound but imposed no such restrictions on dollar or European currency transactions. A futile bout with capital controls in the United States starting in 1963 gave fresh impetus to the Euromarket. As this huge market, denominated in dollars, grew in London, Mr. Paul Volcker, then undersecretary of the Treasury, went to London to argue for the imposition of reserve requirements on Eurodollar deposits, as this was clearly an unregulated market. He was politely but firmly turned down. The British knew a good thing when they saw it.
During this period the famous German banker Hermann Abs was of the opinion that the Euromarket was a temporary phenomenon and would soon go away. He kept the Deutsche Bank out of the market. In the face of such a judgment, Citibank formed a task force of four or five people to report on whether the emerging Euromarket was a transitory phenomenon or a permanent source of capital. The task force’s study convinced Citibank management that the market was real, and Citibank began to use the market through its London office to attract Eurodollars that could be advanced to its New York office to fund its domestic loan portfolio. Thus, New York banks began routinely financing projects in America with dollars deposited in European banks.
page 65
From this small beginning has grown a market that is truly something new under the sun. It is now a vital part of the international financial structure of the world, vastly increased in size and speed by the increasing facility of electronic markets and the increasingly global character of world commerce.
The Eurocurrency markets are part of a global financial network that moves capital to where it is needed and appreciates faster and more efficiently than ever before. But their very existence is a symbol of the growing futility of government attempts to regulate capital. These markets grew, as we have seen, out of a failed attempt to control capital in ways it can no longer be controlled.
It used to be that the main function of currency trading was to facilitate international trade in goods. But today the ownership of capital denominated in dollars is so huge and turning over at such speed that it totally overwhelms the money used to pay for world movements of trade. Capital transactions are now probably forty or fifty times larger than trade flows. Since this is so, the old measures of currency value that we still use, which were based on trade flows, no longer have the same meaning they once had. To further complicate matters, the usefulness of trade-weighted averages, which show a 20 percent or 30 percent decline in the dollar’s value since early 1985, is reduced by the fact that America conducts about 20 percent of its bilateral trade with Latin American and Asian countries whose currencies are not usually included in this measure.
The postwar boom of the industrialized economies was based on the enlightened proposition that goods should be permitted to cross national boundaries with as few restrictions as possible. This concept was institutionalized in such international bodies as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as well as in many national groupings.
page 66
But now the global financial market extends the same freedom to money and to information about money without the benefit of government intervention.
There are, however, those who do not find this an altogether desirable development and complain that the very efficiency of the system undermines or complicates national monetary policy in particular countries. Behind that argument lies a complaint by some governments that the existence of a truly free market disciplines them when they engage in over expansionary policies.
They are right, of course, to complain. Not only are governments losing control over money, but this newly free money in its own way is asserting its control over them, disciplining irresponsible policies and taking away free lunches everywhere. The old discipline of the gold standard has been replaced, in fact, by the new discipline of the Information Standard, more swift and more draconian than the old.
The Bretton Woods arrangement of 1944 sought to maintain fixed exchange rates, and although the conventional wisdom remembers history this way, in fact, literally hundreds of currency revaluations during that period. When countries attempted to maintain an unrealistic rate, they had to use their dollar or gold reserves to buy their own currency to prop up the rate. This action almost always failed, and the country wound up with depleted reserves and an unwelcome exchange rate. The loss of reserves was one of the biggest incentives governments had to announce more realistic exchange rates. Though countries often sought to insulate themselves from the judgment of the market by instituting exchange controls, these control always failed. Economic fundamentals always reassert themselves over time, more so now, in the new electronic marketplace for money, than ever before.
page 67
In the seventeenth century the Amsterdam bankers made themselves unpopular in the royal chambers by weighing coins and announcing their true metallic value. Instead of weighing coins and publishing their intrinsic worth, the global market weighs the fiscal and monetary policies of each government that issues currency and places a value on it that is instantly seen by traders in Hong Kong, London, Zurich, and New York. Even major countries that announce inadequate monetary or fiscal policies have seen their foreign exchange reserves vanish in days. There is no longer enough money in the central banks of the world to hold an unrealistic exchange rate in the face of bad economic policies. Minutes after any official announcement, the Reuters screens light up in the trading rooms of the world. Scores of traders make their judgments about the effects of the new policies on the value of a currency, and then they buy or sell. These buy and sell orders drive the price up or down in minutes. The entire process does not take much more time than it took the Dutch bankers to adjust their scales in Amsterdam.
In the international financial markets today, a vote on the soundness of each country’s fiscal and monetary policies, in comparison with those of every other country in the world, is held in the trading rooms of the world every minute of every day. Every kind of information moves across the electronic infrastructure that binds the world together. The latest political joke makes its way from trading room to trading room around the world in minutes. The newest figures on the GNP (gross national product), the money supply, or the words of a political leader all enter the data bases that move markets. This continuing direct plebiscite on the value of currencies and commodities proceeds by methods that are growing more sophisticated every day.
In America, we have progressed to the point where politicians no longer blame the electorate if they lose an election. Blaming the global market for our political or economic mistakes as reflected in the value of the dollar is equally useless, although some economists and politicians still do.
page 68
Just as politicians often manage to trick the electorate for a short period but in the end are found out and removed from office, so central bankers, finance ministers and parliaments sometimes imagine that their words can affect the price for currencies. But over time the market will not be fooled: Fundamentals will always prevail. The politically astute officials are the ones who see where fundamentals are driving the market and then jawbone it in that direction; hence, the phenomenon of cockcrow followed by sunrise. The best example of this was the “action” taken by a meeting of finance ministers held in the Plaza Hotel on September 22, 1985. The dollar, they opined, was overvalued. In order to rectify the situation, the ministers announces they had agreed on a course of action. The reality was that since everyone knew the dollar was overvalued, the ministers were only getting out of the way of a huge avalanche of selling that followed the announcement.
This new international monetary system is burdened with a vocabulary that was not designed to describe the modern world. The words we use do not really tell us what is happening, and so confusion abounds. It is not unlike trying to explain modern computer systems by using terms invented for describing how a steam engine works.
page 69
In the case of computers, a whole new language was invented to describe both the hardware and software; unfortunately, no such vocabulary has been developed to help us understand the new international financial system. The vocabulary we use to describe the international marketplace is largely derived from a time when merchandise trade dominated our thinking.
We talk, for example, of capital inflows or outflows, just as if money really entered our country in the way goods are unloaded from a ship. This is not the case with so-called capital inflows — no one brings dollars into America, or takes them out for that matter. There is no capital inflow or outflow in a merchandise trade sense.
What happens is quite different. The ownership of dollars, which are already here, changes hands. If a German wants to own some dollars, he or she must buy them from someone who owns them and is willing to part with them in exchange for German marks. If the owner who sells the dollars resides in America and the buyer resides in Germany, we count the transaction as a capital inflow even though the total supply of dollars in the United States is unchanged and indeed cannot be changed except by the Federal Reserve.
All the dollars in the world — except currency — are on deposit in a bank in America, because that is the only place anyone can spend a dollar. One can, of course, give a shopkeeper abroad a dollar check in payment of merchandise, but that check will be exchanged for an equivalent amount of the local currency in which business is conducted in that country. The foreign bank that bought the dollar check for local currency will send it to New York for collection and credit to its account. Eurodollars, which are dollars deposited with a bank in London, (which in turn deposits them in a bank in New York), are traded in London hundreds of times a day in huge volumes, but each transaction is effected and recorded on the books of a New York bank. After all the Eurodollar transactions have cleared, the ownership of the dollars have changed. But the number of dollars on deposit in New York remains the same in aggregate, as each debit is offset by a credit. The dollars cannot leave the system; it is a closed shop.
page 70
Doomsayers love to conjure up the specter of foreigners “pulling their dollars out of America.” But we all learned in the OPEC (Organization of Oil Exporting Countries) oil crisis that, except for small amounts of currency, dollars cannot be taken out of the United States. Only the ownership of existing dollars in a bank located in America changes hands. The threat that the Arabs, the Japanese, or others would pull their dollars out of America was always an empty one and the Arabs were well aware that it was impossible.
Even though Americans have accepted the ballot box as the arbiter of who holds office, this new global vote on the nation’s fiscal and monetary policies is profoundly disturbing to many. Accepting the judgment of thousands of traders who translate politicians’ actions into new values for currencies is harder to accept because it developed so fast and is new and unfamiliar. Nevertheless, it is about as useful to cuss out the thermometer for recording a heat wave as it is to rail against the values the global market puts on a nation’s currency. There is no escaping the system.
In the past, nations that did not like the gold standard, the gold exchange standard, the Bretton Woods system, or whatever the dominant international financial system of the day could opt out. A finance minister would call a press conference and explain that the current international arrangements were unsatisfactory and his nation would no longer play by the rules. This, as we have seen, is just how the gold exchange standard and later the Bretton Woods standard were dissolved.
Today there is no way for any nation to opt out of the Information Standard. No matter what formal decisions a government makes, the two hundred thousand screens in the trading rooms will continue to light up, the news will continue to march across the tube, the traders will continue to make judgments, and other traders all over the world will know instantly what value the market has placed on a currency.
Japan, which engineered a remarkable economic recovery after the war, was lauded for the skill of its policymakers in controlling markets in difficult times. As the market became freer and truly global, Japan, too, became subject to the Information Standard. In March 1990, the New York Times reported the erosion of sovereign power:
Hard earned over forty years, Japan’s reputation has been a source of immense confidence here, even arrogance.
Page 71
But in the last three months, that reputation has begun to unravel. For the first time, market forces are looming larger than the powers of Government bureaucrats.
Persistent turmoil has racked the financial markets this year, sending stock prices down by more than 20 percent, the yen down more than 5 percent and interest rates up sharply, despite numerous Government attempts to restore order. As a result, Japan’s elite bureaucrats are watching their credibility erode almost daily.
The rapid dissemination of information has always changed societies and their governments. In the case of the Information Standard, governments have lost even more than the power to freely manipulate their currencies, or the ability to protect their currencies from their own economic folly. The new system also is steadily driving sovereign nations towards unprecedented international cooperation and coordination of monetary and fiscal policies.
The slow building and knitting together of the European Economic Community (EEC) is a case in point. Today we have a kind of mini-Bretton Woods agreement among the countries in the community called the European Monetary System, or EMS. It is not a fixed-rate system, as there has been a realignment of currencies each year, but it is anchored by the German deutsche mark, just as the old system was based on the dollar. The system itself forces all participating governments to weigh heavily the actions of their neighbors in forming their own policy. It is almost the reverse of the old mercantilism. Money is only one of the problems of living in an integrated world. The vast bureaucracy in Brussels is trying to “harmonize” everything from the kind of plug to use on an electric razor to what frequencies can be used in satellite transmission. All of these efforts and thousands more, are being forced by integration of the market.
Page 72
Each nation will always pursue what it perceives to be its own national interest, but it cannot do so in a vacuum. If one government in the market approves a new drug to alleviate suffering, and another does not because of official doubts about it, citizens will cross borders to be treated. This is but one example of many thousands that will occur and indeed are now happening that will move governments toward adopting common standards.
The global network has become such an essential part of the future of the world that it is worthy of everyone’s best efforts to see that it remains as efficient, as cost-effective, and as free as possible.
The legitimate competing concerns of society make this no easy task, but it is one that is worthy of our best efforts because the global marketplace has become such an essential part of the future of the world. The ability to move capital to where it is needed and wanted is fundamental to the continuous effort of mankind to live a better life. In today’s world, information about this market and the transfers themselves travel on our networks at the speed of light — which Einstein tells us is as fast as it is possible to go. Keeping that data moving with speed and efficiency, while balancing competing interests, is our particular challenge – and the greatest contribution we can make to the world that emerges from the information explosion.
As the relative weight of the world economy outside any given sovereign state increases, the need for international cooperation also increases. In June 1989, Federal Reserve Chairman Alan Greenspan called on other central bankers to cooperate in overseeing international markets. He urged central bankers to work together to supervise multinational payment and clearing systems rather than create a centralized authority. The growing practice of “netting” debits and credits in each country is leading, Mr. Greenspan said, to the “decentralization of the major monetary mechanisms.” and could diminish the supervisory power of central banks. No leader likes to face the erosion of his or her own power.
Page 73
Central bankers are no different in that regard than others, but the world has changed, and central bankers, acting alone in their own country, no longer can control financial events in the way they once could. The huge capital movements that wash across the world, the international arbitrage of interest rates, the global futures market, and above all, the communications ability that permits individuals to move their money away from danger and toward safe haven rob individual central banks of much of their power. The views of the chairman of the Federal Reserve Board are among the first to highlight this new situation, but they will not be the last to decry the erosion of sovereign power. Indeed, the process has just begun.
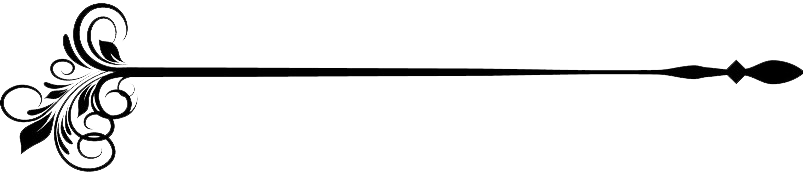
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Five
The End of Trade
No nation was ever ruined by trade.
Benjamin Franklin
THROUGHOUT HISTORY A DISPUTE HAS RAGED ABOUT THE way to achieve economic progress. Thucydides, the great historian of the Peloponnesian Wars, understood clearly the role of trade in the fifth century B.C.:
Without commerce, without freedom of communication either by land or sea, cultivating no more of their territory than the exigencies of life required, (people) could never rise above nomadic life and consequently neither built large cities nor attended to any other form of greatness.
But the concept that trade produces human progress and the lack of it condemns people to mere subsistence has not been universally shared. This ancient animosity toward trade and commerce as a way to increase the wealth of nations dies hard, and until the eighteenth century the free flow of trade was seldom seen as advantageous.
The maps we look at today and the trading relationships that we now take for granted bear little resemblance to those we knew a generation ago.
Page 75
For example, what we now know as Germany consisted only two hundred years ago of over a thousand economic units separated by customs barriers and guild regulations. While the Germans were still living in commercial isolation from one another, the United Kingdom had long been a common market. Martin Wolf has written:
This difference was one of the main reasons why the Industrial Revolution started here, the significance of the internal barriers being shown by the great rapidity with which the German economy caught up, once a custom union (the Zollverein) had been put in place during the nineteenth century.
The United States enjoyed a similar advantage. Shortly after Chief Justice Burger retired, I asked him what he regarded as the most important sections of the U.S. Constitution and he answered immediately, “The first Amendment and the commerce clause.” The latter, he explained, made possible our continental common market, which created the circumstances for America’s economic growth.
For hundreds of years the world has been torn between the extremes of economic nationalism and the concept of worldwide free trade, a debate that raises the most serious questions concerning the state’s power and wealth, to say nothing of its fundamental purpose. The case for free markets, according to F. A. Hayek, is that
the market is the only known method of providing information enabling individuals to judge comparative advantages of different uses of resources of which they have no immediate knowledge and through whose use, whether they so intend or not, they serve the needs of distant unknown individuals. This dispersed knowledge is dispersed, and cannot possible be gathered together and conveyed to an authority charged with the task of deliberately creating order.
The mercantile system of the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries, on the contrary, was a political endeavor to maintain and extend the power of government not only abroad but at home by attempting to regulate all kinds of production — a concept that bordered on absurdity when Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV’s controller general, decreed even the size of a handkerchief and the length of a fish that could come to market. According to Colbert: “All purchases must be made in France, rather than in foreign countries, even if the goods should be a little poorer and a little more expensive, because if the money does not go out to the realm, the advantage to the state is double.” Although mercantilism, like most political concepts, was variously expressed by many people, the central point of mercantilism was a belief that “the greatness of a state is measured entirely by the quantity of silver it possesses.” The purpose of the state, in other words, was primarily to enrich the royal treasury, not to enhance commerce or encourage the division of labor.
To further this goal, the object of the mercantilistic game was to export goods abroad and import precious metals in payment. The gold and silver thus acquired, so the argument ran, paid for the armies and navies that fought and won the wars that increased the territory and power of the state. Soldiers and sailors at that time put little faith in the promises of kings and demanded gold in payment for their services and later only reluctantly accepted silver. So gold was necessary to maintain an army, and selling goods abroad for bullion was one way to produce it.
In 1776, Adam Smith, as we have seen, challenged the principles of the mercantilistic system, arguing for freer trade and laissez-faire. Smith also argued that the wealth of a country was directly connected to “the increase of the number of its inhabitants” rather than the size of its gold reserves.
Page 77
Smith saw that the size of the market was central to his concept of the division of labor, although in his wildest dreams he could never have contemplated today’s global market.As usual, he put it succinctly: “As it is the power of exchanging that gives occasion to the division of labor, so the extent of this division must always be limited by the extent of that power or, in other words, by the extent of the market.”
The power of sovereign states to control the commerce between its citizens with citizens of other nations has been a jealously guarded right as long as nation-states have existed. From before the time of Adam Smith, national governments understood that to control a nation’s economy, to advance one particular goal or frustrate that one, to help this group at the expense of another, to reward friends and punish enemies, states must control international trade. They must, that is, assert the power if the state over that of their citizens to decide which deals get done, which foreign companies are tolerated, and which national ones are promoted.
Today this traditional sovereign power is eroding almost as rapidly as the power of individual states to control the short-term fluctuations in the value of their own currencies. It is eroding largely because the classic concept of international trade is becoming obsolete. The traditional multinational economy in which “products” are exported is being replaced by a truly global one in which value is added in several countries. The traditional business of import and export among nations is being replaced by a transnational system of product development, design, production, and marketing that takes less and less notice of national borders and which national governments can disrupt only at the risk of economic chaos far greater than the protectionist disasters of the past. The world has been moving, fitfully and with many reversals, toward a global economy almost from the beginning of time. But this process has accelerated enormously in the past few decades largely because the growing global information network, global financial markets, and improvements in transportation have greatly eased the difficulties of international trade and production.
Page 78
This information infrastructure has also encouraged consumers and businesses worldwide to demand the same sorts of products at the best prices and quality, requirements that can be met only by access to a global market. We have not yet arrived at the point where government policy has shifted from protecting its natural-resources base from foreign capital and has moved toward policies that assure their citizens access to the best products at the lowest prices. But consumers are already demanding such a shift in many countries of the world because they are learning more and more about the world’s goods as displayed on television.
This acceleration toward a global economy has produced a fundamental change in the world’s work. The driving force behind that change is information technology and in particular the relative importance of intellectual capital in relation to physical capital. Intellectual capital — human intelligence — is now the dominant factor of production, and the world’s most fundamentally important market is the market for intellectual capital. The most mobile of all forms of capital will be increasingly intolerant of nationalist restrictions because it is inherently global and almost immune from nationalist restrictions. Far more than any other form of capital, intellectual capital will go where it is wanted, stay where it is well treated, and multiply where it is allowed to earn the greatest return. Nations that respect the freedom of intellectual capital and accommodate it accordingly will prosper in the global economy. Those that imagine that this most powerful form of capital can be enslaved or entailed will wither.
For roughly the entire history of the industrial era annual growth in international trade has outstripped yearly GNP (gross national product) growth for the advanced economies, the only exception being the years between 1914 and 1950 when two world wars and an outbreak of protectionism interrupted the peaceful growth of world prosperity. In the past three decades, however, world trade has grown particularly rapidly despite a recent slowdown in the world economy and occasional outbreaks of protectionism — mostly in the form of nontariff barriers, such as national buying policies and import quotas.
Page 79
From 1950 to 1985, while real world GNP tripled, world trade grew sevenfold. America’s merchandise exports more than doubled in the decade ending in 1987, from $120,816 million to $249,570 million.[37] Among the Western industrial powers the percentage of GNP absorbed by foreign trade has almost doubled since 1960. In the United States, which has the world’s largest internal market, foreign trade has, until recently, represented an almost insignificant single-digit percentage of our national efforts. But by the mid-1980s, merchandise imports and exports accounted for over 15 percent of U.S. GDP (gross domestic product). In Europe, with their far smaller internal markets, the figures were even more arresting: By 1986, merchandise trade accounted for more than 20 percent of France’s GNP, more than 40 percent of Great Britain’s and almost 50 percent of West Germany’s. The creation of the European Economic Community (EEC) was therefore a foregone conclusion, and the complete integration of the European nations will increase these numbers even further.
Yet none of these figures count trade in services, the most rapidly growing sector of world trade. The reason for the absence of service figures is partly historical and partly practical. For years, government statisticians used the cash, insurance, and freight (CIF) method in value the goods sold in international trade, thus incorporating these services in the value of merchandise trade. Only a few years ago, the model economists built of the world economy did not have to account for services, but now such models are unacceptable; shipping companies, airlines, travel companies, financial institutions, consulting firms, accountants, and lawyers are all engaged in this kind of service trade.
Page 80
The importance of trade in services was recognized on September 20, 1986, when trade ministers from all over the world, meeting in Punta del Este, Uruguay, agreed for the first time to make trade in services a major issue in GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) negotiations. Nor do the trade numbers include the huge movement of money capital that by far exceeds world trade. Many of these transactions can only be effected by buying or selling foreign exchange, so the size of this market had to expand and is now probably about $500 billion per day and growing. While these numbers are tricky in that they may include double counting between institutions, they nevertheless indicate a market of a size, depth, and speed never before seen on earth, one that presents entirely new problems for sovereign states.
It used to be that each sovereign policed and regulated the markets operating in its own country with small regard to what was happening elsewhere. Each country has its own clearance system by which trades are settled, each its own rules of trading, its own margin requirements and trading hours and holidays. Even though markets are now blips on a screen, and not geographic locations, sovereigns try to protect and control that part of the market that functions within its jurisdiction. Yet even this becomes increasingly difficult, for if one sovereign becomes unreasonable in the severity of regulatory demands, the market node in that country withers and is replaced by the node “residing” in more hospitable climes. To be effective, a sovereign must therefore cooperate with other governments in forging international agreements.
This problem was acknowledged officially by the Bank for International Settlements — a kind of a central bank’s bank — in a study released in March 1989, which concluded that “the appropriate division and sharing of supervisory responsibilities will be extremely problematic.”
While creating massive problems for government regulation, the electronic market occasionally solves problems by eliminating geography.
Page 81
The fierce rivalries that have split stock trading among seven regional exchanges in the tiny country of Switzerland prevented the opening of a Swiss futures and options exchange because no city would tolerate its location in any other. In the meantime, the business was going to London and Amsterdam. Saul Hansell tells us: “The solution was to redefine an exchange. The…Swiss Options and Financial Futures Exchange is not in Geneva nor Zurich nor any other city; trading occurs in the dimensionless geography of a computer network.”
The enormous explosion of world trade has not only created a global market, but the worldwide information network has made it possible to carry the division of labor through all stages of production and marketing, with value added in many countries. An item in the showroom with a well-known brand name like IBM may in fact be only a handsome facade hiding parts from all over the world. The popular IBM PS/2 Model 30-286, for example, contains a microprocessor from Malaysia, oscillators from either France or Singapore, disk controller logic array, diskette controller, ROM and video graphics array from Japan, VLSI circuits and video digital-to-analog converter from Korea, and Dram from Singapore, Japan, or Korea — and all this is put together in Florida. To complicate matters further, some components are manufactured overseas, but by a U.S. company.[41] Since there are thousands of products put together in similar ways, the old concept of trading one item for another is obsolete. But the bookkeeping system to record these international transactions has not changed. When measuring systems fail to keep up with technology, they become less and less useful, and through them we understand less and less about the world economy.
The current trade accounting system is totally inadequate to produce any useful numbers for policymakers concerning the following transaction: An American author exports intellectual capital in the form of a manuscript to Taiwan where it is printed and bound into a book. The book is then shipped back to the United States to be sold in bookstores here.
Page 82
The export of the manuscript, which from a physical standpoint is small, barely shows in tallying up U.S. exports but, the finished book at, say, two dollars per copy shows up as part of the value of Taiwan’s exports. The books are sold in this country for thirty dollars by American stores, and royalties accrue to an American author. So far as the balance-of-trade figures are concerned, Taiwan runs a trade surplus with the United States, and we have a trade deficit with Taiwan. Clearly this accounting does not reflect reality, since the lion’s share of the return on this capital is generated in the United States. These trends toward horizontal integration are being driven by the growing awareness that to survive in the global market, everyone has to go back to basics and pursue a form of comparative advantage. In this example, Taiwan did have such an advantage in actually printing and binding books, but the United States had the advantages of creating both the intellectual capital and the marketing strategy.
As the volume of world trade increases, so does the complexity of trade patterns and the number of significant players. Long dominated by the Developed Market Economies, essentially Western Europe, the United States, and Japan, the club of major trading nations is growing quickly.
Since 1965, the developing countries’ share of world manufactured exports has risen from 7.3 to more than 17 percent. Most of this increase is due to such newly industrialized countries (NICs), as Hong Kong, South Korea, Singapore, and Brazil, all of which now rank among the top twenty exporters of manufactured goods, though no developing country ranked among the top thirty as recently as 1965.[42] India, Indonesia, and others are coming on quickly. Several of these countries — Korea is a particularly strong example — have become driving forces in regional development. With growing prosperity and rising wages at home, such companies have begun to move labor-intensive manufacturing jobs to their less developed neighbors, and in turn have helped those lesser developed neighbors become more important markets for NIC manufacturers.
Page 83
Among the developed countries and NICs, the exchange of products has become more egalitarian, making the warp and woof of trade more complex and difficult to unravel. In the first post-World War II decades, the United States thoroughly dominated the sale of high- and mid-technology products; world trade patterns in such products resembled the spokes of a wheel of which the United States was the hub. As recently as the late 1960s, Japanese cars were regarded with amusement, and “made in Japan” (or Hong Kong) were bywords for inferiority. Today all the developed countries and most of the NICs can produce a vast number of products and components that approach state of the art. As a result, trade flows of sophisticated products move from country to country for value-added components, assembly and packaging.
Much of this trade, particularly in information-rich technologies, is carried on within or facilitated by, an increasingly complex network of alliances between companies sharing precious technological and intellectual resources. This sharing of intellectual capital may take the form of jointly developed products, filling in each other’s product lines, supplying each other’s cutting-edge components, or simply availing themselves of the best and the latest in today’s blisteringly fast technological competition. With technology and manufacturing capabilities so widespread, the international sourcing of competitively priced components is no longer a luxury but a necessity from which no country’s businesses can afford to be cut off. As Christopher Bartlett of the Harvard Business School has written, “competitiveness is already beyond the reach of the purely national company.”
The year 1989 marked the tenth anniversary of the world’s largest producer of commercial jet engines, a company that hardly anyone outside the industry has heard of. The company, CFM International, is a joint venture of SNECMA (a French government company) and GE, which is, of course, a private American company.
Page 84
This new entity is managed jointly by a third company called CFMI. The official press release of July 18, 1989, celebrating the anniversary, explained the workings of an enterprise that has produced two thousand jet engines with three thousand more on order.
CFMI has a small staff to act as project manager and as the contractual interface with customers. But CFMI does none of the engineering, manufacturing, marketing, or project support work itself. It buys that work from SNECMA and GE, balancing the work shares so that they reflect the 50/50 ownership of the program. CFMI also splits the sales revenues between the two parents.
This complex but highly efficient structure was constructed to help fulfill the French government’s desire to enlarge its role in the world market for commercial aircraft engines and GE’s desire to sell two of its new aircraft engine designs to Airbus Industries, a European consortium, which was going to build a new 150-passenger airliner. The technology of the engine core, which is built by GE in Cincinnati, Ohio, is not shared with the French partners due to restrictions mandated by the U.S. government. But the French have significant technologies that are likewise hidden from the Americans. While the engine cores come from America, SNECMA builds the low-pressure outer parts of the engine in France. Some engines are assembled in GE’s plant in Evendale, Ohio, and some in SNECMA’s facility in Villaroche, France. The engines are sold all over the world to civilian airlines and also to power more than three hundred military aircraft in six countries.
This very successful international venture is only one example of why it is becoming more and more difficult to unscramble the egg as global manufacturing and marketing alliances are becoming the rule rather than the exception.
Page 85
Nevertheless, protectionism has had its effects: a good deal of trade has been transferred into foreign investment, as companies avoid quotas and other nontariff barriers by assembling or producing final products in the countries in which they mean to sell them. Thus, Honda now builds more cars in America than in Japan. Roughly half of American chemical workers work for foreign-owned companies.) In 1987, some thirteen hundred American and European companies made and sold over $260 billion worth of goods in Japan, accounting for 10.9 percent of Japan’s GNP.[45] But this trend, not all of which is due to protectionism, only strengthens the global economy and make it more difficult for economic nationalists to control or subvert it by substituting products made locally by foreign companies.
This expanding pattern of world trade in goods is largely a function of information technology, for not only has the global telecom network made global enterprise far more practical; products become easier and more profitable to trade as information becomes the dominant source of value added. A few ounces of microchips or a few pounds of VCRs may earn more profit than a ton or steel, though steel itself is made by an information-rich new system that today packs more strength and value per pound than it did a decade ago. The cost of moving high-technology products around the world is now such an insignificant percentage of their selling price that a growing percentage of such products travels air freight. So cross-border business agreements are limited not by cost so much as by the imagination of the participants. For example, one division of the General Electric, Power Systems, has sixteen alliances with sixty-two companies located in nineteen countries. These types of arrangements are becoming typical of all large companies, no matter where their headquarters may be located.
The automobile business is a classic example of alliances covering everything from engineering to production. Chrysler, for example, owns 24 percent of Mitsubishi Motors, which in turn owns part of the South Korean company, Hyundai. Additionally, automobiles bearing the Chrysler logo are made
Page 86
by Mitsubishi, and a fifty-fifty joint venture of the companies in Illinois will be producing cars under both nameplates. Ford owns 25 percent of Mazda, and Mazda makes cars in America for Ford, and Ford makes trucks for Mazda. Each one of these companies owns a piece of Korea’s Kia Motors. Ford and Nissan swap vehicles in Australia, while Ford and Volkswagen are a single company in Latin America that exports trucks to the United States. General Motors owns 41 percent of Isuzu, which is starting a joint venture in America with Subaru, which in turn is partly owned by Nissan. And so it goes. Europe is also full of such alliances, which grow in number and complexity every day. These ventures range from relatively arm’s length relationships, such as licensing and outsourcing, to more formal “alliances,” consortia, joint ventures, and mergers.
During the 1980s, high-technology firms, such as Siemens (FRG), Philips (Benelux), GGE, Bull, and Thomson (France), Olivetti (Italy), AT&T, IBM, Control Data, Fujitsu, Toshiba, and NEC (Japan), each forged numerous foreign alliances; some of them formed dozens. A chart of Siemens’s international cooperative agreements is a genealogist’s delight, including, among others, Ericsson, Toshiba, Fujitsu, Fuji, GTE, Corning Glass, Intel, Xerox, KTM, Philips, B.E., GEC, Thomson, Microsoft, and World Logic Systems. IBM has so many alliances in Japan that there is a Japanese book on the subject called .
The driving force behind all these combinations is the need to make the most out of increasingly precious and highly mobile intellectual capital. Research and Development (intellectual capital investment) has become a huge fixed cost for many high- (and medium-) technology companies. A new drug may cost $300 million to develop, a new jet engine, a billion. Moreover, the pace of technological development means that even a highly successful R & D effort may in the end not come up with a state-of-the-art product but, rather, with an expensive also-ran.
While politicians still talk of international trade and a few industrialists echo their statements, the integration of the world’s production is destroying the reason that a balance-of-merchandise trade should exist between countries. The trade deficit that was supposed to destroy America did not for the reasons we have mentioned. It can be argued that the very concept of a trade balance is an artifact from a bygone age. As long as capital — both human and money — can move freely toward opportunity, trade will not balance; indeed, one will have as little reason to desire such accounting symmetry between nations as between, say, New York State with California. We have built the beginnings of what George Gilder has called a “planetary utility.”
The most remarkable example of economic integration, on a regional basis, is the rapid progress being made by the EEC toward turning Europe into a single market. There will continue to be setbacks along the way, some serious, but nevertheless remarkable progress is being made. The EEC was formally established in 1958 as an outgrowth of an earlier effort to form the European Coal and Steel Community. After languishing in the backwaters of national politics for years, the explosive growth of the world economy focused attention on the attractiveness of a huge integrated market in Europe, and a target date of 1992 was set to achieve it. By that date, the EEC nations intend to have dramatically eased the movement of people, goods, and money across national borders, harmonized thousands of national regulations and more than a hundred thousand technical standards; sweep away onerous barriers to trade and entry, and lower the costs of doing business throughout the community.
This effort is remarkable first because the single most common argument one hears for it is that European companies need guaranteed access to a much larger market than that afforded by their home countries if they are to support the development of information-rich products.
Page 88
The other remarkable thing about the pursuit of the single market is that a new generation of European business leaders has not waited for the political process to adjust to the information age but have sought to adjust it. The single market is more advanced in fact than in law, as business practice has outpaced legal reform. The armies of civil servants who stamp entry documents and compute border taxes are understandably not enthusiastic about seeing their jobs eliminated.
Clearly, a common currency will be the final step in a completely integrated market, and the EEC has moved toward this eventuality, but this surrender of sovereignty touches the very heart of the nation-state. To lose control of the right to issue currency is an attack against one of sovereignty’s most valued rights. As trade between European countries grew, as business alliances proliferated, and as money capital was needed from wherever savings existed, the need arose for a unit of account that would be relatively immune from the changing relationships among national currency values. Several ideas were put forth, but most centered on some kind of a basket of currencies so that no particular devaluation or reevaluation would overwhelm the rest. After a few false starts, the European Currency Unit (ECU) emerged as the market’s way to solve a problem. The ECU looks like a currency and is used like a currency, but it lacks one essential element, and that is the backing of some national or international monetary authority. The matter is further complicated by the fact that about the same time as the market was creating the ECU, governments were establishing a similar unit with the same name created by the European monetary authorities through swaps with the European central banks. These institutions thus become obligated to exchange 20 percent of their gold and dollar reserves for official ECUs. These official ECUs are not convertible into any single currency and cannot be traded. Additionally, the failure to establish a European monetary fund has given these official ECUs a certain
Page 89
fragility that has prevented it from emerging as a reserve currency. The private ECU, on the other hand, which grew up in response to market demand, is growing in usefulness all the time. Corporations are using the ECU for denominating notes, bonds, and accounting entries. In 1989, there were 114 bond issues totaling 11.2 billion ECUs, up from 71 issues for 6.6 billion in 1987. The percentage of bonds issued in ECUs as against all bond issues stayed steady at about 4 percent. There has also been put in place an ECU clearing system that handles billions of ECUs a day and has become a vital part of the new, emerging European system. Today, more than five hundred banks lend, take deposits, and deal in the private ECU in the same way they handle any other currency. Some governments have even used the private ECU in their money raising efforts in Europe. The Japanese government, for example, guaranteed an issue of Japanese highway bonds in 1987 denominated in ECUs. What has happened, in effect, is that the governments, by not moving quickly enough to establish a usable common currency, have been bypassed by the market, which has created its own international currency, albeit of limited utility. Although not accepted as legal tender by any European government, the ECU grows in importance every year, since more companies need a stable European unit of account for cross-border contracts and a simpler and more accurate way to report the fortunes of pan-European businesses. The official movement toward creating a common currency in the EC (European Community) was given impetus at the meeting of ministers held in Holland in late 1991, but in the meantime private ECU is serving a very useful purpose.
The single market comes at a real cost in traditional national power and sovereign prerogatives: Brussels, where the European Commission and the European Parliament are located, now entertains more lobbyists than any city in the world other than Washington, testimony to how much power
Page 90
has shifted towards this transsovereign body. But this shift in power, though guided by European leaders of admirable vision and leadership, came largely in response to economic and social forces, which in turn were driven by the information technology that made Europe into a de facto common market long before the national governments might have wished.
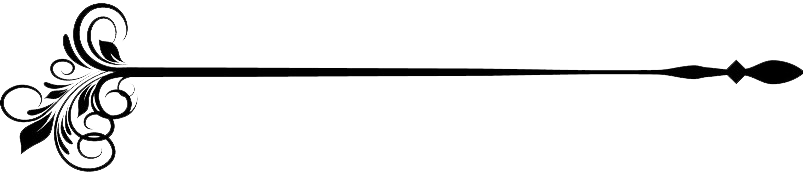
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Six
Where We Stand
“A…useful and somewhat surprising lesson of historical scholarship is that widely accepted facts are often wrong.”
George Stigler,
WE ARE SO ACCUSTOMED TO THE VARIOUS STANDARDS OF measurement we commonly use that we seldom stop to consider either their validity for today’s world or their history. We have a surfeit of numbers quantifying every aspect of life. This was not always the case. The historian Fernand Braudel tells us for example: “Nobody knows the total population of the world between the fifteenth and eighteenth centuries … the figures are few and not very reliable. They apply only to Europe and…to China…What about the rest of the world? There is nothing in fact on non-Chinese Asia, outside Japan.”
The measurements of time and distance we use today evolved slowly, and each refinement often ran into resistance from those with a vested interest in the familiar measures. Time is a good example. The Egyptians developed one of the first successful measuring devices when it occurred to them to use the sun’s shadow to measure time. The result was the first crude sundial. With admirable, if misplaced, logic they located the hour markings equidistantly from each other. We now know that this actually produced
Page 92
hours of uneven length, varying with the seasons of the year. But since there were no alternative measuring devices, people became accustomed to relying on these somewhat eccentric instruments and were convinced they were accurate.
About five hundred years after the first sundial was constructed, the Egyptians invented the water clock. The artisans were dismayed to discover that their new water clocks did not tell the same time as the sundials. They assumed that the sundials, which had been used for centuries, were correct and spent considerable time and treasure in frustrating attempts to construct a water clock precisely as inaccurate as a sundial. It was not until the fourteenth century that mechanical clocks were constructed that produced accurate measures of the passing hours. Town clocks in that era had no hands or dials, as the populace was illiterate, but did ring bells to mark the passing hours.
When we encounter a new situation, we assess it against some yardstick of our experience. We are now in the midst of a huge technological and economic revolution. Yet we are so accustomed to using the standards of economic and social measurement developed for the industrial age that we seldom stop to consider that the old measures of economic progress and decay, success and failure, are rapidly losing their usefulness. Much of the economic hysteria that has become a constant background to discussions of government policy or business strategy is traceable to the increasing inaccuracy or irrelevance of our standards of economic measurement. The declining usefulness of these standards seems to be one reason so many very good economists lately have been so wrong about the direction of the economy. For the last seven or eight years of the decade of the 1980s, the standard blue-chip economic forecast went like this: “We are surprised how strong this quarter is, but we expect the next quarter to be weaker, and the recession to occur four or five quarters out.” Words like these resound from innumerable podiums over that time period. The problem with this standard forecast was that
Page 93
for a very long time it was wrong, although like a stopped clock that is right twice a day, it momentarily described reality. What these failed forecasts demonstrate is that even very good people will make bad calls when they must use bad information.
Flying by faulty instruments is dangerous. The old instruments may convince us we have failed where we are succeeding or persuade us to turn about in vain pursuit of our past rather than successfully navigating the future. If we are to cope successfully with the information economy, we shall have to develop a new methodology to measure economic success and failure.
In some cases this may mean merely updating and revising measurements that have served us well for many years. But in other cases we must be prepared to give up forever the statistical surety of the old numbers in favor of less quantifiable indicators. America’s balance of trade figures, which are much lamented, today conceal more than they reveal. Murray Weidenbaum has written:
Two basic statistical indicators make the point: The first is that one-half of all imports and exports are transacted between companies and their foreign affiliates or parents. From the viewpoint of political geography, these are international transactions. But from an economic and technological viewpoint, the flow of goods and services are internal transfers within the same enterprise. A second way of looking at the global market is to consider that one-half of the products manufactured in the U.S. have one or more foreign components.
(Our current accounting conventions fail to take these new realities into account.)
Knowledge, the fundamental capital stock of the information economy, is far more difficult to quantify than the material wealth and real assets that previously dominated economic thought. As it becomes clear that today really is
Page 94
different from yesterday, nations may be forced not only to change the way they measure their economies but also to modify their ambitions to regulate and control them. If it turns out that the economy of the future really is fundamentally more difficult to measure than the economy of the past, governments may have to relinquish many of the powers of economic planning and control they have acquired over the past several hundred years.
George Stigler, the Nobel laureate who has done such brilliant work on the consequence of economic policies, put the problem this way:
The first and the purest demand of society is for scientific knowledge, knowledge of the consequences of economic actions…Whether one is a conservative or a radical, a protectionist or a free trader, a cosmopolitan or a nationalist, a churchman or a heathen, it is useful to know the causes and consequences of economic phenomena…Such scientific information is value-free in the strictest sense; no matter what one seeks, he will achieve it more efficiently the better his knowledge of the relationship between action and consequences.
In order to get that information, we must measure things impartially. This is easier said than done. Einstein’s theory could be proved by using the photographs of a solar eclipse. The wealth of nations is more elusive. Not long ago in historical terms, land and wealth were seen to be one and the same. So were other natural resources. Then, as the Industrial Revolution remade Western society, economists gradually accepted manufacturing as a creator of wealth.
In the 1980s, as the industrial age began to fade into the information society, the same arguments took place but with different protagonists. Making “things” in a factory, not punching computer keys, created wealth, we were told. The measurements of wealth and progress we have become accustomed to in the industrial age may be no more relevant
Page 95
to the information society than the of William the Conqueror, which recorded ownership of parcels of land, was central to wealth creation in the industrial age.
In modern times, one of the principal sets of measures published by our government is the National Income and Products Accounts, which yield, among other things, the official estimate of the gross national product (GNP). These statistical measures were constructed during the Great Depression when our GNP was about $56 billion, the economy was dominated by traditional heavy industry, and national exports at, $500 million, accounted for less than 1 percent of the GNP. By any reckoning measurement of GNP is an immensely difficult task, and one can only admire the skill of the people who constructed our national accounting system. But given the dramatic changes in the economies of the United States and the world, too great a reliance on sixty-year-old national income accounts puts us in real danger of mismeasuring the economy. Since fiscal 1969, the U.S. government has used a unified cash-based budget that does not produce results congruent with generally accepted accounting principles. One of the principal aberrations from good accounting principles is that there are no capital accounts. Everything the government buys is “expensed” — a several-billion-dollar road system, Yellowstone National Park, or a ten-cent pencil. It would be hard to find a serious accountant who would endorse this bookkeeping system. Its employment in the private sector might force prosecution for fraud.
Today’s method of calculating GNP not only fails — except indirectly — to capture the benefits of rapidly accumulating knowledge, but it is also marred by inconsistencies. For example, income is imputed by formula to the owners of homes that they occupy, but there are no imputations for streams of income that flow from the use of autos, dishwashers, and other consumer durables. In times of high taxation, these durables — which are arguably capital investments — often provide shelter from the ravages of inflation.
Page 96
Because of these and other difficulties it becomes increasingly arduous to measure recent GNP achievements and much more formidable to make projections into the future.
Government is incapable even of telling us with any precision what the last quarter’s GNP growth was. Final figures are not issued until three years after the close of a quarter. The difference between the Commerce Department’s first reports on the GNP for a quarter and the final figures show huge variations. If, for example, the initial report indicated a GNP growth of 3 percent, virtually a full 50 percent of the time the final figures show statistical growth of either less than 1.5 percent or more than 4.5 percent. One time in ten the adjusted final figure would be recorded as less than 0.5 percent of more than 5.5 percent. Figures that vary that much rarely furnish a firm foundation for policy decisions. The record of looking ahead for most forecasters, public or private, is even worse.
Yet the GNP and other national economic measurements play a critical role in the formulation of economic policy. The federal deficit is a case in point. Federal fiscal policy depends on accurate forecasts of the deficit, which in turn depend very heavily on GNP projections. Yet the numbers produced by the Congressional Budget Office (CBO) are often substantially at variance with those produced by the Office of Management and Budget (OMB), an agency of the executive branch. For the fiscal year 1991, the CBO estimated the federal deficit at $138 billion, while the OMB projected a deficit of $63.1 billion — a difference of $74.9 billion. Political agendas obviously intrude on these supposedly objective measurements. Doom and gloom clashes with the rosy scenario, and it becomes ever more difficult to tell who is right.
Federal Reserve monetary policy is heavily dependent on comparing GNP estimates with estimates of the nation’s productive capacity. What rightly concerns Fed policymakers is how fast the real economy can grow over the long haul with-
Page 97
out inflation. What is the real potential growth rate for real GNP? The Fed, as nearly as one can infer from its public statements, assumes GNP has the potential to grow at around 3 percent before running into the physical limitations imposed by capacity. The Fed may act to slow growth if the economy grows at the persistently higher rate in order to slow inflation. On the other hand, some of the Fed’s supply-side critics insist that potential GNP growth is as high as 5 percent. The issue is anything but trivial. The difference between a 3 and 5 percent potential could mean a huge difference in the level of real GNP over a ten-year span. Clearly reliable assessments of potential growth are essential, and deciding the reliability of these measures in turn rests in part on whether or not current measures of industrial capacity remain relevant in the information age.
Some argue that when industrial production reaches approximately 85 percent of capacity, the economy approaches the physical limits of its output, raising the possibility that further growth will be inflationary. In today’s economy this traditional rule of thumb may be outmoded, since industrial production employs only about 20 percent of American labor, with the balance working in the nonindustrial sectors of our society, where there is a huge potential for expansion.
Despite the decline in the percentage of non farm workers employed in manufacturing — from 31 percent to 19 percent today — manufacturing as a share of the GNP has remained remarkably stable throughout the postwar period. We have seen in our factories the same phenomenon that so dramatically changed American farms. Fewer and fewer people are producing more and more goods. It is estimated that in 1810, 80 percent of the labor force was employed in agriculture; by 1910 it had fallen to about 30 percent; and today is roughly 3 percent — and yet we can and do feed the world.
This relatively steady output, in the face of a massive exodus of workers from industry, raises the question of whether the utilization figures on percentage of industrial capacity
Page 98
mean the same thing for inflation as they once did. Indeed, this measure of capacity utilization played a key role in leading some forecasters to overestimate inflation during the 1982-87 economic expansion. Another reason the capacity utilization index misleads unwary economists is that it covers only manufacturing, mining, and utilities, activities that account for a shrinking share of U.S. output.
The standard industrial codes that once told how industry is organized are now out-of-date. Of the twelve major code divisions, only two reflect the service industry, although about 80 percent of Americans work in a service business. Accurate numbers are available on the number of brakemen on American railroads but not on the number of computer programmers. This is but one example of why today’s economy cannot be fitted into yesterday’s standards. If basic macroeconomic measurements, such as GNP and productive capacity, do not mean what they once did, the question then becomes: Can we construct new, more reliable measures of the kind of economy we now have?
We can with the power of modern computers. Like any change, a new way to measure our economy will be resisted. Charges will be leveled that the books are being cooked. When I entered the banking business, earnings were reported before allowance for loan losses. Citibank started to publish its reserve figure — an innovation at the time — and then instituted the concept of reporting earnings after allowing for loan losses. At the time, both initiatives were roundly condemned by our fellow bankers, although today both are standard. Just as each line in the federal budget has a political constituency, so also do various political and business groups have a stake in how our GNP is measured. The problem of changing yardsticks will always be more political than technical.
Some of our trading partners, however, are already moving in this direction. Japan proposed in January 1989 that the Office of the Economic Cooperation and Development (OECD) change the way it measures economic performance.
Less reliance should be placed on the traditional measures, such as trade and budget figures, and more on spending on research and development, the extent of overseas investment, the ratio of high-tech industries to service companies, changes in industrial structure and labor mobility, the productivity of labor and capital, and the contribution of newly developed businesses. Yet even a corrected set of traditional measuring sticks for the national economy might not be as relevant as they once were precisely because they are strictly national in scope. Once that was appropriate. Today, however, the global marketplace has moved from rhetoric to reality. National economies are no longer islands but, rather, an integral part of a larger global market.
In practice this fact of life is often overlooked. In 1972, for example, when U.S. imports as a percentage of the GNP were only about one-half as large as they are today, many forecasters underestimated the sharp increase in inflation that would follow the devaluation of the dollar that year. Other nations whose livelihood has depended on trade for years were not surprised.
The Netherlands, with a population about the size of New York State, although it maintains its own GNP accounts, knows full well that any sensible analysis of that nation’s economy must proceed by looking at the rest of Europe as well. What is obvious about the Netherlands is true even of the United States. It makes little sense today to use the GNP of the United States as presently computed.
For instance, for much of the 1980s economists predicted that the federal deficit would absorb so much of our domestic savings as to “crowd out” private investment. The crowding-out theory was never validated — the 1980s saw a powerful increase in U.S. business investment — because the theory ignored the reality of the global market. The proponents of the theory added up all the capital instruments sold on Wall Street in a year and then took the amount of federal debt sold and computed a ratio that purported to say that the federal
Page 100
government absorbed some significant percentage of all capital raised. That ratio may once have been useful, but today Wall Street, while still integral, is just one part of the global market. If foreigners choose to give up their currency to buy dollars to invest in America, it is not an act of charity but a hardheaded decision that they can do better here than at home. While still huge, American capital markets are only one option for raising money. It is a matter of complete indifference to the chief financial officer of any major company whether one sells capital notes in New York, Hong Kong, or London. Decisions are made on the basis of rate and availability, not geography.
These tight linkages make the growth rates of our major trading partners ever more essential to U.S. prosperity. Policies aimed at giving the GNP of the United States a short-term boost while ignoring possible global impacts are even less well advised today than they were sixty years ago, when a binge of protectionism helped bring on the Great Depression.
As the reality of the global market sinks in, policymakers from different nations will come to understand that even the strongest sovereign cannot entirely control his own destiny but will increasingly be forced to cooperate on economic issues it once regarded as almost exclusively national concerns. This in itself will force them to reexamine the ways it measures its national economies and may well spark a vigorous international effort to assemble more meaningful data on the world economy. The suggestions of MITI to the OECD, referred to earlier, is a first step in this direction.
The global economy may also prompt some increase in international economic regulation and even some more forceful attempts at international economic planning and manipulation. However, as we shall see in greater detail in later chapters, the barriers to procrustean government regulation in the information age are substantial. Moreover, however intensely nations cooperate in search of better data, they may never be able to measure certain economic phenomena with the apparent assurance with which we once measured the industrial economy.
Page 101
In recent years we have witnessed furious, often partisan debates, about two leading factors in America’s struggle to remain economically competitive: capital formation and productivity. Of both it has been said with great confidence that they were lagging and soaring, that they represented the light at the end of the tunnel, and that the light at the end of the tunnel was an oncoming train. The truth is the information economy has made both far more difficult to measure. Assets recorded on today’s balance sheets tend to be things we can feel and touch. On the accountants’ ledgers the intellectual capital a company acquires tends to be treated as an expense, not as a real asset; it is not carried on the capital accounts along with the shiny new company car or the aging brick factory building, though neither contributes as much to the enterprise’s productive capacity.
The magnitude of the distortion is suggested by the fact that the world software market in 1989 was estimated to be between $50 and $60 billion and growing at about 15 percent a year. As far as the accountants and economic statisticians are concerned, this $50 or $60 billion has almost disappeared into thin air. Companies expense most of the software when they buy it, and it appears in total on nobody’s balance sheet as an asset that is in fact used on a daily basis.
If the software sold by IBM and thousands of other software producers suddenly disappeared, factories would stop running, accounting and payroll systems would cease to function, all the telephone switches would freeze, airlines would stop flying, and the economy would halt. It is hard to imagine such a vital business asset being virtually unrecorded anywhere, but that is the case.
If capital is what produces a stream of income — and that is a definition no one seems to quarrel with — then it follows that software is a form of capital.
Page 102
It has always been difficult to measure any form of knowledge capital, but in the past the problem was not as urgent, since the ratio of difficult-to-quantify knowledge capital to more tangible capital was not as high or growing so rapidly as it is today.
This development throws a different light on the problem of capital formation. To enter a business, the entrepreneur in the information age often needs access to knowledge more than he or she needs large sums of money. To write a software program that might make its author millions of dollars may require only a relatively trivial investment (enough to purchase a personal computer or at least rent time on a mainframe) compared to the investment needed to enter, say, a manufacturing business producing a comparable stream of income. It is the knowledge capital accumulated in the software writer’s head or in the documentation or on disks that makes possible the new program. This capital is substantial and very real. And it does not show up with any clarity in the numbers economists customarily quote about capital formation.
The trends that are making intellectual capital an increasing proportion of national wealth are accelerating. At least 80 percent of all the scientists who ever lived are now alive. In our own country at least half of all scientific research done since the United States was founded has been conducted in the last decade. With the total stock of our knowledge doubling about every ten or twelve years, it is clear that our intellectual capital is being formed far more rapidly than tangible capital.
Even the numbers we use to describe tangible capital investment are sometimes misleading. The figures may show that we are “disinvesting” when what we are really doing is paying less money for much more capacity. We see this in the ratio of price to capacity in the hand-held calculator or the watches on our wrists or the personal computers on our desks. They cost less than they did a few years ago. But they do more and by any reasonable standard represent an increase of capital. The intellectual value-added in a microchip far outweighs any cost of labor and materials.
Page 103
Experience shows us that the information economy drives down manufacturing costs (as compared to capacity, not units) at a pace that seems far faster than typical during the industrial era for the simple reason that as information products are refined, they rapidly gain capacity without increasing in size, cost of materials, or labor. The entire Industrial Revolution, says Dr. Carver Mead of the California Institute of Technology, “enhanced productivity by a factor of about a hundred.” But “the microelectronic revolution has already enhanced productivity in information-based technology by a factor of more than one million — and the end isn’t in sight yet.”
In doing their capital accounts, accountants have traditionally equated cost and value. This was a sensible procedure in the past, when the intellectual value-added in most products constituted a relatively modest proportion of the cost of labor, materials, and machinery, and the prices of products therefore fell at he relatively slow pace allowed by the industrial learning curve.
Imagine what this truth would mean for automobile manufacturers if, over the course of a few decades, without increasing the price or size of a six-passenger car, they could figure out how to make it hold 600 hundred people, travel safely at 5,500 miles per hour, and get 2,600 miles to the gallon! That is roughly what has happened in the computer industry.
Nor are these considerations limited to stand-alone calculators and computers. As we saw in chapters 2 and 3, the microchip and other information technologies are everywhere. The usefulness of traditional capital accounting is being undermined by the spread of information into nearly all the “hard” products of our age.
At Citicorp, I encountered a perfect example of how the current vocabulary of economics and business describes a world that still exists in part but fails to capture the essential dynamics of this new world.
Page 104
My Citicorp colleague John Reed invented for us the term “investment spending,” a concept it took us some time to understand as it seemed, at first glance, to be a contradiction in terms. But it was, and is, appropriate to our times. Simply put, in an information-based economy much of what we now consider expenditure — staff, software, or marketing programs, for example — is actually capital investment: It produces a high return and is self-financing.
Almost every day brilliant young scientists and engineers are hired by business enterprises for a fraction of what it cost American universities to produce them. Of course, even toting up the true dollar cost of their educations would fail to measure the contribution of the uncounted intellectual capital (retained intellectual earnings, as it were) accumulated by the universities over the years.
In early 1990, Intel Corp., one the most important commercial enterprises of the information age, announced yet another of its stunning breakthroughs in information technology. Intel made fundamental advances in “data compression” technology that allows huge amounts of data — words, numbers, or pictures — to be transported from place to place in a fraction of the time currently required. Two-hour movies can be sent to your home in minutes; masses of data can be dispatched without tying up expensive circuits. The new technology will create enormous value for any enterprise, from the movies to modern medicine, that depends on real-time management of very large batches of complex data.
This new development will produce a stream of income, though river or tidal wave might be more accurate. Yet what economist would volunteer for the job of quantifying the intellectual investments responsible or figuring the return on investment? To be sure, Intel has been a research-based company since its inception and could show hefty expenditures in that regard.
Page 105
But the essential base of knowledge capital could not be contained or counted within the walls of Intel or even inside the borders of Silicon Valley. What is the knowledge capital base at Cal Tech or MIT or at the other universities that helped make Intel what it is today? How much capital did they form last year? What income will that capital produce? When will its effects be measured in the economy? Impossible-to-trace intellectual investments add more value to the economy almost overnight than years of carefully retained money earnings and cautious expansion in physical-plant improvements.
As the percentage of “knowledge workers” to manual workers increases, the difficulty of measuring productivity grows proportionately. The debate over the status of American productivity has been much in the news. How does America stack up in the global marketplace? Is the growth of American productivity greater or less than that of other nations? These are important questions, but once again what do the words mean? Productivity, in the simplest terms, used to mean output per man-hour. While that was a useful concept in manufacturing, do we really have any meaningful measure of productivity for this information-intensive age when the vast majority of our workers are employed in the knowledge or service sectors? Current methodology, although quite sophisticated, fails to supply really meaningful numbers in many instances.
The huge and growing financial service industry is one example of the difficulty of measuring productivity. Once we get past counting the number of checks cleared per hour or the number of insurance claims paid — all of which display greatly improved productivity, thanks to the computer — we then move immediately into the realm of the subjective. Is a loan officer’s productivity in a bank, insurance company, or a credit company to be judged on the number of loans made per day? The size of the loans? The number of loans that are repaid on time? The quantity of bad debts created? How do you measure the productivity of workers who make such critical judgments? No one really knows, though many have tried.
Page 106
The challenge of measuring productivity is spreading to the industrial sector as information supplements, and in some cases replaces, physical capital. As Shoshana Zuboff and others have pointed out, management’s usual first impulse has been to assess the productivity of factory automation almost exclusively by job reductions. But as her ambitious study demonstrated, even in enterprises in which automation was well handled, job reductions often fell short of expectations. The remaining workers, however, began to make new contributions to customer needs, including more reliable quality and faster and more conscientious service. Such improvements would not necessarily show on the books in a timely or easily quantifiable manner, though making great medium- and long-term contributions to the enterprise.
As Zuboff also points out, in a well-automated environment (and badly automated ones still seem to predominate in this new world) workers are enabled to more fully comprehend the productive process and take on more responsibility for it. That presents a challenge to middle managers, who rightly feel that their traditional roles are being taken over in part by automated scheduling and task-assignment systems and in part by self-policing workers themselves.
The best managers look for new ways to add value to the enterprise, and the others eventually follow along. Yet if these managers do begin to add value in thoroughly unexpected ways, how accurately will this phenomenon be represented by productivity statistics? Will the raw numbers reveal the history of productivity growth or obscure its true sources? And how many speeches will politicians have made in the meantime about declines in productivity because they were looking at old numbers, not new realities?
As information applied to work adds value to every aspect of economic activity, the problem of assessing productivity spreads throughout the economy. As long as we are unable reliably to quantify the productivity of knowledge workers or information technology, statistical alarms or number- crunching boasts about American productivity will have little credibility.
Page 107
It will take a long time to construct a new measuring system for our global economy. When we achieve this goal, many will dismiss the results because they will be different from our current system in the great tradition of those who dismissed the accuracy of water clocks that did not agree with sundials. Nevertheless, until we do construct a new system, we may never again have such comfortably reliable statistical measures of the productivity of people or investment as we had in the past. The firm statistical measures of the industrial era may have been an artifact of their time. So how will we judge what course to take? Deprived of truly relevant numbers, we may have to substitute judgment plus a healthy dose of modesty, a combination sometimes called common sense.
For governments, the difficulty of quantifying intellectual capital or productivity will mean that they, too, will have to fall back on common sense, including an extra-large dose of modesty. Grand dreams of planned economies hail from an era in which government economists, like the accountant who opposed the Brooklyn Bridge because there was plenty of room on the ferry, used to be pretty sure what made economies work. They were usually wrong, but they were sure that view of reality, derived largely from statistical pictures of the economy, was correct.
As we move into the information economy, that certainty will erode, at least for a time. Our statistical portraits may have to owe more to the impressionist school than to academic realism. Governments that value prosperity will have to give up their dreams of economic fine-tuning. You can not fine-tune (if you ever could) what you can not measure. Not all or even most political leaders will want to admit this. But these difficulties will be one more force arrayed against government manipulation of the economy, and it is only reasonable to expect them to have some effect.
Page 108
It will become essential for governments to recapture the wisdom of Socrates: to know that they do not know.
For governments, common sense in pursuit of prosperity may mean less fiddling with the details of economic output and more hard work on input, particularly of the human variety. The quality of education may be the most important way government can address productivity. Peter Drucker has called information the “primary material” of the new economy. If Marx were alive today, he might fairly call education the means of production.
If we are to compete in a global marketplace, we must constantly build and renew our intellectual capital. We have little or no control over the natural resources within our borders, but we do have control over our educational and cultural environment.
Our success in achieving outstanding agricultural productivity was not unrelated to our educational structure. When Abraham Lincoln signed the Morrill Act in 1862, the first land-grant colleges were formed offering courses in agriculture, engineering, and home economics. Some years later, in 1887, the Hatch Act expanded the program with federal funds for research. The county agent was the conduit of the new technology from campus to farm. And the United States, in large part as a result of such efforts, gave birth to the green revolution.
Soshana Zuboff observes that a key factor in determining whether workers succeed in realizing the full potential of information systems is their ability to master the technology and use it to create unexpected value rather than passively serving it. But this mastery requires workers to operate on levels of abstract and symbolic thought that may never before have been required in their jobs. It can be done, even by workers who never expected to evolve out of the blue collar tradition. These new “intellective” skills, as Zuboff calls them, can be learned. But poorly educated workers, with minds untrained in and unchallenged by the abstract skills of math and science, who lack the confidence to learn the new system behind the new technology, are much less likely to meet the challenge.
Page 109
Although much has been written about the decline of American competitiveness, in many ways this new global market plays to our strengths. The constant in the global marketplace is change, and change is what we Americans deal with best. We have always been innovators. Who else would choose as a national motto on our great seal “” — the new order of the ages. This native adaptability is in itself a kind of “infrastructural” advantage, an infrastructure of culture that will serve us well as long as we refuse to panic in the face of statisticians and pundits wielding yesterday’s numbers and telling us we’re washed up if we remain ourselves.
In a time of often confusing transition, our goal must be to make common sense of the order of the day. We must tell the politicians and pundits to stop flogging us with increasingly meaningless numbers. The governments of the world must drop the pretense of being able to outguess a world market that was always too complex to accommodate the pretenses of economic planners and which now less than ever can fit into any central plan or “industrial policy.” But we can help our economic position by doing what we know is right: nourishing the growth of intellectual capital and shunning superstitious reverence for materialist totems of a bygone era.
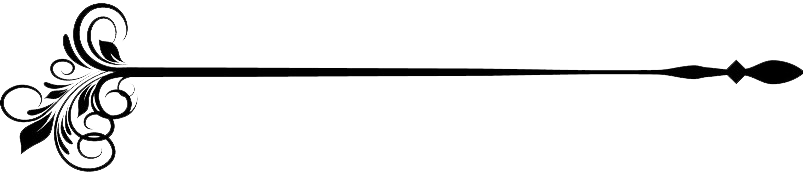
The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming Our World
Wriston, Walter B.
1992
Chapter Seven
Serendipity Inc.
We are limited, not by our technology, but by the way we think. We still think just the way we thought two hundred years ago, as if nothing had happened.
Carver Mead
POUL ANDERSON, ONE OF OUR MOST THOUGHTFUL WRITERS of science fiction, imagines in one of his “future histories” an interstellar consulting agency called Serendipity Inc. With the aid of the most capacious computer in the galaxy, Serendipity sells only one thing: information about potential opportunities in distant solar systems. Serendipity does not sell to the general public. Its only clients are an elite cadre of space pioneers, traders, and adventurers who in the course of their own travels pick up unique and timely bits of information about the remote reaches of the galaxy. Much of this information, though not relevant to their own enterprises, could be enormously profitable to others in a different line of business.
In exchange for a deposit of such fresh information and an enormous fee, the Serendipity computer will provide for a client the exclusive information on some far-flung opportunity tailor-made for the client’s own capabilities. But, and here is the most intriguing part, the client does not ask the computer any specific questions, for any subject about which he knows enough to ask is probably too widely known to justify Serendipity’s enormous fee.
Page 111
The whole point of the computer is that it has access to vast and obscure realms of knowledge of which the client knows nothing. The client simply tells the computer about his company’s interests and resources. The computer then selects the single galactic opportunity for which the client is best suited, and tells him what he needs to know to pursue it, without fear of competition, since no one else will be sold the same information.
Anderson was imagining a future time in which information is the most valuable of all resources. That time is now, and Serendipity, Inc. and its clients, however fanciful, are in a very real way models for business corporations under the information standard. In their corporate strategies and structures, and even in their relationship to the state, Anderson’s creations reflect the transforming power of the Information Standard.
When information technology made information the most important factor of production, it made the timely acquisition of the best information the number-one goal of business management, as it is for Serendipity and its clients. Information technology is simplifying corporate structure: The layered hordes of middle management whose primary function was once to move information up and down the corporate hierarchy are disappearing; at Serendipity the computer has replaced them entirely. Finally, no government bureaucrats regulate Serendipity or its clients. For one thing, the government neither knows nor understands what Serendipity is doing. Even in our own time, the paradigmatic information industries, such as microelectronics, remain largely unregulated because their technologies change too fast for any regulatory agency to keep up. Moreover, such industries are not only led but staffed at almost every level by knowledge workers who bridle at the idea of outsiders and amateurs from the government interfering in their work.
The supremacy of the sovereign state depends to some extent on the exercise of that power over lesser institutions.
Page 112
The most important of these institutions in a market economy is the business corporation. As the information standard changes the business corporation, it will change the sovereign state itself.
Information technology is changing the “government” of businesses, upsetting the “sovereign” privileges of top business executives and the traditional roles of middle managers and both traditional and professional workers, spreading corporate democracy, and making corporate subjects into corporate citizens.
This is a sea change from the time the large business corporation first appeared. Until recently, corporations have been organized along the same lines as the largest and most complex state organization: the military. The branching hierarchy of the military bureaucracy, which was essentially a communications system, and the tradition of following orders without question, fulfilled the army’s primary management goal: to make all the parts of a vast body respond as one to directions from above and to funnel intelligence smoothly in the opposite direction. One person can personally command or communicate with only so many others. As a result, the system developed into a hierarchy, replete with sergeants directing squads, lieutenants directing a platoon, captains directing a company, and so on up the line to the commander in chief.
By the end of the nineteenth century, the growing size and complexity of industrial organizations demanded similar coordination. The assembly line that vastly increased the flow of products per worker also greatly increased the need to manage and coordinate those workers: Middle management was born. Like sergeants, captains, and lieutenants, these men and women were skilled messengers bearing information up and down the line to keep the systems running smoothly. They had to make sure that the right part reached the right place at the right time, or else the process would break down.
The railroads provided an early example of modern business organization. Some attribute this to the fact that in the early days the railroads hired a great many men from the army corps of engineers to help them build their system and that they brought both their engineering knowledge and their organizing skills to the business. As trains began to move at speeds far beyond human experience, the roads were plagued by accidents. Railroad management responded by establishing chains of command at least as strict as those of a military unit. With the aid of an indispensable telegraph system, trains could be kept on schedule and out of danger.) The system did more than prevent accidents; it became a vast and systematic management tool. Managers throughout the railway system were required to file detailed and standardized daily, weekly, and monthly reports on traffic, maintenance, costs, etc., a real innovation at the time. The system certainly helped keep track of cars and freight and made it possible for the roads to use their resources sensibly. But it also shifted power up the hierarchy in the direction of those receiving the report and reduced the autonomy of those below. As James R. Beniger writes:
[The Western Railroad] programmed its operating workers with “careful and explicit rules.” Enginemen, for example, became little more than programmable operators, dutifully following rules like “in descending grades higher than 60 feet per mile passenger trains are not to exceed 18 miles per hour and merchandise trains not over 10 miles per hour”… [The] conductor …had standardized detailed programs for responding to delays, breakdowns and other contingencies … carried a watch synchronized with all others on the line, and … moved his train according to a precise timetable.[57]
These conductors, lower-echelon managers, were largely information carriers. So were the station and district managers.
Page 114
Indeed, not only in the railroads but throughout the industrial economy moving information was once the main task of most people dignified by the title manager. Now we move most of it by machine. As Beniger points out, the conductor in many ways functioned as an on-board computer system. Today for many purposes he has been replaced by one.
Long before computers, the exquisitely organized management hierarchy of General Motors helped it dominate the automotive industry. A human information feedback system, starting at the dealer level, allowed the top management of the largest industrial corporation in the world to revise its production decisions every ten days. The industrial-era assembly line stayed in sync through the efforts of an army of clipboard bearers, grandly called managers, who constantly checked that the right parts and workers were in the right place at the right time doing the right things at acceptable levels of quality. Even mid-nineteenth century factories, few of which came close to fulfilling the assembly-line vision, required vast information systems consisting of whole corps of managerial workers that had never existed before.[58] ) Middle managers were unknown in the United States before the mid-nineteenth century, yet managers and clerks accounted for almost 17 percent of the U.S. work force by 1940. From 1900 to 1910 the number of managers in the U.S. work force grew by 45 percent, far outpacing the growth in the general work force. In the same decade, the number of stenographers, typists, and secretaries, the staff workers for middle management, increased 189 percent.[59] All these people shared essentially one function: to carry information up to decision makers and then carry the decisions back down.
Those at the top of such a classic industrial hierarchy might fancy themselves Napoleons of commerce, sole owners of the big picture, whose commands, conveyed eagerly by hundreds of white-collared subalterns, would turn squadrons of marketeers on a dime or unloose a devastating barrage of production. That world is vanishing.
Page 115
Computers offer a hydraulic of the mind that frees us from much of the drudgery of information processing in the same manner a bulldozer frees us from much of the drudgery of dirt processing. When the drudgery vanishes, however, so do many of the drudges. The man with the clipboard is gone from most shop floors; the computers keep track of parts and people. In sales, the managerial hierarchy is being flattened as men in the field file orders from their laptop computers directly to the company’s mainframe. Staff and field managers whose job it was to present periodic pictures of the state of the business are disappearing because the state of the business is available to anyone with access to the computer.
Management layers that were set up to report rather than produce are beginning to disappear, changing the power structure of companies. The middle mangers who used to convey information and the upper managers who “owned” it and held power thereby are losing that power and in some cases their jobs. The new information systems flatten the management hierarchy. They change the very meaning of management and the skills needed to do it well.
In the future, what will managers do? The answer is both simple and unsettling: They will run the business, which is what they should have been doing in the first place. Managers, no longer forced to devote most of their time to acquiring or moving information, will be able to use information to solve business problems.
What will this look like, practically speaking? Many managers will find it looks disturbingly like work. For instance, more and more managers are spending time outside the hierarchy, working in ad hoc groups formed to solve specific problems, rather than in routinized information management. Typically, these task forces are composed of specialists in various phases of the business: accounting, legal, marketing, manufacturing, and technical. Quite often they are formed to fix a problem and are dissolved when the solution is found. The members of the task force operate more like professional workers, who offer their own particular skills to an operation, than like managers, who are defined by their place in the structure.
Page 116
Years ago, when Castro seized the assets of American banks in Cuba, Citibank had a task force in place to do several things: to see that Americans got out of Cuba safely, that Cuban assets in the U.S. were identified and arrangements had been made to seize them in satisfaction of debts due, to advise foreign correspondent banks of loss of control of the Cuban branches, to cancel test words and codes, to advise government agencies, to pass the proper accounting entries, and to take appropriate legal action. With all this done, the task force was disbanded, leaving behind a record of things learned for the next emergency. At the time, this was unusual enough to be noticed. Today it is becoming business as usual.
As the distinction between managers and professionals breaks down and managers do more professional work and less time facilitating the functioning of the corporate hierarchy, more and different types of people become eligible for leadership. It used to be all but axiomatic that the best loan officer in a bank would be groomed for the bank presidency. The credit function is still crucially important and must be always nurtured. But in a modern bank it may be more important to have as president the man with the best grasp of the information technology that allows banks to offer customers a range of services and options never previously imagined.
The new business organization will need different leadership skills. Hierarchical organizations provide tight control of a large group of workers by placing relatively small groups of workers, or submanagers, under the direct supervision of a higher manager. Thus, the steepness of the management pyramid. Flatten that structure and the people within it get a lot less direct supervision. It becomes more important for organizations to have well-understood common goals by which workers can direct themselves.
Page 117
The job of instilling such goals has more to do with persuasion and teaching and leadership than with old-style management. Successful business leaders are finding the skills of a good political leader are more relevant than those of the general.
Peter Drucker has compared tomorrow’s business leader to a symphony conductor, and it is a good analogy:
In some modern symphonies, hundreds of musicians are on stage together and play together. According to organization theory, there should be several “group vice president conductors” and perhaps half a dozen “division VP conductors.” But there is only one conductor — and every one of the musicians, each a high-grade specialist, plays directly to that person, without an intermediary.”[60]
The erstwhile commanders, moreover, are finding yet another a new challenge to their leadership: As information becomes the most important factor of production, good workers and managers acquire more of it. Former subalterns become formidable experts with specialized skills that may outstrip those of the boss. These people reject autocracy because their talents cannot be efficiently used by the “command and control” model.
In her book , Zuboff dramatically illustrates the changing meanings of corporate power, management, and leadership by telling the story of how full computer automation came to two traditional paper mills and failed in one but succeeded in the other. Both mills had long been run by a corps of middle managers who supervised blue-collar worker-operators. The operators had spent most of their time moving about the plants checking on individual processors, vats of pulp, drying rooms, etc., developing a keen intuitive sense for how to keep them working at their best. Only the managers, however, knew what was going on in the plant as a whole: Given production and other goals by their bosses, the middle managers used the operators as tools to control the plant and meet the goals.
After automation, however, the operators spent most of their time in a central computer room from which they could operate most of the equipment. But that central computer room also gave the operators a chance to get a far better sense of overall plant operations, to learn for themselves what only the managers had known before. Soon the computer system was enhanced with a cost-control program that helped to do what managers had once done: adjust the manufacturing systems so as to meet cost and production goals.
The result, in both plants at first, was that many managers began to feel uneasy. They feared for their status and even their jobs, viewing the operators as competitors and even enemies. In the less successful plant these anxieties dominated: Managers chastised for laziness operators who made good use of the computer instead of sticking with “real work.” Managers tried to keep information from operators, discouraged them from taking on new responsibilities, or refused to share their expertise. Morale suffered, workers began to shy away from learning the system, and automation fell far short of its goals. As one worker complained to Zuboff: “[The managers] don’t want us to know very much, and the more they keep us in the dark, the more they can order us around.”[61] An engineer from the same plant agreed: “They tend to try and keep the operators in the dark as a form of job security.”[62] And upper management was indeed considering whether many of the middle managers might have become obsolete.
At the more successful plant, however, some middle managers did find a new and genuine role: that of teacher. The operators, after all, were blue-collar workers whose main tools had been experience and intuition, not the abstract skills demanded by the new system. They needed teachers.
The managers who understood this and worked to become teachers got the most out of the operators and were happiest with their jobs. As one particularly eloquent operator told Zuboff: “In a traditional system managers are drivers of people. You focus on driving people to work as hard as possible.
Page 119
With our new technology environment, managers should be drivers of learning.”
We do not now generally recruit managers for their teaching ability. But as information becomes an ever more essential ingredient of production, teaching will become one of the most important management skills. To become more productive, companies must turn more laboring workers into knowledge workers. To do this we will have to tell managers “right out loud” that teaching is part of their job. They will have to adopt for themselves a teacher’s ethic in which the greatest triumph is to be surpassed by one’s student. Losing the old power of closely held knowledge, they must learn to cherish the new power of those who spread knowledge. One manager Zuboff interviewed learned this lesson particularly well:
In this environment, the key to influence is not telling people what to do but in helping to shape the way they interpret the data. For example, in our unit, information is available to everyone, but I am the only one who can interpret it. I can either give them the result of my interpretations, or I can show them how to interpret it. If I choose the latter, I increase my influence.
The successful teacher-manager creates a new challenge for himself: leading men and women who have to a considerable extent become his peers. A company in which the vast majority of employees have become knowledge workers cannot be managed in the same way as a company of laborers. Organizing, even regimenting, the industrial work force was a great achievement in its day, making possible the assembly line, mass production and distribution, and fantastically productive economies of scale. But the work required of today’s workers depends too much on creativity, autonomy, and personal judgment to be successfully regimented.
Page 120
Obedience to instructions was a great virtue in the industrial laborer, but mere obedience, which is what the managers wanted in the unsuccessful mill, wastes and frustrates the potential of information technology. As Zuboff writes, in an information industry “internal commitment and motivation replace obedience….As the work that people do becomes more abstract, the need for positive motivation and internal commitment becomes all the more crucial.”[65] It is relatively easy to monitor whether a machine tender is working hard and well. Workers who work by thinking cannot be as easily monitored. They must be motivated, well taught, and engaged.
The fruits of this change will be tasted not only by the business organization but by the entire society and the sovereign state itself. A work force on the Information Standard will require more sophisticated corporate leadership; a nation composed largely of information workers will require the same. As more people become information users and fewer do jobs that can be comprehended by the military model of management, we must expect the rise of a work force that is better educated, more independent in judgement, more conscious of the value and bargaining power of its knowledge, and less willing to fit itself in to an aging power structure.
In the industrial age, work taught men to make themselves interchangeable parts in vast organizations not only in the factory but in the union, and even in the political organizations that claimed to represent the common interests of common men. Under the Information Standard men are likely to be less deferential to their former corporate sovereigns. But will a society of men and women who have learned that deference is due to knowledge rather than rank find it easy to defer to their sovereigns, the regulators and would-be regulators of trade and technology, capital and labor?
It seems more likely that the regulators, usually a few steps behind in comprehending the onrush of new technologies and new opportunities, will find themselves gradually surrendering power, not perhaps over the essentials of public health and safety but over the details of enterprise.
Page 121
A nation of knowledge workers seems likely to regard the generalists who inhabit our legislatures and administrative agencies in the same light as they would managers who tried to substitute rank for knowledge in running their shops.
The information corporation makes colleagues and citizens, not subalterns and subjects. In societies already free and democratic the fathers and grandfathers of these men fought to strengthen the power of government in the hope of checking the abuse of workers who had little leverage beyond that provided by numbers, courage, and good organization. But they themselves will fight to reduce government power over the corporations for which they work, organizations far more democratic, collegial, and tolerant than distant state bureaucracies inhabited by men and women who never seem to have enough knowledge to temper or justify their power. In the burgeoning number of societies only now tasting or preparing to taste freedom and democracy, the change will be even greater. The bureaucrats are even less informed and more powerful and destructive. Consequently, there is so much more to be gained by breaking their power, and much more exertion is necessary to achieve the goal.
This change in the internal power structure of the business corporation is not the only new challenge the corporation presents to the prerogatives of the sovereign state. The emerging business corporation not only transmits information more efficiently within the ranks but does a much better job capturing and capitalizing on information resources from all sources. Information technology makes the business environment far more competitive and unsettling, speeding up the “creative destruction” that Joseph Schumpeter identified as the essence of capitalism, doubling and redoubling the rewards of innovation or the prize for getting right information at the right time.
Sovereign governments, so often hostile to innovation, may try to frustrate such opportunistic organizations.
Page 122
But in the ruthless competition of an information economy, the successful corporation will become far more difficult for government to control.
The job that Poul Anderson’s Serendipity computer performed for its clients — sorting out opportunities from an overwhelming flow of information — is now the prime mission of every good corporate management. True, under the Information Standard, information remains a management tool, but is also great deal more. Information is the raw material of wealth and opportunity. New scientific discoveries and technical capabilities provide a wish list of ways to add value to matter. Within new demographic, sociological, marketing, and economic data are hidden endless ideas for products, services, and marketing strategies. The knowledge explosion is an explosion of opportunities.
But how do we turn wish list into reality? Today more than ever, having a business strategy means having an information strategy, a strategy for recognizing opportunities in the onrush of change, a strategy for transforming data flows that now look like a necessary evil into new products, services, and sources of profit, a strategy for ensuring that a company derives full value from the knowledge accumulated by its workers rather than allowing that knowledge to languish or leak away.
Consider computerized airline reservation systems. American Airlines’ Sabre system, by getting there first with the most enhancements, captured the lion’s share of travel agents’ computerized reservation business. But American went further. It built a data base of frequent flyers and used that information to develop not only marketing strategies, but the American Airlines Advantage program as well. Today every major airline has a similar frequent-flyer program. They are so common we forget that they are the by-product of hundreds of millions of dollars and many years of effort spent to build huge data bases that in the first instance served another purpose entirely.
The essence of an information strategy is to turn the burden of burgeoning business data into a bounty of business opportunity. The business organization has to be rebuilt around the goal of managing information productively. The object of the game is to get information to the person or company that needs and can use it in a timely way.
Ian Sharp has built a data base in Toronto containing information about every commercial airplane that took off in the United States during the past decade and a half. There are seventy pieces of data about each flight, ranging from time of takeoff and landing to number of passengers carried, yield per passenger, fuel consumed, and time and distance of flight. Sharp’s data base can provide a crucial advantage for an airplane manufacturer contemplating a new design. With Sharp’s data he can target specific routes, building planes of appropriate size, fuel economy, speed, maintenance requirements, etc. The estimations can make the difference between selling many planes or none. Knowing the market is what it is all about.
Over 90 percent of American goods now have a Universal Product Code, those familiar black stripes commonly known as a bar code. The checkout scanners that read those codes are creating a staggeringly informative, brand-new data base on what products are sold, in what volume, from what shelf, in what store, to what kinds of people. The long-term impact of this kind of data is still unclear, but we do know that as stores get a more detailed picture of their own customers, they are beginning to use more in-store advertising, “narrow-casting” their sales pitches to their prime audience rather than broadcasting to a less well understood audience through traditional media.
The banking business for generations depended on the loan officer’s knowing more about his customer’s needs and capabilities than other people did. This comparative advantage permitted the bank to lend money with a solid expectation that it would be paid back at maturity.
Page 124
But in the information economy, 10K reports became available on tape from the SEC (Securities and Exchange Commission), and Dow Jones, Reuters and the rest started keeping everyone up-to-date in real time. Software packages promising to make anyone into an expert financial analyst flooded the market.
In this environment the banks lost much of its comparative advantage. Soon the treasurer of General Electric knew as much about the credit of General Motors as did a bank lending officer. A new flow of information created a new market for commercial paper: corporations selling their unsecured notes directly to other corporations and bypassing the banks. Today the volume of commercial paper outstanding exceeds the total of commercial loans at all the New York banks put together.
As “copyrights” on business information break down, the manager will continue to shift away from procuring and carrying information to using it. New managers will be recruited for these new skills, but it is also important to reeducate older managers, who in a frantically innovative economy may “age” before their time. Today’s businesses do devote an enormous amount of time and energy to executive reeducation, sponsoring hordes of conferences and executive retreats to consider new possibilities and chew over common problems. Many companies also hold such conferences for customers so both sides can learn together how they can get the most from their relationships. Joint design efforts by customers and suppliers are becoming more common, shortening delivery time, preventing costly first-time mistakes, and lowering costs. These conferences not only absorb considerable effort and expense; they are tantamount to admitting that thinking is work, always a hard point for management to concede but crucial in today’s world.
We cannot, however, deal with the new opportunities of information simply by encouraging manager make-overs. The organizations people manage must be made over as well.
Page 125
Flattening organizations and squashing hierarchies simplify and shorten information pathways, making it easier for the right information to get to the right person at the right time.
As we have seen, information technology itself can flatten organizations and focus a company’s intellectual resources. The former chief scientist of IBM, Dr. Ralph E. Gomory, told me that when a software writer gets stuck for a solution to a problem he or she may “post” the problem on IBM’s electronic bulletin board, which can be accessed by thousands of IBM employees all over the globe. The bulletin board and often elicits an answer overnight from a fellow programmer thousands of miles away.
Many of our most innovative, fastest-growing companies tend to be “flat” by definition: they are small, and often built around a few key pieces of information. Most of the growth, new jobs, and new ideas in the American economy come from small, innovative firms — that is to say, from companies that have created new information. In such firms employees tend to understand and share the company’s goals, and information pathways are usually uncomplicated.
In the most advanced, high-tech sectors of the economy, this “entrepreneurial flattening” has been vindicated repeatedly. In microelectronics industry, new and profitable information is created at a stunning rate. Yet older and larger, firms (which in this sector can mean firms that have reached the ripe old age of fifteen or twenty years) have frequently been unable to capitalize on new technologies spawned in their own labs. The numerous Silicon Valley spin-off firms represent the sobering truth that the information pathway from the older company’s lab to the venture capitalist’s may be shorter and easier than the path to the company president’s ear.
More than ever it has become important to recognize opportunities early. Yet as business and government bureaucracies expand and age, they tend to develop a kind of administrative arthritis: They move more slowly and are less agile in response to market demands. Examples abound.
Page 126
The commercial banks should have invented the credit card, but they did not. Kodak, which is almost always at the forefront of technology, was a natural to produce the first instant camera, but it was Dr. Land of Polaroid who brought the idea to market. General Electric should have been the world leader in electronic computers, but it was IBM, without a single electronic engineer in 1945, that saw the opportunity and seized the lead. The list of good companies that turned down the Xerox process reads like a who’s who of American industry.
In each of these cases, companies with vast stores of expertise and information capital proved dull students of opportunity. The corporate graveyards of the world are littered with other companies with impressive, indeed intimidating “technology assessment” programs loaded with experts but cut off from the marketing people. Edison dismissed the phonograph he invented as an instrument of no commercial value.
Similarly, most of the management information systems (MIS) that exist today are too narrowly focused on the company itself. They are good for measuring a steady state of business, but fail to tell us what we need to know to prosper in rapidly changing markets. Jack Kilby, who, along with Robert Noyce, has been credited with inventing the integrated circuit, is quoted by T. R. Reid as saying:
“At first, the problem solver has to look things over with a wide-angle lens, hunting down every fact that might conceivably be related to some kind of solution. This involves extensive reading, including all the obvious technical literature but also a broad range of other publications — books, broadsides, newspapers, magazines, speeches, catalogues, whatever happens in view.”
In the same way, internal MIS systems must be integrated with external market data if they are to be really useful. One new tool that helps do this goes by the name of electronic data interchange (EDI).
Page 127
EDI ties business customers and suppliers electronically, automatically informing them about each other’s current needs, inventories, prices etc. Today about 70 percent of the Fortune 500 companies are using EDI both on the buy and sell side. It is estimated that in the wholesale drug industry customers transmit 95 percent of all their purchase orders to manufacturers via EDI. The major automobile manufacturers all use it, and IBM is seeking to connect two thousand of its largest suppliers. All of the information handled by EDI can be integrated with the manufacturing process to support highly efficient just-in-time inventory and production processes. Altogether such systems provide enormous data bases that must be integrated into our formal information systems (just as the value of such a valuable instrument of business must begin to be accounted for in our GNP).
The need for formal information systems, the need to flatten business organizations, the need to reeducate managers, all arise from the competitive imperatives of an information-rich, and therefore , economy. Nations that wish to flourish in such an economy will have to foster a climate of innovation. But allowing maximum freedom to innovate may upset traditional sovereign prerogatives. Many of the innovations of the information age, for instance, present significant challenges to seemingly long-settled law and custom. Is a computer terminal a branch of a bank? That is an important question for states in which sharp limitations on branch banking have been a cherished institution for generations. How do we protect intellectual property in the age of the Xerox machine, the VCR, and direct dialing to most places in the world? Who owns and assigns the radio frequencies of the world? How should the two hundred slots in the geosynchronous belt be allocated and by whom? International law and the laws of nations are being repeatedly challenged by onrushing technology.
Page 128
To the extent that U.S.the law fails to allow businesses to take full advantage of new information and new technologies, the United States will certainly lose some of its competitive edge.
Competition under the Information Standard will force companies to develop just those qualities that make them hard for governments to control. They will be international. They will be built to respond quickly to new opportunities. They will be well informed, more expert in their fields than their competitors or their regulators, and able to exploit new productive capabilities before regulatory bureaucracies can fully comprehend them. Because the bulk of their capital will be intellectual, they will be highly mobile, sensitive to their political and social environments, and always ready to shift operations to countries with more favorable climates. Indeed, as we shall see in the next chapter, the richest and most powerful nations in the world are already losing some of their traditional advantages in the global competition for information leadership.
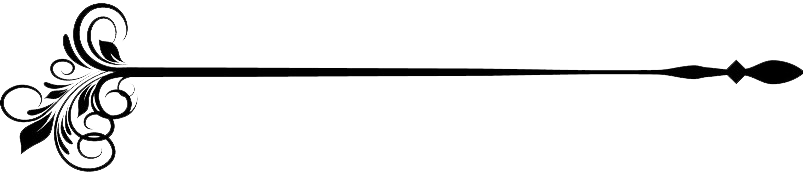
كتابُ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعْرَاق
تأليف الحكيم : بنُ مِسْكَوَيْه
مقدمةُ الكتاب والمقالةُ الأُولى منه.
بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرشد إلى الصراط المستقيم ومدح الخلق العظيم وأرسل نبيه محمد متمما لمكارم الأخلاق وأدَّبَهُ فأحسَنَ تأدِيبَهُ على الإطلاق.
الّلهُم إنا نتوجه إليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب الصراط المستقيم الذي نهَجْتَهُ لنا إلى مَرْضاتِك فأَعِنّا بقوتك واهدِنا بِعِزَّتِكَ واعصِمنا بقُدرتك وبلغنا الدرجة العليا برَحْمَتِكَ والسعادةَ القُصوى بجُودِكَ ورأفَتِكَ إنكَ على ما تشاء قدير.
قال أحمد بن محمد بن مسكويه:
غرضنا في هذا الكتاب أن نُحَصِّلَ لأنفسنا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقةَ ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي. والطريق في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا ماهي وأي شيء ولأي شيء أُوجدت فينا، أعني كمالها وغايتها وما قُواها وملكاتها التي إذا استُعملت على ما ينبغي بَلَغنا بها هذه الرتبة العَلِية وما الأشياء العائقة لنا عنها ومالذي يُزَكيها فتفلح ومالذي يُدَسِّيها فتخيب
ومتى كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تَهِيجُ في غير حينها ولا تحمى أكثر مما ينبغي لها حدثت منها فضيلة الحلم وتتبعها فضيلة الشجاعة ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وهي فضيلة العدالة. فلذلك أجمع الحكماء على أن أجناس الفضائل أربع وهي: الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. ولهذا لا يفتخر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط. فأما من افتخر بآبائه وأسلافه فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت صاحبها إلى غيره تَسَمَّى صاحبُها بها ومُدِح عليها وإذا اقتصرت على نفسه لم يُسَمَّ بها بل غيرت هذه الأسماء. أما الجود فإنه إذا لم يتعد صاحبه سمى صاحبه منفاقا. وأما الشجاعة فإن صاحبها يسمى آنفا. وأما العلم فإن صاحبه يسمى مستبصرا ثم إن صاحب الجود والشجاعة إذا عم غيره بفضيلتيه وتعدتاه رجى بإحداهما واحتشم وهيب بالأخرى. وذلك في الدنيا فقط لأنهما فضيلتان حيوانيتان. أما العلم إذا تعدى صاحبه فإنه يرجى ويحتشم في الدنيا والآخرة لأنه فضيلة إنسانية ملكية. وأضداد هذه الفضائل الأربع أربع أيضا وهي الجهل والشره والجبن والجور وتحت كل واحد منهذه الأجناس أنواع كثيرة سنذكر منها ما يمكن ذكره. فأما أشخاص الأنواع فهي بلا نهاية وهي أمراض نفسانية تحدث منها أمراض كثيرة كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق الشهواني وضروب من سوء الخُلُق وسنذكرها ونذكر علاجاتها فيما بعد إنشاء الله تعالى.
المقالة الأولى – أجناس الفضائل الاربعة
والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الأشياء أعني الأجناس الأربعة التي تحتوي على جمل الفضائل فنقول: أما الحكمة فهي فضيلة النفس الناطقة المميِزة وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي موجودة وإن شئت فقل أن تَعلمَ الأمور الإلهية والأمور الإنسانية ويثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أيها يجب ان يفعل وأيها يجب أن يغفل. واما العفة فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأيِ أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا ينقاد لها ويصير بذلك حرا غير متعبد لشيء من شهواته، وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسب إنقيادها للنفس الناطقة المميِزة واستعمال ما يوجبه الرأيُ في الأمور الهائلة أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلا والصبر عليها محمودا.
فأما العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث لها من إجتماع هذه الفضائل الثلاث التي عددناها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها للبعض وإستسلامها للقوة المميزة حتى لا تتغالب ولا تتحركَ لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها ويحدث للإنسان بها سِمَة يختار بها ابدا الإنصاف من نفسه أولا ثم الإنصاف والإنتصاف من غيره وله. وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا إذا ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الأربع إذ كان غرضنا في هذا الموضع الإشارة إليها بالرسوم الوجيزة ليتصورها المتعلم. والذي ينبغي الآن أن نتبع ما قدمنا بذكر أنواع هذه الأجناس وماتحت كل واحد منها فنقول {الأقسام التي تحت الحكمةِ هي: الذكاء. الذِّكْرُ. التعقل. سرعة الفهم وقوتهِ، صفاء الذهن، سهولة التعلم، وبهذه الأشياء يكون حسن الإستعداد للحكمة فأما الوقوف على جواهر هذه الأقسام فيكون من حدودها. وذلك أن العلم بالحدود يُفْهِمُ جواهرَ الأشياءِ المطلوبةِ الموجودةِ دائما على حال واحد وهو العلم البرهاني الذي لا يتغير ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه.
والفضائل التي هي بذاتها فضائل لا تكون في حال من الأحوال غير فضائل، فكذلك العلوم بها. أما الذكاء فهو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. أما الذكر فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الأمور. وأما التعقل فهو موافقة بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه. وأما صفاء الذهن فهو استعداد لما قد لزم من المقدم. وأما سهولة التعلم فهي قوة للنفس وحدة في الفهم بها تدرك الأمور النظرية.
الفضائل التي تحت العفة
الحياء. الدعة. الصبر. السخاء. الحرية. القناعة. الدماثة. الإنتظام. حسن الهدى. المسالمة. الوقار. الورع، أما الحياء فهو إنحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب الصادق. وأما الدعة فهي سكون النفس عند حركة الشهوات. وأما الصبر فهو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد لقبائح اللذات وأما السخاء فهو التوسط في الإعطاء وهو أن ينفق الأمور فيما ينبغي بعلىمقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي وتحت السخاء خاصة أنواع كثيرة نحصيها فيما بعد لكثرة الحاجة إليها.
وأما الحرية فهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطي في وجهه وتمنع من اكتسابه منغير وجهه. وأما القناعة فهي التساهل في المآكل والمشارب والزينة. وأما الدماثة فهي حسن إنقياد النفس لما يجمل وتسرعها إلى الجميل. وأما الإنتظام فهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور وترتيبها كما ينبغي. وأما حسن الهدي فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة. وأما المسألة فهي موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها. واما الوقار فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب وأما الورع فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس.
الفضائل التي تحت الشجاعة
كبر النفس. النجدة. عظم الهمة، الثبات. الصبر، الحلم. عدم الطيش، الشهامةُ، احتمال الكدِّ. والفرق بين الصبر والصبر الذي في العفة أنّ هذا يكون في الأمور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الهائجة. اما كبر النفس فهو الإستهانة باليسير والإقتدار على حمل الكرائه فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها. وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جَزَع. وأما عظم الهمة فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت. وأما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على إحتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة. وأما الحِلْمُ فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة.
وأما السكون الذي نعني به عدم الطيش فهو إما عند الخصومات وإما في الحروب التي يُذَبُّ بها عن الحريم أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس تقسر حركتها في هذه الأحوال لشدتها. وأما الشهامة فهي الحرص على الأعمال العظام توقعا للأحدوثة الجميلة. وأما احتمال الكد فهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة
الفضائل التي تحت السخاء
الكرم. الإيثار، النيل، المواساة. السماحة المسامحة. أما الكرم فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي وباقي شرائط السخاء التي ذكرناها. وأما الإيثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه. وأما النيل فهو سرور النفس بالأفعال العظام وإبتهاجها بلزوم هذه السيرة. وأما المواساة فهي معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وأما السماحة فهي بذل بعض ما لا يجبز وأما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب والجميع يكون بالإرادة والإختيار.
الفضائل التي تحت العدالة
الصدقة، الألفة. صلة الرحم. المكافأة. حُسْنُ الشركة. حسن القضاء، التودد. العبادة. ترك الحقد. مكافأة الشر بالخير. استعمال اللطف. ركوب المروءة في جميع الأحوال. ترك المعادات. ترك الحكاية عمن ليس بعدل مَرْضِي. البحث عن سيرة من يُحكي عنه العَدْل. ترك لفظة واحدة لا خير فيها مسلم فضلا عن حكاية توجب حدا او قذفا أو قتلا أو قطعا.ترك السكون إلى قول سفلة الناس وسقطهم. ترك قول من يكدي بين الناس ظاهرا باطنا أو يلحف في مسألة أو يلح بالسؤال فإن هؤلاء يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لأجله حسنا ويسخطهم إذا منعوا اليسير فيقولون لأجله قبيحا. ترك الشره في كسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لأجل العيال. الرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به أو لحظ يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقائه. ترك اليمين بالله وبشيء من أسماءه وصفاته رأسا. وليس بعدل من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين بها وأهل المعرفة الباطنة به وأهل المعرفة الباطنة به. وخير الناس خيرهم لأهله وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو والد أو قريب أو نسيب أو شريك أو جار أو صديق أو حبيب. ومن أحَبَّ المالَ حُبّا مُفْرِطا لم يؤهل لهذه المرتبة. فإن حرصه على جمع المال يصده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما يجب ويضطره إلى الخيانة والكذب والإختلاق والزور ومنع الواجب والإستقصاء وإستجلاب الدانق والحبة والذرة لبيع الدين والمروءة. وربما أنفق أموالا جمة محبة منه للمحمدة وحسن الثناء ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده. بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبة ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة. أما الصداقة فهي محبة صادقة يهتم معها بجميع أسباب الصديق وغيثار فعل الخيرات التي يمكن فعلها به. وأما الألفة فهي إتفاق الآراء والإعتقادات. وتَحْدُثُ عن التواصل فيُعتَقد معها التضافر على تدبير العيش.
وأما صلة الرحم فهي مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات التي تكون في الدنيا.
وأما المكافأة فهي مقابلة الإحسان بمثله أو بزيادة عليه. وأما حسن الشِّرْكة فهو الأخذ والإعطاء في المعاملات على الإعتدال الموافق للجميع. وأما حسن القضاء فهو مجازاة بعدل بغير ندم ولا مَنٍّ. وأما التودد فهو طلب مَوَداتِ الأكِفّاءُ وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالأعمال التي تستدعي المحبة منهم. وأما العبادة فهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته وإكرام أوليائه من الملائكة والأنبياء والأئمة والعمل بما توجبه الشريعة وتقوى الله تعالى تتم هذه الأشياء وتكملها، وإذ قد تقصينا الفضائل الأولى وأقسامها وذكرنا أنواعها وأجزاءها فقد عرفنا الرذائل التي تضاد الفضائل لأنه يفهم من كل واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها لأن العلم بالأضداد واحد.
ولما كانت هذه الفضائلُ أوساطا بين أطرافٍ وتلك الأطرافُ هي الرذائل وجب أن تفهم منها وأن اتسع لنا الزمان ذكرناها لأن وجود أسمائها في هذا الوقت متعذر وينبغي ان تفهم من قولنا أن كل فضيلة فهي وسطٌ بين رذائل ما أنا واصفه.
إنّ الأرضَ لما كانت في غاية البعد من السماء قيل إنها وسطٌ. وبالجملة المركز من الدائرة هو على غاية البعد من المحيط وإذا كان الشيء على غاية البعد من شيء آخر فهو من هذه الجهة على القُطرِ. فعلى هذا الوجه يبنغي أن يُفهَمَ معنى الوسط من الفضيلة إذا كانت بين رذائل بعدها منها أقصى البعد ولهذا إذا انحرنفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قَرُبت من رذيلة أخرى ولم تَسْلَم من العيب بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل إليها ولهذا صعب جدا وجود هذا الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب. لذلكَ قالت الحكماء إصابة نقطة الهدف أعسر من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطأها أعسر وأصعب. وذلك أن الأطراف التي تسمى رذائل من الأفعال والأحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة جدا. ولذلك كانت دواعي الشر أكثر من دواعي الخير ويجب أن تُطلَبَ أوساطُ تلك الأطراف بحسب كل فرد فرد. فأما ما يجب على المؤلف فهو أن يذكر جمل هذه الأوساط وقوانينها بحسب ما يليق بالصناعة لا على ما يجب على كل شخص فإن هذا غير ممكن فإن النجار والصائغ وجميع أرباب الصناعات إنما يحصل في نفوسهم قوانين وأصول فيعرف النجار صورة الباب والسريرِ، والصائغ صورة الخاتم والتاج على الإطلاق. فأما أشخاص ماقام في نفسه فإنما يستخرجها بتلك القوانين، ولا يُمكنه تَعرُّفُ الأشخاصِ لأنها بلا نهاية. وذلك أن كل باب وخاتم إنما يعمل بمقدار ما ينبغي وعلى قدر الحاجة وبحسب المادة.
والصناعة لا تضمن إلا معرفة الأصول فقط. وإذ قد ذكرنا معنى الوسط في الأخلاق وماينبغي أن يفهم منه فلنذكر هذه الأوساط لتفهم منها الأطراف التي هي رذائل وشرور فنقول وبالله التوفيق.
أما الحكمة فهي وسطٌ بينَ السفهِ والبله وأعني بالسفه ههنا إستعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكمالا ينبغي. وسماه القوم الجزيرة وأعني بالبَلَهَ تعطيلُ هذه القوة وإطراحها وليس بنبغي أن يفهم أن البَلَهَ ههنا نقصانُ الخِلقةِ بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرية بالإرادة. وأما الذكاء فهو وسط بين الخبث والبلادة فإن أحد طرفي كل وسط إفراط والآخر تفريط أعني الزيادة عليه والنقصان منه فالخبث والدهاء والحيل الرديئة هي كلها إلى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه. وأما البلادة والبله والعجز عنغدراك المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء. وأما الذكر فهو وسط بين النسيانِ الذي يكون بإهمال ما ينبغي أن يُحفظَ وبين العناية بما لا ينبغي أن يُحفظ. وأما التعقل – وهو حسن التصور – فهووسط بين الذهاب بالنظر في الشيء الموضوع إلى أكثر مما هو عليه وبين القصور وبالنظر فيه عما هو عليه. وأما سرعة الفهم فهي وسط بين إختطاف خيال الشيء من غير إحكام لفهمه. وبين الإبطاء عن فهم حقيقته. وأما صفاء الذهن فهو وسط بين ظلمة النَفْسِ عن إستخراج المطلوب وبين التهابٍ يُعرضُ فيها فيمنعُها من استخراج المطلوب وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بين الإفراط في التأمل لما لزم من المُقَدَّمِ حتى يخرج منه إلى غيره وبين التفريط فيه حتى يَقْصُرَ عنه.
وأما سهولة التعلم فهي وسط بين المبادرة إليه بسلاسة تثبت معها صورة العلم وبين التعصب عليه وتعذره.
وأما العفة فهي وسطٌ بين رذيلتين وهما الشَّرَهُ وخمودُ الشهوة. وأعني بالشَّرَهِ الإنهماك في اللذات والخروج فيها عما ينبغي وأعني بخمود الشهوة السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج إليها البدن في ضروراته وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل.
وأما الفضائل التي تحت العفة فإن الحياء وسط بين رذيلتين. إحداهما الوقاحة والأخرى الخرق. وأنت تقدر على أن تلحظ أطراف الفضائل الأخرى التي هي رذائل وربما وجدت لها أسماء بحسب اللغة وربما وجدت لها إسما وليس يَعسُرُ عليك فهم معانيها والسلوك فيها على السبيل التي سلكناها {وأما الشجاعة} فهي وسط بين رذيلتين إحداهما الجبن والأخرى التهور. أما الجبن فهو الخوف مما لا ينبغي ان يخاف منه. وأما التهور فهو الإقدام على ما لا ينبغي أن يُقدِمَ عليه وأما السخاء فهو وسط بين رذيلتين إحداهما السرف والتبذير والأخرى البخل والتقتير. أما التبذير فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق. وأما التقتير فهومنع ما ينبغي عمن يستحق {وأما العدالة} فهي وسط بين الظلم والإنظلام، أما الظلم فهو التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي كما لا ينبغي. وأما الإنظلام فهو الإستحذاء والإستماتة في المقتنيات لمن لا ينبغي وكما لا ينبغي. ولذلك يكون للجائر أموال كثيرة لأنه يتوصل إليها من حيث لا يجب ووجوه التوصل إليها كثيرة. وأما المنظلم فمقتنياته وأمواله يسيرة جدا لأنه يتركها من حيث لا يجب. وأما العادل فهو في الوسط لأنه يقتني الأموال من حيث يجب. ويتركها من حث لا يجب. فالعدالة فضيلة يُنصف بها الإنسان من نفسه ومن غيره من غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغيره أقل. وأما في الضار فبالعكس وهو أن لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب ما بين الأشياء ومن هذا المعنى اشتُق اسمه أعني العَدْلُ.
وأما الجائر فإنه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منها وأما في الأشياء الضارة فإنه يطلب لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها. فقد ذكرنا الأخلاق التي هي خيرات وفضائل وأطرافها التي هي شرور ورذائل على طريق الإيجاز وحددنا ما يحد منها ورسمنا ما يرسم وسنشرح كل واحد منها على سبيل الإستقصاء فيما بعد إن شاء اللهُ تعالى.
وينبغي أن نلخص في هذا الموضع شَكَّاٌ ربما لحق طالب هذه الفضائل فنقول: أنا قد بينا فيما تقدم أن الإنسان من بين جميع الحيوان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته. ولا بد له من معاونة قوم كثيرى العدد حتى يتمم به حياته طيبة ويجري أمره على السداد. ولهذا قال الحكماء أن الإنسان مدني بالطبع أي هو محتاج إلى مدينة فيها خَلْقٌ كثير لتتم له السعادة الإنسانية فكل بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره فهو لذلك مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم العِشرةَ الجميلةَ ومحبتهم المحبة الصادقة لأنهم يكملون ذاته ويتممون إنسانيته وهو أيا يفعل بهم مثل ذلك. فإذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الإنسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي ولا يتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره. فإذاً القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم إما بملازمة المغارات في الجبال وأما ببناء الصوامع في المفاوز. وأما بالسياحة في البلدان لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية التي عددنها. ذلك أن من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء ولا العدالة بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيه باطلة لأنها لا تتوجه لا إلى خير ولا إلى شر فإذا بطُلت ولم نظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم أعفَّاءٌ وليسوا بإعفَّاءَ وأنهم عُدول وليسوا بعُدول وكذلك في سائر الفضائل اعني أنه إذا لم يظهر منهم أضداد هذه التي هي شرور. ظن بهم الناس أنهم أفاضل وليست الفضائل إعداما بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الإجتماعات. ونحن إنما نعلم ونتعلم الفضائل الإنسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم لنصل منها وبها إلى سعادات أخَرْ إذا صرنا إلى حال أخرى. وتلك الحال غير موجودة لنا الآن.
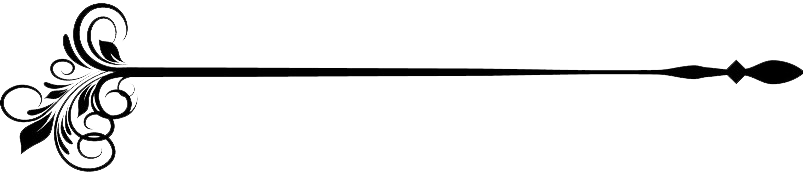
كتابُ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعْرَاق
تأليف الحكيم : بنُ مِسْكَوَيْه
نهائي
كتابُ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعْرَاق
تأليف الحكيم : بنُ مِسْكَوَيْه
.كتابُ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعْرَاق
.تأليف الحكيم بنُ مِسْكَوَيْه
،ِالمقالة الثانيةُ – في تعريف الخُلُق.
الخُلُقُ حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية.
وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب وكالإنسان الذي يجبُن من أيسر شيء، وكالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب، وربما كانَ مبدؤه بالرَويّةِ والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير مَلَكة وخُلقا.
ولهذا اختلف القدماء في الخُلُق، فقال بعضهم الخُلُق خاص بالنفس غير الناطقة وقال بعضهم قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ. ثم اختلف الناس أيضا اختلافا ثانيا فقال بعضهم من كانَ له خُلُق طبيعي لم ينتقل عنه وقال آخرون ليس شيء من الأخلاق طبيعيا للإنسان ولا نقول أنه غير طبيعيّ. وذلك أنّا مطبوعون على قبول الخُلُق بل ننتقل بالتأديب والمواعظ إما سريعا أو بطيئا. وهذا الرأي الأخير هو الذي نختاره، لأنَّا نُشاهده عيانا ولأن الرأى الأول يؤدي إلى أبطال قوة التمييز والعقل وإلى رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين وإلى ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جدا.
وأما الرواقيون فظنوا أنَّ الناس كلهم يُخْلَقُونَ أخيارا بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون أشرارا بمجالسة أهل الشر والميل إلى الشهوات الرديئة التي لا تُقمَعُ بالتأديب فينهمك فيها ثم يتوصل إليها من كل وجه ولا يفكر في الحسن منها والقبيح. وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء ظنُّوا أنّ الناس خُلِقوا من الطينة السفلى وهي كَدَر العالَم فهم لِأَجل ذلك أشرار بالطبع.
وإنما يصيرون أخيارا بالتأديب والتعليم، إلاّ أنّ فيهم من هو في غاية الشر لا يصلحه التأديب وفيهم من ليس في غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصِبا ثم بمجالسة الأخيار وأهل الفضل،
فأما جالينوس فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خّيِّرٌ بالطبع وفيهم من هو شِرّيرٌ بالطبع وفيهم من هو متوسط بين هذين. ثم أفسدُ المذهبين هما الأوَّلَينِ اللذينِ ذكرناهما، أمّا الأولُ فبِأنْ قالَ: إنْ كانَ كلُ الناسِ أخياراً بالطبعِ وإنما ينتقلون إلى الشر بالتعليم، فبالضرورةِ، إمّا أن يكونَ تَعَلُّمُهم الشُّرُورَ من أنفسهم وإمّا من غيرهم. فإنْ تعلموا من غيرهم فإنّ المعلِمينَ الذين علموهم الشَّرَّ أشرارٌ بالطبع. فليسَ الناسُ إذاً كُلُّهُم أخيارٌ بالطبع. وإن كانوا تَعَلَّموه من أنفسِهِم فإمَّا أن يكونَ فيهم قوةٌ يشتاقون بها إلى الشرِّ فقط، فهم إذاً أشرارٌ بالطبع.
وأما الرأيُ الثاني فإنه أفسَدَهُ بمثل هذه الحُجةَ. وذلكَ أنَّه قال: إنْ كان كلُّ الناسِ أشراراً بالطَبعِ فإمَّا أن يكونوا تَعَلّموا الخَيرَ من غيرهم أو من أنفسهم، ونعيدُ الكلامَ الأولَ بعينه، ولما أفسد هذين المذهبين، صحَّحَ رأيَ نَفْسِهِ من الأمورِ البيِّنَةِ الظاهرةِ. وذلكَ أنَّهُ ظاهرٌ جداً أنَّ من الناس من هو خيِّرٌ بالطبعِ وهم قليلون، وليسَ يَنْتقلُ هؤلاءِ إلى الشرِّ، ومنهم من هو شريرٌ بالطَّبعِ وهم كثيرون وليس ينتقل هؤلاء إلى الخير. ومنهم من هو متوسط بين هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم إلى الخير وقد ينتقلون بمقاربة أهل الشرِّ وإغوائهم إلى الشر.
وأما أرسطو طاليس فقد بيَّن في كتابِ الأخلاقِ وفي كتاب المقولات أيضا أنَّ الشِّرير قد يََنتقل بالتأديب إلى الخير. ولكن ليس على الإطلاق لأنه يرى أنَّ تكريرَ المواعظ والتأديبَ وأخذَ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لا بد أن يؤثِرَ ضروبَ التأثير في ضُرُوبِ الناسِ فمنهم من يقبلُ التأديبَ ويتحركُ إلى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاءٍ. ونحن نؤلف من ذلك قياسا وهو هذا: كلُّ خُلُقٍ يُمكن تَغَيُرُه . ولا شيء مما يمكن تَغَيُرُه هو بالطبع. فإذا لا خُلُقٌ ولا واحدٍ منه بالطبع. والمقدمتان صحيحتان والقياس مُنتج في الضرب الثاني من الشكل الأول.
أمّا تصحيحُ المقدمة الأولى. وهي أنّ كل خُلُق يُمكن تَغيُّره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بَيِّنٌ من العَيان ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثيره في الأحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسةُ الله لخَلقِهِ، وأمّا تصحيح المقدمة الثانية وهي أنَّه لا شَيءَ مما يُمكن تَغيُّره هو بالطبع، فهو ظاهرٌ أيضاً. وذلك أنا لا نَرُومُ تَغييرَ شَيءٍ مِمّا هو بالطبع أبداً. فإنَّ أيَّ أحدٍ لا يَرومُ أن يُغيِرَ حَركةَ النارِ التي إلى فوقٍ بأن يُعَودَها الحركةَ إلى أسفلٍ، ولا أنْ يُعَوِّدَ الحجرَ حركةَ العُلوِّ يَرومُ بذلكَ أن يُغيرَ حركةَ الطبيعة التي إلى أسفلَ.
ولو رامَهُ ما صحَّ له تغيير شَيءٍ من هذا ولا ما يَجري مَجراهُ أعني الأمورَ التي هي بالطبعِ فقد صَحَّت المُقدمتان وصحَّ التأليف في الشكل الأول وهو الضّربُ الثاني منه وصار برهانا.
فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي سميناها خُلُقا والمسارعةِ إلى تعلمها والحرصِ عليها فإنها كثيرةٌ وهي تُشاهدُ وتُعَايَنُ فيهم وخاصةً في الأطفالِ فإنَّ أخلاقَهم تَظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها برُويَّةٍ ولا فكرٍ كما يفعلهُ الرجل التامُّ الذي انتهى في نشوءه وكماله إلى حيث يَعرِفُ من نفسهِ ما يُستقبحُ منه فيُخِفيهُ بضُرُوبٍ من الحِيَلِ والأفعالِ المضادة لما في طبعه: وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه أو ما يظهر في بعضهم من القحة وفي بعضهم من الحياء، وكذلك ما تَرَى فيهم من الجُودِ والبخل والرخمة والقسوة والحسد وضدهِ، ومن الأحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة، وتَعلمُ معه أنّهم ليسوا على رتبة واحدة وأن فيهم المتواني والممتنع والسهل السلس والفظ العسر والخيّرَ والشريرَ. والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرةً، وإذا أُهمِلت الطباعُ ولم ترضَ بالتأديبِ والتقويمِ نشأ كلُّ إنسان على رسوم طباعه وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في الطفولية وتبع ما وافقه في الطبع، إمّا الغضبَ وإمّا اللذةَ وإمّا الزعارةَ وإمّا الشرهَ وإمّا غير ذلك من الطباع المذمومة.
.فصل في الشريعة.
والشريعةُ هي التي تُقوِّمُ الأحداثَ وتُعوِّدُهم الأفعالَ المَرْضية وتُعِدُّ نُفوسَهم لقَبول الحكمةِ وطلبِ الفضائل والبلوغِ إلى السعادة الإنسية بالفِكرِ الصحيح والقياس المستقيم، وعلى الوالدين أخذُهُم بها وسائرِ الآدابِ الجميلةِ بضُروبِ السياسات من الضرب إذا دعت إليه الحاجة أو التوبيخات إن صدّتْهُم عن فعلهم الاعْوَجِ، أو إطماعِهم في الكرامات أو غيرها مما يميلون إليه من الراحات أو يَحْذَرُونَه من العقوبات. حتى إذا تعودوا ذلك واستمروا عليه مدة من الزمانِ كثيرةٍ، أمكنَ فيهم حينئذ أن يعلموا برهين ما أخذوه تقليدا، ويُنَبّهوا على طرق الفضائل وإكتسابها والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحن بصددها.
ُ.ومنه سبحانه وتعالى التوفِيق.
وللإنسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها أولا فأولا إلى الكمال الأخير طريق طبيعي يتشبه فيها بفعل الطبيعة. وهو أن ينظر إلى هذه القوى التي تحدث فينا أيها أسبق إلينا وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بَيِّنٌ ظاهرٌ. وذللك أن أول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال يختص بشيء ثم شيء يتميز به عن نوع ثم نوع إلى أن يصير إلى الإنسانية. فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا إلى الغضب ومحبة الكرامة فنُقَوّمُهُ، ثم بآخره وهو الشوق الذي يحصل فينا إلى المعارف والعلوم فنُقَوّمُه. وهذا الترتيب الذي قلنا أنه طبيعي إنما حَكمنا فيه لما يظهر فينا منذ أول نشونا أعني أن نكون أولا أجنة ثم أطفالا ثم أناسا كاملين وتحدث فينا هذه القوى مرتبة. فأما أن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الأخلاق التي تعني بتجويد أفعال الإنسان بحسب ما هو إنسان فيتبين مما أقول.
.فصل في الإنسان.
ولما كانَ للجوهر الإنساني فِعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم كما بيناه فيما تقدم، وكان الإنسان أشرف موجودات عالمنا، ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره، وشبهناه بالفَرَسِ الذي إذا لم تصدر عنه أفعال الفَرَسِ على التمام أُستُعملَ مكانَ الحمار بلا كَلفٍ، وكان وجوده أروحُ له من عَدمه، وجبَ أن تكون الصناعةُ التي تُعْنَى بتجويد أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ورفعه عن رُتبة الأخَسِّ التي يستحق بها المقتَ من الله والقرار في العذاب الأليم.
.فصل في أشرف الصناعات كلها وأكرمها.
وأما سائر الصناعات الأخر فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جدا من تصفح الصناعات لأن فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميتة وفيها صناعة الطب والعلاج التي تهتم باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة، وهكذا الهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها إلى العلوم الدنيئة وبعضها إلى العلوم الشريفة. وإذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان. أما في الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات إذا قيس إلى جوهر الإنسان. وإما في جوهر الموجودات الآخر فظاهر لمن أراد أن يحصيها. فالصناعة والهمة التي تصرف إلى أشرفها أشرف من الصناعة والهمة التي تصرف إلى الأدون منها.
ويجب أن يُعلم انّ اسم الإنسان وإن كان يقع على أفضلهم وعلى أدوَنِهم، فإنّ بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ليس شيء خيرا من إلفٍ مثله الإنسان ” وقال: عليه الصلاة والسلام ” الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة ” وقال: ” الناس كأسنان المشط”، وكان العرب يقولون كأسنان الحمار وإنما يتفاضلون بالعقل. ولا خير في صحبة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له ”
وفي نظائر هذه أشياءُ كثيرة تدل على هذا المعنى، وأنّ الشاعر الذي قال: (ولَم أرَ أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عُدَّ ألف بواحد) وإنْ كان عنده أنه قد بالغ فإنه قد قَصَّر. وفي الخَبَرِ عن النبي عليه الصلاة والسلام ” إني وُزنت بأمتي فرَجَحتُ بهم ” أصدقُ وأوضح. وليس هذا في الإنسان وحده بل في كثير من الجواهر الأُخَر. وإن كان في الإنسان أكثر وأشد تفاوتا فإن بين السيف المعروف بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتا عظيما. وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفَرَسِ الكريم وبين البرذون المقرف، فمن أمكنه أن يرقى بالصناعة من دون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها فأشرفُ به وبصناعته ما أكرمه وأكرمها. فأما الإنسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الإستعدادات لضروب من المقامات. وليس ينبغي أن يكون الطمع في إستصلاحه على مرتبة واحدة وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه.
إلا أنَّ الذي ينبغي أن يُعلم الآن أن وجود الجوهر الإنساني مُتعلق بقدرة فاعله وخالقه تبارك وتقدس إسمُهُ وتعالى. فأمّا تجويد جوهره فمفوض إلى الإنسان وهو معلق بإرادته. فاعرف هذه الجملة إلى أن تلخص في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب أن قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ما هي ولأي شيء هي. ثم قنا إن لكل جوهر موجود كمالا خاصا به وفعلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء
وقد بينا ذلك في غاية البيان في الرسالة المُسعِدة. وإذا كانَ ذلك محفوظا فنحن مضطرون إلى أن نعرف الكمال الخاص بالإنسان والفعل الذي لا يشاركه فيه غيرهُ من حيثُ هو إنسان، لنحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد في البلوغ إلى غايته ونهايته. ولما كان الإنسان مركبا لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به كمال بسائطه وأفعالها الخاصة بها وإلا كان وجود المركب باطلا كالحال في الخاتم والسرير. فإذا له فعل خاص به من حيث هو مركب وإنسان لا يشاركه فيه شيء من الموجودات الأخر. فأفضل الناس أقدرهم على إظهار فعله الخاصِّ والزمُهم له من غير تلون فيه ولا إخلال به في وقت دون وقت. وإذا عُرِفَ الأفضل فقد عُرِفَ الأنقص على إعتبار الضد، فالكمال الخاص بالإنسان كمالان وذلك أن له قوتين إحداهما العالمة والأخرى العاملة فلذلك يشتاق بإحدى القوتين إلى المعارف والعلوم وبالأخرى إلى نظم الأمور وترتيبها وهذان الكمالان هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا.
.فصل في الفلسفة.
تنقسم الفلسفة إلى قسمين، إلى الجزء النظري والجزء العملي، فإذا كَمُلَ الإنسان بالجزء العملي والجزء النظري فقد سّعُدَ السعادة التامة، أما كماله الأول بإحدى قوتيه أعني العالمة وهي التي يشتاق بها إلى العلوم فهو أن يصير في العلم بحيث يَصْدُقُ نظرُهُ وتَصِحَّ بصيرتُه وتستقيم رويته فلا يَغلطَ في إعتقاد ولا يشكَّ في حقيقةٍ، وينتهي في العلم بأمور الموجودات على الترتيب إلى العلم الإلهي، الذي هو آخر مرتبة العلوم، ويَثقَ به ويسكن إليه ويطمئِنَّ قلبه، وتذهب حيرته وينجلي له المطلوب الأخير، حتى يتحد به. وهذا الكمال قد بينا بالقوة الأخرى أعني القوة العاملة فهو الذي نقصده في كتابنا هذا وهو الكمال الخلقي ومبدؤه من ترتيب قواه وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتغالب وحتى تتسالم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهي إلي التدبير المدني الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس حتى تنتظم ذلك الإنتظام ويسعدوا سعادة مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد.
فإذا الكمال الأول النظري منزلته منزلة الصورة والكمال الثاني العملي منزلته منزلة المادة وليس يتم أحدهما إلا بالآخر لأنَّ العلم مبدأ والعمل تمام والمبدأ بلا تمام يكون ضائعا والتمام بلا مبدأ يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذي سميناه غرضا.
وذلك أن الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد وإنما يختلفان بالإضافة فإذا نظر إليه وهو بعدُ في النفس ولم يخرج إلي الفعل فهو غَرَضٌ، فإذا خرج إلي الفعل وتم فهو كمال. وكذلك الحال في كل شيء لأن البيت إذا كان متصورا للباني وكان عالما بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضا. فإذا أخرجه إلي كماله ويصدر عنه فعله الخاص به إذا علم الموجودات كلها أي يعلم كلياتها وحدودها التي هي ذواتها لا أعراضها وخواصها التي تصيرها بلا نهاية.
فإنك إذا علمت كليات الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو مالان الجزئيات لاتخرج عن كلياتها فإذا كملت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم ورتب القوى والمَلَكَاتِ التي فيك ترتيبا عِلميا كما سبق علمك به. فإذا انتهيت إلى هذه الرتب فقد صرت عالما وحك واستحقيت أن تسمى عالما صغيرا لأن صور الموجودات كلها قد حصلت في ذاتك فصرت أنت هي بنحو ما. ثم نظمتها بأفعالك على نحو استطاعتك فصرت فيها خليفة لمولاك خالق الكل جلت عظمته فلم تخط فيها ولم تخرج عن نظامه الأول الحِكميُ فتصير حينئذ عالما تاما.
والتام من الموجودات هو الدائم الوجود، والدائم الوجود هو الباقي بقاء سرمديا فلا يفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم لأنك بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائما أبدا وقد قربت منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب. وهذه هي الرتبة العليا والسعادة القصوى. ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس يمكنه تحصيل هذه المنزلة في ذاته وتكميل صورته بها وإتمام نقصانه بالترقي إليها لكان سبيلهُ سبيلَ أشخاصِ الحيوانات الأُخَرِ، أو كسبيلَ أشخاصِ النباتِ في مصيرها إلى الفناء والإستحالة التي تلحقها والنقصانات التي لا سبيل إلى تمامها. ولإستحال فيه البقاء الأبدي والنعيم السرمدي والمصير إلى ربه ودخول جنته. ومن لا يتصور هذه الحالة ولا ينتهي إلى علمها من المتوسطين في العلم يقع له شكوك. فيظن أن الإنسان إذا انتقض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى كالحال في الحيوانات الأخر وفي النبات فحينئذ يستحق إسم الإلحاد ويخرج عن سمة الحكمة وسنة الشريعة.
فصل في كمال الإنسان.
وقد ظن قوم أنَّ كمال الإنسان وغايته هما في اللذات وإنها هي الخير المطلوب والسعادة القصوى. وظنوا أنَّ جميع قواهُ الاُخرى إنّما ركبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها. وأن النفس الشريفة التي سميناها ناطقة إنما وهبت له ليرتب بها الأفعال ويميزها ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة هي حصولها له على النهاية والغاية الجسمانية. وظنوا أيضا أن قوى النفس الناطقة أعني الذكر والحفظ والروية كلها تراد لتلك الغاية. قالوا وذلك أن الإنسان إذا تذكر اللذات التي كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح اشتاق إليها وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ إنما هي اللذّاتُ وتحصيلُها. ولأجل هذه الظنون التي وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة كالعبد المهين وكالأجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المآكل والمشارب والمناكح وترتبها لها وتعدها إعدادا كاملا موافقا. وهذا هو رأي الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط.
وإلى هذه الخيرات التي جعلوها غاياتهم تشوقوا عند ذكر الجنة والقرب من بارئهم سُبحانَهُ وتعالى. وهي التي يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم. وإذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فإنما ذاك منهم على سبيل المتجر والمرابحة في هذه بعينها. كأنهم تركوا قليلها ليصلوا إلى كثيرها وأعرضوا عن الفانيات منها ليبلغوا إلى الباقيات. إلا انك تجدهم مع هذا الإعتقاد وهذه الأفعال إذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الأعلى الأشرف وما نزههم الله عنه من هذه القاذورات علموا بالجملة أنهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى رتبةً من الناس وأنّهم غير محتاجين إلى شيء من حاجات البشر بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل شيء الذي تولى إبداع الكل هو منزه عن هذه الأشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من إيجادها.
وإن الناس يشاركون في هذه اللذات الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان. وإنما يناسبون الملائكة بالعقل والتمييز ثم يجمعون بين هذا الإعتقاد والإعتقاد الأول. وهذا هو العجب العجيب. وذلك أنهم يرون عيانا ضروراتهم بالأذى الذي يلحقهم بالجوع والعرى وضروب النقص وحاجاتهم إلى مداواتها بما يدفعها عنهم. فإذا زالت آثارها وعادوا إلى حال السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا للراحة لذة. ولا يشعرون أنهم إذا اشتاقوا إلى لذة المَأكلِ فقد اشتاقوا أولا إلى ألم الجوع. وذلك أنهم إن لم يُؤلَموا بالجوع لم يلتذوا بالأكل. وهكذا الحال في سائر اللذات الأخر. إلا أن هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض. وسنتكلم على أن صورة الجميع واحدة وأن اللذات كلها إنما تحصل للملتذ بعد آلام تلحقه. لأن اللذة هي راحة من ألم وأن كل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم أو أذى في غير هذا الموضع.
وسيظهر عند ذلك أنَّ من رضي لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غايتَهُ وأقصى سعادته فقد رضيّ بأخس العبودية لأخص الموالي. لأنه يصير نفسه الكريمة التي يناسب بها الملائكة عبدا للنفس الدنيئة التي يناسب بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال.
وقد تعجب جالينوس في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من هذا الرأي وكثر استجهالُه للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل. إلا أنه قال أنَّ هؤلاء الخبثاء الذين سيرتهم أسوأ السير وأردأُها إذا وجدوا إنسانا هذا رأيه ومذهبه نصروه ونوهوا به ودعوا إليه ليوهموا بذلك أنهم غير منفردين بهذه الطريقة لأنهم يظنون أنهم متى وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ما هم عليه كان ذلك عذرا لهم وتمويها على قوم آخرين في مثل طريقتهم. وهؤلاء هم الذين يفسدون الأحداث بإيهامهم أن الفضيلة هي ما تدعوهم إليه طبيعة البدن من الملاذ.
وأن تلك الفضائل الأخر الملكية إما أن تكون باطلة ليست بشيء ألبتة وإما أن تكون غير ممكنة لأحد من الناس: والناس مائلون بالطبع الجسداني إلى الشهوات فيكثر اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم. وإذا تنبه الواحد بعد الواحد منهم إلى أنَّ هذه اللذات إنما هي لضرورة الجسد وأنَّ بدنه مركب من الطبائع المتضادة أعني الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وأنه إنما يعالج بالمأكل والمشرب أمراضا تحدث به عند الإنحلال لحفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه. وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من الألم ليست بغاية مطلوبة ولا خير محض. وأنَّ السعيد التام هومن لا يعرض له مرض البتة. وعرف مع ذلك أيضا أن الملائكة الأبرار الذين اصطفاهم الله بقربه لا تلحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون إلى مداواتها بالأكل والشرب.
وأن اللهَ تعالى منزه متعال عن هذه الأوصاف – عارضوه بأن بعض البشر أشرف من الملائكة وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق. وشاغبوهُ وسفهوا رأيه وأوقعوا له شبها باطلة حتى يُشككوا في صحة ما تنبه إليه وأرشدَه عقله إليه.
والعجب الذي لا ينقضي هو أنهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقتهم التي يميلون إليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على ما أنبتت الأرض عظموه وكثر تعجبهم منه وأهلوه للمراتب العظيمة. وزعموا انه ولي الله وصفيه وأنه شبيه بالملك وأنه أرفع طبقة من البشر. ويخضعون له ويذِلون غاية الذل ويعدون أنفسهم أشقياء بالإضافة إليه.
والسبب في ذلك هو انهم وإن كانوا من أفن الرأي وسفاهته على ما ترى فإن فيهممن تلك القوة الأخرى الكريمة المميزة وإن كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي الفضائل فيضطرون إلى إكرامهم وتعظيمهم.
.فصل في قُوى النفس الثلاثة
وإذا كانت القوى ثلاثا كما قلنا مرارا فأدْوَنُها النفس البهيمية. وأوسطها النفس السبعية. وأشرفُها النفسُ الناطقة. َوالإنسان إنما صار إنسانا بأفضل هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها بايَنَ البهائم.
فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه إليها أتم وأوفر. ومن غلبت عليه إحدى النفسين الأخريين انحط عن مرتبة الإنسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه. فانظر رحمك الله أين تضع نفسك وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات. فإن هذا أمر موكول إليك ومردود إلى اختيارك.
فإن شئتَ فانزِل في منازلِ البهائم فإنك تكون منهم. وإن شئتَ فانزِل في منازل السباع. وإن شئت فانزِل في منازل الملائكة وكن منهم. وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة فإن بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب، لأن الفرس إنما شرف على الحمار لقبوله الأدبَ، وكذلك في البازي فضيلة على الغراب. وإذا تأملتَ الحيوانَ كله وجدت القابل للتأديب الذي هو أثرُ النطقِ أعني النفسَ الناطقة أفضلُ من سائره، وهو يتدرج في ذلك إلى ان يصير إلى الحيوان الذي هو في أفق الإنسان أعني الذي هو أكمل البهائم وهو في أخس مرتبة الإنسانية.
وذلك أن أخس الناس هو من كان قليل العقل قريبا من البهيمية. وهم القوم الذين في أقاصي الأرض المعمورة وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا ينفصلون عن القرود إلا بشيء قليل من التمييز. وبذلك القدر يستحقون إسم الإنسانية. ثم يتميزون ويتزايدون في هذا المعنى حتى يبلغوا إلى وسط الأقاليم، ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل فيصير فيهم العاقل التام والمميز العالم. ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا إلى أن يصيروا إلى غاية ما يمكن للإنسان أن يبلغ إليه من قبول قوة العقل والنطق. فيصير حينئذ في الأفق الذي بين الإنسان والمَلَكُ ويصير فيهم القابل للوحي
والمُطيق ُلحمل الحكمة تفيضُ عليه قوة العقل، ويَسِيحُ إليه نورُ الحق، ولا حالة للإنسان أعلى من هذه ما دام إنسانا.
ثم ارجع القهقريَ إلى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدوَنُ مراتبِ الإنسان، فإنك تجدُ القومَ الذين تضعف فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذي ذكرنا أنهم في أفق البهائم تقوى فيهم النفس البهيمية فيميلون إلى شهواتها المأخوذة بالحواس كالمأكول والمشروب والملبوس وسائر النزوات الشبيهة بها. وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمية حتى يرتكبونها ولا يرتدعوا عنها. وبقدر ما يكون فيهم من القوى العاقلة يستَحْيُونَ منها حتى انهم يستتروا بالبيوت ويتواروا بالظلمات إذا هموا بلذة تخصهم.
وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها، فإنَّ الجميل بالإطلاق هو الذي يُتَظاهَرُ به ويُستحب إخراجه وإذاعته. وهذا القُبح ليس بشيء أكثر من النقصانات اللازمة للبشر. وهي التي يشتاقون إلى إزالتها. وافحشها هو انقصها. و انقصها أحوجها إلى الستر والدفن. ولو سألت القوم الذين يعظمون أمر اللذة ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الإنسانية لم تكتمون الوصول إلى أعظم الخيرات عندكم. وما بالكم تعدون موافقتها خيرا ثم تسترونها؟ أترون سَِتْرَها وكتمانها فضيلة ومروءة وإنسانية والمجاهرة بها وإظهارِها بين أهل الفضل وفي مجمع الناس خساساة وقحة؟ – لظهر من انقطاعهم وتبلدهم في الجواب ما تعلم به سوء مذهبهم وخبثَ سيرتهم. وأقلهم حظَّا من الإنسانية إذا رأى إنسانا فاضلا احتشمه ووقره وأحب أن يكون مثله إلا الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع ونزارة الإنسانية ووقاحة الوجه إلى أن يقيم على نصرة ما هو عليه من غير محبة لرتبة من أفضل منه.
الواجب على العاقل
فإذاً يجبُ على العاقل أن يعرف ما ابتُلِيَ به الإنسانُ من هذه النقائص التي في جسمه وحاجاته الضرورية إلى إزالتها وتكميلها، أما بالغذاء الذي يحفظ به إعتدال مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله. ولا يطلب اللذة لعينها بل قوام الحياة التي تتبعه اللذة. فإن تجاوز ذلك قليلا فبقدر ما يحفظ رتبته في مروءته. ولا ينسب إلى الدناءة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين الناس، وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحرِّ والبردِ ويسترَ العورةَ. فإن تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحقر ولا ينسب إلى الشح على نفسه وإلى أن يسقط بين أقرانه وأهل طبقته، وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته، أعني طلب النسل فإن تجاوز ذلك فبقدر مالا يخرج به عن السنة ولا يتعدى ما يملكه إلى ما يملك غيره ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار إنسانا، وينظر إلى النقائص التي في هذه النفس خاصة فيروم تكميلها بطاقته وجهده.
فإن هذه الخيرات هي التي لا تُستَرُ وإذا وصل إليها لا يُمنع عنها بالحياءِ ولا يُتوارى عنها بالحيطانِ والظلماتِ، ويُتَظاهرُ بها أبدا بين الناس وفي المحافل. وهي التي يكون بها بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر إنسانية من بعض ويغذوا هذه النفس بغذائها الموافق لها المتم لنقصانها كما يغذو تلك بأغذيتها الملائمة لها. فإن غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات والإرتياض بالصدق في الآراء وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء. فمن اتفق له في الصبا أن يربي على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعودها ثم ينظر بعد ذلك في كتب الأخلاق حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين.
ثم ينظر في الحساب والهندسة حتى يتعود صدقَ القول وصحةَ البرهان فلا يسكن إلا إليها، ثم يتدرج (كما رَسَمنَاهُ في كتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم) حتى يَبلغَ إلى أقصى مرتبة الإنسان فهو السعيد الكامل فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنة الجسيمة. ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوه ثم ابتُليَ بأن يربيه والدهُ على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسانَ ما يوجدُ فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد في شعر أُمرُىء القيس والنابغةُ وأشباههما ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء يقرونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية.
وامتُحِنَ بأقران يساعدونه على تناول اللذات الجسمانية. ومال طبعه إلى الإستكثار من المطاعم والملابس والمراكب والزينة وإرتباط الخيرِ الفارِهَ والعيشِ الرائقِ (كما اتفق لي مثل ذلك في بعض الأوقات)، ثم انهمَكَ فيها واشتغل بها عن السعادةِ التي أُهِّلَ لها – فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيما وخسرانا لا ربحا وليجتهد على التدريج إلى فطام نفسه منها. وما أصعب إلا أنه على كل حال غير من التمادي في الباطل. وليعلم الناظر في هذا الكتاب إن خاصة تدرجت إلى فطام نفسي بعد الكبر واستحكام العادة وجاهدتها جهادا عظيما.
ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالب للأدب الحقيقي بما رضيت لنفسي بل تجاوزت لك في النصيحة إلى أن أشرت عليك بما فاتني في ابتداء أمري لتدركه أنت. ودَلَلْتُك على طريق النجاة قبل أن تتيه في مفاوز الضلالة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحر المهالك. فالله الله في نفوسكم معاشر الإخوان والأولاد. إستسلموا للحق وتأدبوا بالأدب الحقيقي لا المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا الصراط المستقيم وتصوروا حالات أنفسكم وتذكروا قواها. واعلموا أنَّ أصح مَثَل ضُرب لكُم من نفوسكم الثلاث التي مر ذكرها في المقالة الأولى: مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جمعت في مكان واحد مَلِكٌ وسَبُعٌ وخنزير. فأيها غلب بقوته قوة البالقين كان الحكم له. وليعلم من تصور هذا المثال أن النفس لما كانت جوهرا غير جسم ولا شيء فيها من قوى الجسم وأعراضه كما بينا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها واتصالها بخلاف اتحاد الأجسام وإتصال بعضها ببعض.
والنفوسُ ثلاث، ولكنْ هذه الأنفسُ الثلاثُ إذا اتصلت صارت شيئا واحدا ومع أنها تكون شيئا واحدا فهي باقية التغاير وباقية القوى تثور الواحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تصل بالأخرى ولم تتحد بها وتستجدي أيضا الواحدة للأخرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها تنفرد بها. وذلك أن إتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلقى سطوحها كما يكون ذلك في الأجسام. بل تصير في بعض الأحوال شيئا واحدا وفي بعض الأحوال أشياء مختلفة بحسب ما تَهِيْجُ قوةُ بعضِها أو تَسُكن. ولذلك قال قوم أن النفس واحدة ولها قوى كثيرة. وقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثيرة بالعرض وبالموضوع.
وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب وسيمر بك في موضعه.
وليس يضرك في هذا الوقت أن تعتقد أي هذه الآراء شئت بعد أن تعلم أن بعض هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة عادمة للأدب بالطبع. وليس فيها استعداد لقبول الأدب وبعضها عادمة للأدب. إلا انها تَقْبَلُ التأدب وتنقاد للتي هي أدبية. أما الكريمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة. وأما العادمة للأدب وهي مع ذلك غير قابلة له فيه النفس البهيمية وأما التي عدمت الأدب ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية وإنما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تَقْبَلُ الأدب. وقد شبه القدماء الإنسان وحاله في هذه الأنفس الثلاث بإنسان راكب دابة قوية أو يقود كلبا أو فهدا للقنص.
فإن كان الإنسان من بينهم هو الذي يرُوضُ دابته وكلبَه يُصَرفُهُما ويُطيعانه في سَيْرِهِ وتَصَيُّدِهِ وسائرِ تصرفاته، فلا شكَّ في رَغَدِ العيشِ المشترك بين الثلاث وحسن أحواله. لأن الإنسان يكون مُرَفَّها في مطالبه، يجري فرسُه حيث يحب وكما يحب ويُطلِقُ كلبه أيضا كذلك. فإذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن القيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية الأعداء وغير ذلك من مصالحهما. وإذا كانت البهيمية هي الغالبة ساءت حال الثلاثة وكان الإنسان مضعوفا عندهما فلم تطع فارسها وغلبت. فإن رأت عشبا من بعيد عدت نحوه وتعسفت في عدوها وعدلت عن الطريق النهج فاعترضتها الأودية والوهاد والشوك والشجر فتقحمتها وتورطت فيها ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه الأحوال فيصيبهم جميعا من أنواع المكاره والإشراف على الهلكة ما لا خفاءَ فيه.
وكذلك إن قَوِيَ الكلبُ لم يُطع صاحبَه، فإن رأى من بعيد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ نحوه فجذب الفارس وفرسه ولحق الجميع من الضرر والضر أضعاف ما ذكرناه. وفي تصور هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للإنسان ومكّنه منه وعرضه له وما يضيعه بعصيان خالقه تعالى فيه عند إهمال السياسة واتباعه أمر هاتين القوتين وتعوُّده لهما، وهما اللذان ينبغي أن يتبعاه بتأمره عليهما. فمن اسوأ حالا ممن اهمل سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه ترك هذه القوى فيه هائجة مضطربة تتغلب.
وصار الرئيس منها مرؤوسا والمَلِكُ منها مستعبدا يتقلب معها في المهالك حتى تتمزق ويتمزق معها هو أيضا. نعوذ بالله من الإنتكاس في الخُلُقِ الذي سبَّبَهُ طاعة الشيطان واتباع الأبالسة، فليست الإشارة بها إلى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها. نسأل الله عصمته ومعونته على تهذيب هذه النفوس حتى ننتهي فيها إلى طاعة الله التي هي نهاية مصالحنا وبها نجاتنا وخلاصنا إلى الفوزالأكبر والنعيم السرمدي.
سياسة النفس العاقلة
وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة وترك سلطان الشهوة يستولي عليها، برجل معه ياقوتة حمراء شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة. وكان بين يديه نار تضطرم فرماها في حباحبها حتى صارت كأسَا لا منفعة فيها فخسرت وضاعت منافِعُها. فقد علمنا الآن أن النفس العاقلة إذا عرفت شرف نفسها وأحست بمرتبتها من الله عزوجل أحسنت خلافته في تربية هذه القوى وسياستها ونهضت بالقوة التي أعطاها الله تعالى إلى محلها من كرامة الله تعالى ومنزلتها من العلو والشرف ولم تخضع للسبعية ولا للبهيمية.
بل تقوم النفس الغضبية التي سميناها سَبُعِيَة ونقودها إلى الأدب بحملها على حسن طاعتها. ثم تستنهضها في أوقات هيجان هذه النفس البهيمية وحركتها إلى الشهوات حتى يقمع بهذه سلطان تلك، وتستخدمها في تأديبها وتستعين بقوة هذه على عصيان تلك. وذلك أن هذه النفس الغضبية قابلة للأدب قوية على قمع الأخرى كما اشرنا. وتلك النفس البهيمية عادمة للأدب غير قابلة له. وأما النفس الناطقة أعني العاقلة فهي كمال قال أفلاطون بهذه الألفاظ: أما هذه فبمنزلة الذهب في اللين والإنعطاف.
وأما تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة والإمتناع فإن أنت آثرت الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوة الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما ىثرت الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوى الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما آثرت فاستعن بقوة الغضب التي تثير وتهيج بالأنفة والحمية وأقهر بها النفس البهيمية. فإن غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت فأنت في طريق الصلاح فتمم عزيمتك واحذر أنت أن تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك؟ فإن لم تفعل ذلك ولم تكن العقبة في الغلبة لك كنت كما قال الحكيم الأول: إني أرى أكثر الناس يدعون محبة الفعال الجميلة ثم لا يحتملون المؤنة فيها على علمهم بفضلها فيغلبهم الترفه ومحبة البطالة.
فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الأفعال الجميلة فرقٌ إذا لم يحتملوا مؤنة الصبر ويصبروا إلى تعلم تمام ما آثروه وعرفوا فضله. واذكر مثل البئر التي تردى فيها الأعمى والبصير فيكونان في الهلكة سواء إلا أن الأعمى أعذر. ومن وصل من هذه الآداب إلى مرتبة يعتد بها واكتسب بها الفضائل التي عددنها فقد وجب عليه تأديب غيره وإفاضة ما أعطاه الله على أبناء جنسه.
.فصل في تأديب الأحداث والصبيان خاصة، وقد نَقَلْتُ أكثره من كتاب بروسنس.
قد قلنا فيما تقدم أنَّ أول قوة تظهر في الإنسان وأول ما يتكون هي القوة التي يشتاق بها إلى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع إلى اللبن يلتمسه من الثدي الذي هو معدَنُه، من غير تعليم ولا توقيف، أو يحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة والأذى. ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدا إلى الإزدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات. ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق له الشوق إلى الأفعال التي تحصل له هذه.
ثم يحدث له من الحواس قوة على تخيل الأمور ويرتسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق إليها ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشتاق بها إلى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يمنعه من منافعه. فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته انتقم منها وإلا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبُكاء. ثم يحدث له الشوق إلى تمييز الأفعال الإنسانية خاصة أولا فأولا حتى يصير إلى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقلا. وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الأخرى إلى أن ينتهي إلى الغاية الأخيرة.
وهي التي لا تراد لغاية أخرى وهو الخير المطلق الذي يتشوقه الإنسان من حيث هو إنسان. فأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء، وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه. ولذلك قلنا أول ما ينبغي أن يتفرس في الصبي ويستدل به على عقلهِ الحياءُ، فإنه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع إحساسه به يحذره ويتجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه. فإذا نظرت إلى الصبي فوجدته مستحيينا مطرقا بطرفه إلى الأرض غير وقح الوجه ولا مُحدق اليكَ فهو أول دليل على نجابته، والشاهدُ لك على أن نفسه قد أحست بالجميل والقبيح. وأنَّ حياءه هو انحصار نفسه خوفا من قبيح يظهر منه وهذا ليس بشيء أكثر من إيثار الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل. وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا تترك ومخالطة الأضداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة.
وإن كانت بهذه الحال من الإستعداد لقبول الفضيلة فإن نَفْسَ الصبي ساذَجَة لم تنتقش بعدُ بصيرتها وليس لها رأي ولا عزيمة تُمِيلها من شيء إلى شيء، فإذا نُقِشَت بصورةٍ وقَبِلَتها، نشأ عليها واعتادها. فالأولى بمثل هذه النفسِ أن تُنَبّهَ أبدا على حب الكرامة ولا سيما ما يحصل له منها بالدِين دون المال وبلزوم سُننه ووظائفه. ثم يمدح الأخيار عنده ويمدح هو في نفسه إذا ظهر شيء جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يظهر منه ويؤاخذ باشتهائه للمآكل والمشارب والملابس الفاخرة ويزين عنده خُلُقُ النفس والترفع عن الحرص في المآكل خاصة وفي اللذات عامة. ويجب إليه إيثار غيره على نفسه بالغذاء والإقتصار على لاشيء المعتدل والإقتصاد في التماسه.
الملابس
ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة النساء اللاتي يتزيَّنّ بها للرجال ثم العبيدُ والخول. وأنّ الأحسن بأهل النُبلِ والشرف من اللباس البياضُ وما أشبهه حتى يَتربى على ذلك ويسمعه كل من يقرب منه ويتكرر عليه ولم يترك مخالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته لا سيما من أترابه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلاعبه.
وذلك أن الصبي في ابتداء نشوئه يكون على الأكثر قبيحَ الأفعالِ إمّا كُلها وإما اكثرها فإنه يكون كذوبا ويخبر ويحكي ما لم يسمعه ولم يره ويكون حسودا سروقا نماما لجوجا ذا فضول أضر شيء بنفسه وبكل أمر يلابسه. ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجار حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال. فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلا بما ذكرناه وبذكره. ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوده بالأدب حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمناه ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يُوهمه أصحابها ّأنه ضرب من الظَرَف ورقة الطبع. فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جدا. ثم يُمدحُ بكل ما يَظهرُ منه من خُلُقٍ جميل وفعل حسن ويُكرَّمَ عليه.
فإن خالف في بعض الأوقات ما ذكرتُهُ فالأولى أن لا يُوبَّخَ عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه بل يُتَغافل عنه تغافُلَ من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ولا هَمَّ بهِ، لا سيما إن سَتَرهُ الصبيُّ واجتهدَ في أن يُخفيَ ما فعله عن الناس فإن عادَ فليُوَبَّخ عليه سِرا وليُعَظّمَ عنده ما أتاه. ويُحّذر من معاودته فإنك إن عَوَّدتَه التَوبيخ والمُكاشفة حَمَلْتَه على الوقاحة وحرَّضتَه على معاودة ما كان استقبحه وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات التي تدعو إليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا.
.فصل في آداب المطاعم.
والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها آداب المطاعم فيفهم أولا انَّها إنما تراد للصحة لا للذة، وأنَّ الأغذيةَ كُلُّها إنَّما خُلقت وأعِدَّت لنا لِتَصُحَّ بها أبدانُنا وتصيرَ مادةَ حياتِنا. فهي تجري مجرى الأدوية ليُتداوي بها من الجوع والألم الحادث منه. فكما أنَّ الدواء لا يُرام للذة ولا يُستكثر منه للشهوة، فكذلك الأطعمة لا ينبغي أن يُتناول منها إلا ما يَحفظ صحةَ البدن ويَدفع ألَمَ الجوع ويَمنعَ من المرض. فيُحَفَّزَ عِنده قَدْرَ الطعام الذي يستعظمه أهل الشَّرَه، ويُقّبَّحُ عنده صورةُ من غَلَبهُ الشَّرَه، وينال منه فوق حاجة بدنه أو ما لا يوافقه، حتى يَقتَصِرَ على لونٍ واحد. ولا يُرَغَّبَ في الألوان الكثيرة. وإذا جلس مع غيره لا يُبادر إلى الطعام ولا يُديمً النظر إلى ألوانه ولا يُحدق إليه شديدا.
ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الأكل ولا يوالي بين اللُقَمِ بسرعة. ولا يُعَظِّمَ اللقمة، ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها. ولا يُلَطِّخَ يده ولا ثوبه، ولا يلحظَ من يؤاكله، ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام. ويُعَوَّدَ أن يُؤثِرَ غيره بما يليه إن كان أفضل ما عنده، ثم يضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدونَهُ. ويأكلُ الخُبزَ القِفَار الذي لا أُدْمَ معه في بعض الأوقات. وهذه الآداب وإن كانت جميلةٌ بالفقراء فهي بالأغنياء أفضل وأجمل. وينبغي أن يَستوفي غذاه بالعشي فإن استوفاه بالنهار كسل واحتاج إلى النوم وتبلد فهمه مع ذلك.
وإن مُنِعَ اللحمُ عنه في أوقاته كان أنفع له وأشدَّ وقعا في الحركة والتيقظ وقلة البلادة وبَعَثَه على النشاط والخِفة. وأما الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها ألبتة إن أمكن. وإلا فليتناول أقل ما يمكن فإنها تستحيل في بدنه فتكثر إنحلاله وتعوده مع ذلك على الشره ومحبة الإستكثار من المآكل. ويُعَوَّدَ أن لا يشرب في خلال طعامه الماء. فإما النبيذ وأصناف الأشربة المسكرة فإياها وإياها فإنها تضره في بدنه ونفسه وتحمله على سرعة الغضب والتهور والإقدام على القبائح والقحة وسائر الاخلال المذمومة.
.فصل في آدابٍ مُتنوعة.
ولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل اللهو وإن كان أهل المجلس أدباء فضلاء. وأما غيرهم فان ضرره واضح فانه يسمع الكلام القبيح والسخافات التي تجري فيه.
وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الأدب التي يتعلمها ويتعب تعبا كافيا. وينبغي أن يُمنع من كل فعل يستره ويخفيه فإنه ليس يخفى شيئا إلا وهو يظن أو يعلم أنه قبيح. ويُمنَعَ من النوم الكثير فإنه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره. هذا بالليل فأما بالنهار فلا ينبغي أن يَتَعوده ألبتة. ويمنع أيضا من الفراش الوطيء ويمنع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه ويتعود الخشونة ولا يتعود الخيش والأسراب في الصيف ولا الأوبار والنيران في الشتاء للأسباب التي ذكرناها. ويُعَوَّدَ المشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يَتعود أضدادها.
ويُعَوَّدَ أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع في المشي ولا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره ولا يُربي شعره. ولا يتزين بملابس النساء ولا يلبس خاتما إلا وقت حاجته إليه. ولا يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه من مآكله وملابسه وما يجري مجراه ولا يشين أحدا، بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره.
ولا يتوصل بشرف إن كان له أو سلطان من أهله إن اتفق إلى غضب من هو دونه أو استهداء من لا يمكنه أن يرده عن هواه أو تطاوله عليه. كمن اتفق له إن كان خاله وزيرا أو عمه سلطانا فتطرق به إلى هضيمة أقرانه وثلم أخوانه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره. ولا يضع رِجْلا على رِجْل، ولا يَضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه بيده.
فإنّ هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به القُبْحَ إلى أن لا يحمل رأسه حتى يستعين بيده. ويُعَوَّدَ أن لا يكذب ولا يحلف البتة لا صادقا ولا كاذبا. فإنّ هذا قبيح بالرجال مع الحاجة إليه في بعض الأوقات، فأما الصبي فلا حاجة به إلى اليمين. ويُعَوَّدَ أيضا قلة الكلام فلا يتكلم إلا جوابا. وإذا حضر من هو أكبر منه اشتغل بالاستماع منه والصمتِ له. ويُمنعَ من خبيث الكلام وهجينه ومن السب واللعن ولغو القول. ويُعوَّدَ حسن الكلام وظريفه وجميل اللقاء وكريمه، ولا يُرَخَصَّ له أن يستمع لأضدادها من غيره. ويُعَوَّدَ خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان أكبر منه.
وأحوجُ الصبيانِ إلى هذا الأدب أولادُ الأغنياء والمُترفين. وينبغي إذا ضرَبه المُعلم أن لا يصرخ ولا يستشفِعَ بأحد، فإنّ هذا فعل المماليك ومن هو خَوَّارٌ ضعيف. ولا يُعَيِّرَ أحدا إلا بالقبيح والسيء من الأدب. ويُعَوَّدَ أن لا يُوحش الصبيان. بل يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه لئلا يتعود الريح على الصبيان وعلى الصديق. ويُبَغَّضَ إليه الفضةَ والذهبَ ويُحَذَّر منهما أكثر من تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعي. فإن حُبَّ الفضة والذهب آفتةٌ أكثر من آفات السموم. وينبغي أن يُؤذَنَ له في بعض الأوقات أن يلعب لعبا جميلا ليستريح إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد.
ويُعَوَّدَ طاعةَ والديه ومعلميه ومؤدبيه وأن يَنظُرَ اليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابَهُم. وهذه الآداب النافعة للصبيان هي للكبار من الناس أيضا نافعة ولكنها للأحداث أنفع، لأنها تعودهم محبة الفضائل وينشأون عليها فلا يثقل عليهم تجنب الرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما ترسمه الحكمة وتحده الشريعة والسنة. ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من اللذات القبيحة وتكفُّهم عن الإنهماك في شيء منها والفكر الكثير فيها.
وتَسُوْقُهُم إلى مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم إلى معالي الأمور التي وصفناها في أول الكتاب من التقرب إلى الله عز وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الحال في الدنيا وطيبِ العيش، وجميل الأحدوثة، وقِلة الأعداء، وكثرة المَدح له، والراغبين في مودته من الفضلاء خاصة. فإذا تجاوزَ هذه الرتبة، وبَلَغَ أيامُهُ إلى أن يفهم أغراض الناس وعواقب الأمور، فَهِمَ أنّ الغرضَ الأخيرَ من هذه الأشياء التي يقصُدُها الناس ويحرصون عليها من الثروة وإقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشباه ذلك، إنما هو لراحة البدن وحفظ صحته. وأن يبقى على إعتداله مدة ما. وأن لا يقع في الأعراض ولا تفجأه المَنِيّة. وأن يهنأ بنعمة الله عليه ويستعد لدار البقاء والحياة السرمدية.
وأنّ اللذاتِ كلها في الحقيقة هي خلاص من آلام وراحات من تعب. فإذا عرف ذلك وتحققه ثم تعوَّدَهُ بالسيرة الدائمة وتَعَوَّدَ الرياضات التي تُحرِك الحرارة الغريزية، وتحفظُُ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البلادة وتبعث النشاط وتُذكي النفس. فمن كان مترفا كانت هذه الأشياء التي رسَمْتُها أصعب عليه، لكثرة من يَحتَفُّ به ويُغويه، ولموافقة طبيعة الإنسان في أول ما تنشأ هذه اللذات وإجماع جمهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم.
فأما الفقراء فالأمر عليهم أسهل بل هم قريبون إلى الفضائل قادرون عليها متمكنون من نيلها والإصابة منها. وحال المتوسطين من الناسِ، متوسطةٌ بين هاتين الحالتين. وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يُرَبُّونَ أولادَهم بين حَشَمِهم وخواصِّهِم خوفا عليهم من الأحوال التي ذكرناها ومن سماع ما حذَّرتُ منه. وكانوا ينفذونهم مع ثُقَاتِهم إلى النواحي البعيدة عنهم. وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يَعرِفُ التنعم ولا الترفه، وأخبارهم في ذلك مشهورة. وكثير من رؤسائهم في زماننا هذا ينقلون أولادهم عندما ينشأون إلى بلادهم ليتعودوا بها هذه الطرق المحمودة في تأديب الأحداث، فقد عُرِفَت أضدُادها.
أعني أن يشتغل بصلاحه وتقويمه فإنه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي، الذي لا يُطمَعُ في رياضته، فإن نفسَهُ العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغَضَبِيةِ فهي منهمكة في مطالبها من النزوات. وكما أنه لا سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تَقْبَل التأديب كذلك لا سبيل إلى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلا في السن. اللهم إلا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته ذا مالها عائبا على نفسه عازما على الإقلاع والإنابة.
فإنّ مِثلَ هذا الإنسان من يرجى له النُزوعُ عن أخلاقه بالتدريج والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبة الأخيار وأهل الحكمة وبالإنكباب على التفلسف. وإذ قد ذكرنا الخُلُقَ المحمود وما ينبغي أن يؤخذ به الأحداث والصبيان فنحن واصفون جميع القوى التي تحدث للحيوان أوَّلا فأوَّلا إلى أن ينتهي إلى أقصى الكمال في الإنسانية، فإنكَ شديد الحاجة إلى معرفة ذلك لتبتديء على الترتيب الطبيعي في تقويم واحد منها، فنقول:
في الأجسام الطبيعية،
إنّ الأجسام الطبيعية كلها تشترك في الحد الذي يَعُمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التي تحدث فيها. فإن الجماد منها إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التي لا تقبل تلك الصورة. فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد.
وتلك الزيادة هي الإغتذاء والنمو والإمتداد في الأقطارِ وإجتذاب ما يوافقه من الأرضِ والماءِ وترك ما لا يوافقه ونفض الفضلات التي تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ. وهذه الأشياء التي ينفصل بها النبات من الجماد. وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شَرُفَ بها على الجماد تتفاضل: وذلك أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة كالمرجان وأشباهه. ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبِزر. ويكفيه في حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطُلُوع الشمس، فلذلك هو في أُفُقِ الجمادات وقريب الحال منها. ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الأثمار وحفظ النوع بالبزر الذي يخلف به مثله فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبلهِ. ثم تقوى هذه الفضيلة فيه حتى يصير بعضه على بعض حتى يبلغ إلى أُفُقِه ويصير في أفق الحيوان.
وهي كِرَامُ الشجر كالزيتون والرمان والكرْمِ وأصناف الفواكه إلا أنها بعد مختلطة القوى، أعني أن قوى ذكورها وإناثها غير متميزة، فهي تَحمل وتلد المِثلَ ولم تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق الحيوان. ثم تزداد وتَمْعُنُ في هذا الأفق إلى ان تصير في أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة. وذلك أنها أن قبلت زيادة يسيرة صارت حيوانا وخرجت عن أفق النبات. فحينئذ تتميز قواها ويحصل فيها ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل الحيوان أمورا تتميز بها عن سائر النبات والشجر كالنخل الذي طالع أُفُقِ الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها ولم يبق بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة وهي الإنقلاع من الأرض والسعي إلى الغذاء.
وقد رويَ في الخَبَرِ ما هو كالإشارة أو كالرمز إلى هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {أكرموا عَمّتكم النخلةَ فإنها خلقت من بقية طينة آدم} فإذا تحرك النبات وانقلع من أفُقِهِ وسعى إلى غذائه ولم يتقيد في موضعه إلى أن يصير إليه غذاؤه، وكُوّنَتْ له آلاتٌ أُخَرَ يتناول بها حاجاته التي تكمله فقد صار حيوانا.
وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من أول أفقه وتتفاضل فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كانَ ذلك في النبات فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة الشعور باللذة والأذى فيلتذ بوصوله إلى منافعه ويتألم بوصول مضاره إليه. ثم يقبَلُ الهامَ الله عز وجل إياه فيهتدي إلى مصالحه فيطلبها وإلى أضداده فيهرب منها. وما كان من الحيوان في أول أفق النبات فإنه لا يتزاوج ولا يُخَّلِفُ المِثْلَ، بل يتوالد كالديدان والذباب وأصناف الحشرات الخسيسة.
ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات سواء.
ثم تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطي من السلاح بحسب قوته وما يطيق استعماله. فإن كانت قوته الغَضَبِيّة شديدة كان سلاحه تاما قويا. وإن كانت ناقصة كان ناقص،ا وإن كانت ضعيفة جدا لم يُعْطَ سلاحا ألبَتّةَ، بل أُعطيَ آلة الهرب كشدة العدو والقدوة على الحيل التي تنجيه من مخاوفه. وأنت ترى ذلك عيانا من الحيوان الذي أعطى القرون التي تجري له مجرى الرماح.
والذي أعطيَ الأنيابَ والمخالب التي تجري له مجرى السكاكين والخناجر. والذي أعطى آلة الرميَ التي تجري له مجرى النَبلِ والنشاب. والذي أُعطيَ الحوافر التي تجري له مجرى الدبوس والطُبَرزين.
فأما الذي لم يُعط سلاحا لضُعفه عن استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية ولأنه لو أُعطِيهُ لصار ثُقلا عليه فقد أعطيَ آلة الهرب والحيلةِ على العدو والخفة والخَتَلِ والمراوغة كالأرانب وأشباهها. وإذا تصفحت أحوال الموجودات من السباع والوحش والطير، رأيتَ هذه الحكمة مستمرة فيها فتبارك الله أحسن الخالقين، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، فأما الإنسان فقد عُوّضَ من هذه الآلات كلها بان هُدِيَ إلى استعمالها كلها وسُخِّرَت هذه كلها له وسنتكلم على ذلك في موضعه. فأما أسباب هذه الأشياء كلها والشكوك التي تعترض في قصد بعضها بعضا بالتلف والأنواع من الأذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها إن أخر الله في الأجلِ عند بلوغنا إلى الموضع الخاص بها.
.فصل في مراتب مراتب الحيوان.
ونعود إلى ذكر مراتب الحيوان فنقول: أنّ النوع الذي إهتَدى منها إلى الإزدواج وطلب النسل وحفظ الولد وتربيته والإشفاق عليه بالكَنِّ والعُش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض، وتغذيته إما باللبن وإما بنقل الغذاء إليه، فإنه أفضل مما لا يهتدي إلى شيء منها. ثم لا تزال هذه الأحوال تتزايد في الحيوان حتى يَقْرُبَ من أفق الإنسان فحينئذ يَقبل التأديب ويصير بقبوله للأدب ذا فضيلة يتميز بها من سائر الحيوانات.
ثم تتزايد هذه الفضيلة في الحيوانات حتى يَشْرُفُ بها ضروب الشَّرَفِ كالفرس والبازي المُعَلَّم. ثم يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذي يحاكي الإنسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقِرَدة وما أشبهها ويبلغ من ذكائها أن تَستَكفي في التأدب بأن ترى الإنسان يعمل عملا فتعملَ مثله من غير أن تحُوجَ الإنسانَ إلى تعب بها ورياضة لها، وهذه غاية أفق الحيوان التي أن تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه وصار في أفق الإنسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور التي تلائمها. فإذا بلغ هذه الرتبة تحرك إلى المعارف واشتاق إلى العلوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقي والإمعان في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب الأخرى التي ذكرناها،
وأول هذه المراتب من الأفقِ الإنساني المتصل بآخِرِ ذلك الأفقِ الحيوانيِ، مراتب الناس الذين يسكنون في أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب كأواخر الترك من بلاد يأجوجَ ومأجُوجَ وأواخر الزنج وأشباههم من الأمم التي لا تُمَيَّزُ عن القرود إلا بمرتبة يسيرةٍ. ثم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل، وإلى هذا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات.
ثم يستعد بهذا القبول لإكتساب الفضائل واقتنائها بالإرادة والسعي والإجتهاد الذي ذكرناه فيما تقدم حتى يصل إلى آخر أفُقِهِ فإذا صار إلى آخر أُفُقِهِ اتصل بأول أفق الملائكة وهذا أعلى مرتبة الإنسان وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أولها بآخرها. وهو الذي يسمى دائرة الوجود، لأنَّ الدائرة هي التي قيل في حدها إنها خط واحد يبتدىء بالحركة من نقطة وينتهي إليها بعينها ودائرة الوجود هي المتأحدة التي جعلت الكثرة وحدة. وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية على موجدها وحكمته وقدرته ووجوده تبارك إسْمُه وتعالى جدُّه وتقدس ذكره. ولولا أن شرح هذا الموضوع لا يليق بصناعة تهذيب الأخلاق لشَرَحْتُه لك، ولكنك ستقِفُ عليه إن بلَغتَ هذه الرتبة بمشيئة الله.
وإذا تصوّرتَ قدر ما أومَأنا إليه وفهمته اطلعت على الآلة التي خُلِقت ونُدِبتَ إليها وعرفت الأفق الذي يتصل بأُفُقك وتنقلك في مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقا عن طبق وحدث لك الإيمان الصحيح وشهِدتَ ما غاب عن غيرك من الدهْمَاء وبَلَغتَ أن تَتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة التي مبدؤها تعلم المنطق فإنه الآلة في تقويم الفهم والعقل الغريزي.
ثم الوصول به إلى معرفة الخلائق وطباعها ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها إلى العلوم الإلهية، وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله سبحانه وعطاياه، فيأتيك الفيض الإلهي فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولا فأولا من مراتب الموجودات. وعَلِمتَ ان كل مرتبة منها محتاجة إلى قبلها في وجودها، وعَلِمْتَ أن الإنسان لا يتم له كماله إلا بعد أن يحصل له ما قَبْلَهُ، وإذا صار إنسانا كاملا وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى عليه وصار إما حكيما تاما تأتيه الإلهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكمية والتأييدات العلوية في التصويرات العقلية، وإما نبيا مؤيدا يأتيه الوحي على ضروب المنازل التي تكون له عند الله تعالى ذِكْرُه.
فيكون حينئذ واسطة بين الملأ الأعلى والملأ الأسفل. وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل إليها من حال الإنسية ومطالعة الآفاق التي ذكرناها. وحينئذ يفهم عن الله تعالى قوله (فلا تعلم نفسٌ ما أُخفيَ لهم من قرة أعين) وتصور معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هناك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)، وإذا بلغ الكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أُهِّل الإنسان لها ونسقنا أحواله التي يترقى فيها وأنه يكون أولا بالشوق إلى المعارف والعلوم فينبغي أن نزيد في بيانه وشرحه فنقول:
.فصل في الشوق إلى المعارف والعلوم.
إنَّ هذا الشَّوقَ ربما ساق الإنسان على منهج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي إلى غاية كماله وهي سعادته التامة. وقلما يتفق ذلك وربما اعوج به عن السَّمْتِ والسَّنَنِ، وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بك إلى علمها الآن وأنت في تهذيب خُلُقِكَ. فكما أن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت إلى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق إلى أكل الطين وما جرى مجراه مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده. كذلك أيضا النفس الناطقة ربما اشتاقت إلى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها إلى الأشياء التي تُعَوِّقُها وتَقْصُر بها عن كمالها، فحينئذ يحتاج إلى علاج نفسانيّ روحانيّ كما احتاج في الحالة الأولى إلى طب طبيعيّ جسمانيّ. ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين وإلى المؤدبين والمسددين.
فإن وجود تلك الطبائع الفائقة التي تنساق بذاتها من غير تَعوقٍ إلى السعادة عسرة الوجود ولا توجد إلا في الأزمنة الطوال والمدد البعيدة. وهذا الأدب الحق الذي يؤدينا إلى غايتنا، يجب أن تَلحَظَ فيه المبدأ الذي يجري مجرى الغاية، حتى إذا لَحَظتَ الغايةَ تدرج منها إلى الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدىء من أسفل على طريق التركيب فيسلك فيها إلى أن ينتهي إلى الغاية التي لاحظت أوّلا. وهذا المعنى هو الذي أحوجنا في مبدأ هذا الكتاب وفي فصول أخر منه أن نذكر أشياء عالية لا تليق بهذه الصناعة ليتشوق إليها من يستحقها. وليس يمكن الإنسان أن يشتاق إلى ما لا يعرفه ألبَتَّةَ. فإذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة فتشوَّقَها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب فيها. وينبغي أن يعلم أن كل إنسان مُعّدّ نحو فضيلة ما فهو إليها أقرب وبالوصول إليها أحرى. ولذلك لا تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر إلا من اتفق له نفس صافية وطيعية فائقة فينتهي إلى غايات الأمور وعلى غاياتها أعني السعادة القصوى التي لا سعادة بعدها.
.فصل في ما هو الواجب على الحاكم.
ولأجل ذلك يجب على مدبر المدن أن يَسُوقَ كل إنسان نحو سعادته التي تخصه ثم يقسم عنايته بالناس ونظرِهِ لهم بقسمين: أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية، والأخرى في تسديدهم نحو الصناعات والأعمال الحسية. وإذا سدَّدَهم نحو السعادة الفكرية بدأَ بهم من الغاية الأخيرة على طريق التحليل ووقف بهم عند القُوى التي ذكرناها. وإذا سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم من عند هذه القُوى وانتهى بهم إلى تلك الغاية.
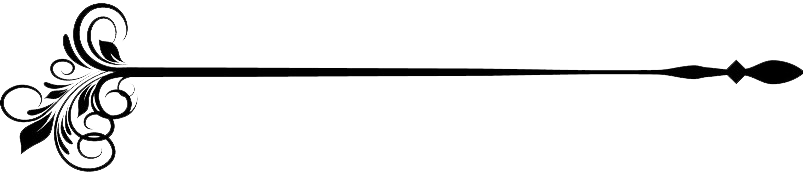
متروك
أمّا تصحيحُ المقدمة الأولى. وهي أنّ كل خُلق يُمكن تَغيُّره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بين من العيان ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثيره في الأحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسةُ الله لخَلقِهِ، وأمّا تصحيح المقدمة الثانية وهي أنَّه لا شيءَ مما يُمكن تَغيُّره هو بالطبع فهو ظاهرٌ أيضاً. وذلك أنا لا نَرُومُ تَغييرَ شيءٍ مِمّا هو بالطبع أبداً. فإنَّ أيَّ أحدٍ لا يَرومُ أن يُغيِرَ حَركةَ النارِ التي إلى فوقٍ بأن يُعَودَها الحركةَ إلى أسفلٍ، ولا أنْ يُعَوِّدَ الحجرَ حركةَ العُلوِّ يَرومُ بذلكَ أن يُغيرَ حركةَ الطبيعة التي إلى أسفلَ.
ولو رآمَهُ ما صحَّ له تغيير شيءٌ من هذا ولا ما يَجري مَجراهُ أعني الأمورَ التي هي بالطبعِ فقد صَحَّت المُقدمتان وصحَّ التأليف في الشكل الأول وهو الضّربُ الثاني منه وصار برهانا.
فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي سميناها خُلُقا والمسارعة إلى تعلمها والحرص عليها فإنها كثيرةٌ وهي تُشاهدُ وتُعاينُ فيهم وخاصةً في الأطفالِ فإنَّ أخلاقَهم تَظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها برُويَّةٍ ولا فكرٍ كما يفعلهُ الرجل التامُّ الذي انتهى في نشؤه وكماله إلى حيث يَعرِفُ من نفسهِ ما يُستقبحُ منه فيُخِفيهُ بضُرُوبٍ من الحِيَلِ والأفعالِ المضادة لما في طبعه: وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه أو ما يظهر في بعضهم من القحة وفي بعضهم من الحياء وكذلك ما ترى فيهم من الجود والبخل والرخمة والقسوة والحسد وضده ومن الأحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة واحدة وأن فيهم المتواني والممتنع والسهل السلس والفظ العسر والخير والشرير. والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرة وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل إنسان على رسوم طباعه وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في الطفولية وتبع ما وافقه في الطبع أما الغضب وأما اللذة وأما الزعارة وأما الشره وأما غير ذلك من الطباع المذمومة.
الشريعة
والشريعة هي التي تُقوِّمُ الأحداثَ وتُعوِّدُهم الأفعالَ المَرضية وتُعِدُّ نُفوسَهم لقّبول الحكمةِ وطلبِ الفضائل والبلوغِ إلى السعادة الإنسية بالفِكرِ الصحيح والقياس المستقيم وعلى الوالدين أخذُهُم بها وسائرِ الآدابِ الجميلةِ بضُروبِ السياسات من الضروب إذا دعت إليه الحاجة أو التوبيخات أن صدتهم أو الأطماع في الكرامات أو غيرها مما يميلون إليه من الراحات أو يحذرونه من العقوبات. حتى إذا تعودوا ذلك واستمروا عليه مدة من الزمان كثيرة أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا برهين ما أخذوه تقليدا وينبهوا على طرق الفضائل وإكتسابها والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحن بصددها.
والله الموفق
وللإنسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها أولا فأولا إلى الكمال الأخير طريق طبيعي يتشبه فيها بفعل الطبيعة. وهو أن ينظر إلى هذه القوى التي تحدث فينا أيها أسبق إلينا وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بين ظاهر. وذللك أن أول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال يختص بشيء شيء يتميز به عن نوع نوع إلى أن يصير إلى الإنسانية. فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا إلى الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم بآخره وهو الشوق الذي يحصل فينا إلى المعارف والعلوم فنقومه. وهذا الترتيب الذي قلنا أنه طبيعي إنما حكمنا فيه لما يظهر فينا منذ أول نشونا أعني أن نكون أولا أجنة ثم أطفالا ثم أناسا كاملين وتحدث فينا هذه القوى مرتبة. فأما أن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الأخلاق التي تعني بتجويد أفعال الإنسان بحسب ما هو إنسان فيتبين مما أقول.
الإنسان
لما كان للجوهر الإنساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم كما بيناه فيما تقدم، وكان الإنسان أشرف موجودات عالمنا ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره وشبهناه بالفرس الذي إذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام استعمل مكان الحمار بالاكاف وكان وجوده أروح له من عدمه وجب أن تكون الصناعة التي تعني بتجويد أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ورفعه عن رتبة الأخس التي يستحقق بها المقت من الله والقرار في العذاب الأليم أشرف الصناعات كلها وأكرمها.
وأما سائر الصناعات الأخر فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جدا من تصفح الصناعات لأن فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميتة وفيها صناعة الطب والعلاج التي تهتم باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة وهكذا الهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها إلى العلوم الدنيئة وبعضها إلى العلوم الشريفة. وإذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان. أما في الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات إذا قيس إلى جوهر الإنسان. وإما في جوهر الموجودات الآخر فظاهر لمن أراد أن يحصيها. فالصناعة والهمة التي تصرف إلى أشرفها أشرف من الصناعة والهمة التي تصرف إلى الأدون منها.
ويجب أن يعلم انّ اسم الإنسان وإن كان يقع على أفضلهم وعلى أدونهم فإنّ بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ليس شيء خيرا من ألف مثله الإنسان ” وقال: عليه الصلاة والسلام ” الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة ” وقال: ” الناس كأسنان المشط”، وكان العرب يقولون كأسنان الحمار وإنما يتفاضلون بالعقل. ولا خير في صحبة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له ”
وفي نظائر هذه أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى وأن الشاعر الذي قال: (ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد) وإن كان عنده أنه قد بالغ فإنه قد قصر. والخبر الخمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ” إني وزنت بأمتي فرجحت بهم ” أصدق وأوضح. وليس هذا في الإنسان وحده بل في كثير من الجواهر الأخر. وإن كان في الإنسان أكثر وأشد تفاوتا فإن بين السيف المعروف بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتا عظيما. وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفرس الكريم وبين البرذون المقرف فمن أمكنه أني رقى بالصناعة منأدون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها فاشرف به وبصناعته ما أكرمه وأكرمها. فأما الإنسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الإستعدادات لضروب من المقامات. وليس ينبغي أن يكون الطمع في إستصلاحه على مرتبة واحدة وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه.
إلا أن الذي ينبغي أن يعلم الآن أن وجود الجوهر الإنساني متعلق بقدرة فاعله وخالقه تبارك وتقدس إسمه وتعالى. فأما تجويد جوهره فمفوض إلى الإنسان وهو معلق بإرادته. فاعرف هذه الجملة إلى أن تلخص في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب إن قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ما هي ولأي شيء هي. ثم قنا إن لكل جوهر موجود كمالا خاصا به وفعلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء
وقد بينا ذلك في غاية البيان في الرسالة المسعدة. وإذا كان ذلك محفوظا فنحن مضطرون إلى أن نعرف الكمال الخاص بالإنسان والفعل الذي لا يشاركه فيه غير منحيث هو إنسان لنحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد في البلوغ إلى غايته ونهايته. ولما كان الإنسان مركبا لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به كمال بسائطه وأفعالها الخاصة بها وإلا كان وجود المركب باطلا كالحال في الخاتم والسرير. فإذا له فعل خاص به من حيث هو مركب وإنسان لا يشاركه فيه شيء من الموجودات الأخر. فأفضل الناس أقدرهم على إظهار فعله الخاص والزمهم له من غير تلون فيه ولا إخلال به في وقت دون وقت. وإذا عرف الأفضل فقد عرف الأنقص على إعتبار الضد، فالكمال الخاص بالإنسان كمالان وذلك أن له قوتين إحداهما العالمة والأخرى العاملة فلذلك يشتاق بإحدى القوتين إلىالمعارف والعلوم وبالأخرى إلى نظم الأمور وترتيبها وهذان الكمالان هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا.
الفلسفة
تنقسم إلى قسمين إلى الجزء النظري والجزء العملي فإذا كمل الإنسان بالجزء العملي والجزء النظري فقد سعد السعادة التامة، أما كماله الأول بإحدى قوتيه أعني العالمة وهي التي يشتاق بها إلى العلوم فهو أن يصير في العلم بحيث يصدق نظره وتصح بصيرته وتستقيم رويته فلا يغلط في إعتقاد ولا يشك في حقيقة وينتهي في العلم بأمور الموجودات على الترتيب إلىالعلم الإلهي الذي هو آخر مرتبة العلوم ويثق به ويسكن إليه ويطمئن قلبه وتذهب حيرته وينجلي له المطلوب الأخير حتى يتحد به وهذا الكمال قد بينا بالقوة الأخرى أعني القوة العاملة فهو الذي نقصده في كتابنا هذا وهو الكمال الخلقي ومبدؤه من ترتيب قواه وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتغالب وحتى تتسالم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهي إلي التدبير المدني الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس حتى تنتظم ذلك الإنتظام ويسعدوا سعادة مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد.
فإذا الكمال الأول النظري منزلته منزلة الصورة والكمال الثاني العملي منزلته منزلة المادة وليس يتم أحدهما إلا بالآخر لأن العلم مبدأ والعمل تمام والمبدأ بلا تمام يكون ضائعا والنمام بلا مبدأ يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذي سميناه غرضا.
وذلك أن الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد وإنما يختلفان بالإضافة فإذا نظر إليه وهوبعد في النفس ولم يخرج إلي الفعل فهو غرض فإذا خرج إلي الفعل وتم فهو كمال. وكذلك الحال في كل شيء لأن البيت إذا كان متصورا للباني وكان عالما بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضا. فإذا أخرجه إلي كماله ويصدر عنه فعله الخاص به إذا علم الموجودات كلها أي يعلم كلياتها وحدودها التي هي ذواتها لا أعراضها وخواصها التي تصيرها بلا نهاية.
فإنك إذا علمت كليات الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو مالان الجزئيات لاتخرج عن كلياتها فإذا كملت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم ورتب القوى والملكات التي فيك ترتيبا علميا كما سبق علمك به. فإذا انتهيت إلى هذه الرتب فقد صرت عالما وحك واستحقيت أن تسمى عالما صغيرا لأن صور الموجودات كلها قد حصلت في ذاتك فصرت أنت هي بنحو ما. ثم نظمتها بأفعالك على نحو استطاعتك فصرت فيها خليفة لمولاك خالق الكل جلت عظمته فلم تخط فيها ولم تخرج عن نظامه الأول الحِكميُ فتصير حينئذ عالما تاما.
والتام من الموجودات هو الدائم الوجد والدائم الوجود هو الباقي بقاء سرمديا فلا يفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم لأنك بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائما أبدا وقد قربت منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب. وهذه هي الرتبة العليا والسعادة القصوى. ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس يمكنه تحصيل هذه المنزلة في ذاته وتكميل صورته بها وإتمام نقصانه بالترقي إليها لكان سبيله سبيل أشخاص الحيوانات الأخر أو كسبيل أشخاص النبات في مصيرها إلى الفناء والإستحالة التي تلحقها والنقصانات التي لا سبيل إلى تمامها. ولإستحال فيه البقاء الأبدي والنعيم السرمدي والمصير إلى ربه ودخول جنته. ومن لا يتصور هذه الحالة ولا ينتهي إلى علمها من المتوسطين في العلم يقع له شكوك. فيظن أن الإنسان إذا انتقض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى كالحال في الحيوانات الأخر وفي النبات فحينئذ يستحق إسم الإلحاد ويخرج عن سمة الحكمة وسنة الشريعة.
كمال الإنسان في الذات المعنوية
وقد ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته هما في اللذات وإنها هي الخير المطلوب والسعادة القصوى. وظنوا أن جميع قواه اخر ” إنما ركبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها. وأن النفس الشريفة التي سميناها ناطقة إنما وهبت له ليرتب بها الأفعال ويميزها ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة هي حصولها له على النهاية والغاية الجسمانية. وظنوا أيضا أن قوى النفس الناطقة أعني الذكر والحفظ والروية كلها تراد لتلك الغاية. قالوا وذلك أن الإنسان إذا تذكر اللذات التي كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح اشتاق إليها وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ إنما هي اللذات وتحصيلها. ولأجل هذه الظنون التي وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة كالعبد المهين وكالأجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المآكل والمشارب والمناكح وترتبها لها وتعدها إعدادا كاملا موافقا. وهذا هو رأي الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط.
وإلى هذه الخيرات التي جعلوها غاياتهم تشوقوا عند ذكر الجنة والقرب من بارئهم عزوجل. وهي التي يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم. وإذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فإنما ذاك منهم على سبيل المتجر والمرابحة في هذه بعينها. كأنهم تركوا قليلها ليصلوا إلى كثيرها وأعرضوا عن الفانيات منها ليبلغوا إلى الباقيات. إلا انك تجدهم مع هذا الإعتقاد وهذه الأفعال إذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الأعلى الأشرف وما نزههم الله عنه من هذه القاذورات علموا بالجملة أنهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى رتبة من الناس وأنهم غير محتاجين إلى شيء من حاجات البشر بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل شيء الذي تولى إبداع الكل هو منزه عن هذه الأشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من إيجادها.
وإن الناس يشاركون في هذه اللذات الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان. وإنما يناسبون الملائكة بالعقل والتمييز ثم يجمعون بين هذا الإعتقاد والإعتقاد الأول. وهذا هوالعجب العجيب. وذلك أنهم يرون عيانا ضروراتهم بالأذى الذي يلحقهم بالجوع والعرى وضروب النقص وحاجاتهم إلى مداواتها بما يدفعها عنهم. فإذا زالت آثارها وعادوا إلى حال السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا للراحة لذة. ولا يشعرون أنهم إذا اشتاقوا إلى لذة المآكل فقد اشتاقوا أولا إلى ألم الجوع. وذلك أنهم إن لم يؤلموا بالجوع لم يلتذوا بالأكل. وهكذا الحال في سائر اللذات الأخر. إلا أن هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض. وسنتكلم على أن صورة الجميع واحدة وأن اللذات كلها إنما تحصل للملتذ بعد آلام تلحقه. لأن اللذة هي راحة من ألم وأن كل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم أو أذى في غير هذا الموضع.
وسيظهر عند ذلك أن من رضي لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته فقد رضى بأخس العبودية لأخص الموالي. لأنه يصير نفسه الكريمة التي يناسب بها الملائكة عبدا للنفس الدنيئة التي يناسب بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال.
وقد تعجب جالينوس في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من هذا الرأي وكثر استجهاله للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل. إلا أنه قال أن هؤلاء الخبثاء الذين سيرتهم أسوأ السير وإرداؤها إذا وجدوا إنسانا هذا رأيه ومذهبه نصروه ونوهوا به ودعوا إليه ليوهموا بذلك أنهم غير منفردين بهذه الطريقة لأنهم يظنون أنهم متى وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ما هم عليه كان ذلك عذرا لهم وتمويها على قوم آخرين في مثل طريقتهم. وهؤلاء هم الذين يفسدون الأحداث بإيهامهم أن الفضيلة هي ما تدعوهم إليه طبيعة البدن من الملاذ.
وأن تلك الفضائل الأخر الملكية إما أن تكون باطلة ليست بشيء ألبتة وإما أن تكون غير ممكنة لأحد من الناس: والناس مائلون بالطبع الجسداني إلى الشهوات فيكثر اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم. وإذا تنبه الواحد بعد الواحد منهم إلى أن هذه اللذات إنما هي لضرورة الجسد وإن بدنه مركب من الطبائع المتضادة أعني الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وأنه إنما يعالج بالمأكل والمشرب أمراضا تحدث به عند الإنحلال لحفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه. وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من الألم ليست بغاية مطلوبة ولا خير محض. وأن السعيد التام هومن لا يعرض له مرض البتة. وعرف مع ذلك أيضا أن الملائكة الأبرار الذين اصطفاهم الله بقربه لا تلحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون إلى مداواتها بالأكل والشرب.
وأن الله تعالى منزه متعال عن هذه الأوصاف – عارضوه بأن بعض البشر أشرف من الملائكة وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق. وشاغبوه وسفهوا رأيه وأوقعوا له شبها باطلة حتى يشك في صحة ما تنبه إليه وأرشده عقله إليه.
والعجب الذي لا ينقضي هو أنهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقتهم التي يميلون إليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على ما أنبتت الأرض عظموه وكثر تعجبهم منه وأهلوه للمراتب العظيمة. وزعموا انه ولي الله وصفيه وأنه شبيه بالملك وأنه أرفع طبقة من البشر. ويخضعون له ويذلون غاية الذل ويعدون أنفسهم أشقياء بالإضافة إليه.
والسبب في ذلك هو انهم وإن كانوا من أفن الرأي وسفاهته على ما ترى فإن فيهممن تلك القوة الأخرى الكريمة المميزة وإن كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي الفضائل فيضطرون إلى إكرامهم وتعظيمهم.
قوى النفس الثلاثة
وإذا كانت القوى ثلاثا كما قلنا مرارا فأدونها النفس البهيمية. وأوسطها النفس السبعية. وأشرفها النفس الناطقة. والإنسان إنما صار إنسانا بأفضل هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها باين البهائم.
فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه إليها أتم وأوفر. ومن غلبت عليه إحدى النفسين الأخريين انحط عن مرتبة الإنسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه. فانظر رحمك الله أين تضع نفسك وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات. فإن هذا أمر موكول إليك ومردود إلى اختيارك.
فإن شئت فانزل في منازل البهائم فإنك تكون منهم. وإن شئت فانزل في منازل السباع. وإن شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم. وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة فإن بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب لأن الفرس إنما شرف على الحمار لقبوله الأدب وكذلك في البازي فضيلة على الغراب. وإذا تأملت الحيوان كله وجدت القابل للتأديب الذي هو أثر النطق أعني النفس الناطقة أفضل من سائره وهو يتدرج في ذلك إلى ان يصير إلى الحيوان الذي هو في أفق الإنسان أعني الذي هو أكمل البهائم وهو في أخس مرتبة الإنسانية.
وذلك أن أخس الناس هو من كان قليل العقل قريبا من البهيمية. وهم القوم الذين في أقاصي الأرض المعمورة وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا ينفصلون عن القرود إلا بشيء قليل من التمييز. وبذلك القدر يستحقون إسم الإنسانية. ثم يتميزون ويتزايدون في هذا المعنى حتى يبلغوا إلى وسط الأقاليم، ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل فيصير فيهم العاقل التام والمميز العالم. ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا إلى أن يصيروا إلى غاية ما يمكن للإنسان أن يبلغ إليه من قبول قوة العقل والنطق. فيصير حينئذ في الأفق الذي بين الإنسان والملك ويصير فيهم القابل للوحي
والمطليق لحمل الحكمة فتيض عليه قوة العقل ويسيح إليه نور الحق ولا حالة للإنسان أعلى من هذه ما دام إنسانا.
ثم ارجع القهقري إلى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب الإنسان فإنك تجد القوم الذين تضعف فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذي ذكرنا أنهم في أفق البهائم تقوى فيهم النقص البهيمية فيميلون إلى شواتها المأخوذة بالحواس كالمأكول والمشروب والملبوس وسائر النزوات الشبيهة بها. وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمية حتى يرتكبونها ولا يرتدعوا عنها. وبقدر ما يكون فيهم من القو العاقلة يستحيون منها تى يستتروا بالبيوت ويتواروا بالظلمات إذا هموا بلذة تخصهم.
وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها فإن الجميل بالإطلاق هو الذي يتظاهربه ويستحب إخراجه وإذاعته. وهذا القبح ليس بشيء أكثر من النقصانات اللازمة للبشر. وهي التي يشتاقون إلى إزالتها. وافحشها هو انقصها. و انقصها أحوجها إلى الستر والدفن. ولو سألت القوم الذين يعظمون أمر اللذة ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الإنسانية لم تكتمون الوصول إلى أعظم الخيرات عندكم. وما بالكم تعدون موافقتها خيرا ثم تسترونها؟ أترون سترها وكتمانها فضيلة ومروءة وإنسانية والماهجرة بها وإظهارها بين أهل الفضل وفي مجمع الناس خساساة وقحة؟ – لظهر من انقطاعهم وتبلدهم في الجواب ما تعلم به سوء مذهبهم وخبث سيرتهم. وأقلهم حظا من الإنسانية إذا رأى إنسانا فاضلا احتشمه ووقره وأحب أن يكون مثله إلا الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع ونزارة الإنسانية ووقاحة الوجه إلى أن يقيم على نصرة ما هو عليه من غير محبة لرتبة من أفضل منه.
الواجب على العاقل
فإذا يجب على العاقل أن يعرف ما ابتلى به الإنسان من هذه النقائص التي في جسمه وحاجاته الضرورية إلى إزالتها وتكميلها، أما بالغذاء الذي يحفظ به إعتدال مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله. ولا يطلب اللذة لعينها بل قوام الحياة التي تتبعه اللذة. فإن تجاوز ذلك قليلا فبقدر ما يحفظ رتبته في مروءته. ولا ينسب إلى الدناءة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين الناس، وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحر والبرد ويستر العورة. فإن تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحقر ولا ينسب إلى الشح على نفسه وإلى أن يسقط بين أقرانه وأهل طبقته، وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته، أعني طلب النسل فإن تجاوز ذلك فبقدر مالا يخرج به عن السنة ولا يتعدى ما يملكه إلى ما يملك غيره ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار إنسانا وينظر إلى النقائص التي في هذه النفس خاصة فيروم تكميلها بطاقته وجهده.
فإن هذه الخيرات هي التي لا تستر وإذا وصل إليها لا يمنع عنها الحياء ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات ويتظاهر بها أبدا بين الناس وفي المحافل. وهي التي يكون بها بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر إنسانية من بعض ويغذوا هذه النفس بغذائها الموافق لها المتم لنقصانها كما يغذو تلك بأغذيتها الملائمة لها. فإن غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات والإرتياض بالصدق في الآراء وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء. فمن اتفق له في الصبا أن يربي على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعودها ثم ينظر بعد ذلك في كتب الأخلاق حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين.
ثم ينظر في الحساب والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان فلا يسكن إلا إليها ثم يتدرج (كما رسمناه في كتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم) حتى يبلغ إلى أقصى مرتبة الإنسان فهو السعيد الكامل فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنة الجسيمة. ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوه ثم ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسانا ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد في شعر امرىء القيس والنابغة وأشباههما ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء يقرونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية.
وامتحن بأقران يساعدونه على تناول اللذات الجسمانية. ومال طبعه إلى الإستكثار من المطاعم والملابس والمراكب والزينة وإرتباط الخيل الفره والعبيد الروقة (كما اتفق لي مثل ذلك في بعض الأوقات) ثم انهمك فيها واشتغل بها عن السعادة التي أهل لها – فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيما وخسرانا لا ربحا وليجتهد على التدريج إلى فطام نفسه منها. وما أصعب إلا أنه على كل حال غير من التمادي في الباطل. وليعلم الناظر في هذا الكتاب إن خاصة تدرجت إلى فطام نفسي بعد الكبر واستحكام العادة وجاهدتها جهادا عظيما.
ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالب للأدب الحقيقي بما رضيت لنفسي بل تجاوزت لك في النصيحة إلى أن أشرت عليك بما فاتني في ابتداء أمري لتدركه أنت. ودللتك على طريق النجاة قبل أن تتيه في مفاوز الضلالة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحر المهالك. فالله الله في نفوسكم معاشر الإخوان والأولاد. إستسلموا للحق وتأدبوا بالأدب الحقيقي لا المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا الصراط المستقيم وتصوروا حالات أنفسكم وتذكروا قواها. وأعلموا أن أصح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاث التي مر ذكرها في المقالة الأولى: مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جمعت في مكان واحد ملك وسبع وخنزير. فأيها غلب بقوته قوة البالقين كان الحكم له. وليعلم من تصور هذا المثال أن النفس لما كانت جوهرا غير جسم ولا شيء فيها من قوى الجسم وأعراضه كما بينا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها واتصالها بخلاف اتحاد الأجسام وإتصال بعضها ببعض.
النفوس الثلاثاء وذلك أن هذه الأنفس الثلاث إذا اتصلت صارت شيئا واحدا ومع أنها تكون شيئا واحدا فهي باقية التغاير وباقية القوى تثور الواحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تصل بالأخرى ولم تتحد بها وتستجدي أيضا الواحدة للأخرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها تنفرد بها. وذلك أن إتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلقى سطوحها كما يكون ذلك في الأجسام. بل تصير في بعض الأحوال شيئا واحدا وفي بعض الأحوال أشياء مختلفة بحسب ما تهيج قوة بعضها أو تسكن. ولذلك قال قوم أن النفس واحدة ولها قوى كثيرة. وقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثيرة بالعرض وبالموضوع.
وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب وسيمر بك في موضعه.
وليس يضرك في هذا الوقت أن تعتقد أي هذه الآراء شئت بعد أن تعلم أن بعض هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة عادمة للأدب بالطبع. وليس فيها استعداد لقبول الأدب وبعضها عادمة للأدب. إلا انها تقبل التأدب وتنقاد للتي هي أدبية. أما الكريمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة. وأما العادمة للأدب وهي مع ذلك غير قابلة له فيه النفس البهيمية وأما التي عدمت الأدب ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية وإنما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الأدب. وقد شبه القدماء الإنسان وحاله في هذه الأنفس الثلاث بإنسان راكب دابة قويى يقود كلبا أو فهدا للقنص.
فإن كان الإنسان من بينهم هوالذي يروض دابته وكلبه يصرفهما ويطيعانه في سيره وتصيده وسائر تصرفاته فلا شك في رغد العيش المشترك بين الثلاث وحسن أحواله. لأن الإنسان يكون مرفها في مطالبه يجري فرسه حيث يحب وكما يحب ويطلق كلبه أيضا كذلك. فإذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن القيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية الأعداء وغير ذلك من مصالحهما. وإذا كانت البهيمية هي الغالبة ساءت حال الثلاثة وكان الإنسان مضعوفا عندهما فلم تطع فارسها وغلبت. فإن رأت عشبا من بعيد عدت نحوه وتعسفت في عدوها وعدلت عن الطريق النهج فاعترضتها الأودية والوهاد والشوك والشجر فتقحمتها وتورطت فيها ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه الأحوال فيصيبهم جميعا من أنواع المكاره والإشراف على الهلكة ما خفاء فيه.
وكذلك أن قوى الكلب لم يطع صاحبه فإن رأى من بعيد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ نحوه فجذب الفارس وفرسه ولحق الجميع من الضرر والضر أضعاف ما ذكرناه. وفي تصور هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للإنسان ومكنه منه وعرضه له وما يضيعه بعصيان خالقه تعالى فيه عند إهمال السياسة واتباعه أمر هاتين القوتين وتعيده لهما وهما اللذان ينبغي أن يتبعاه بتأمره عليهما. فمن اسوأ حالا ممن اهمل سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه ترك هذه القوى فيه هائجة مضطربة تتغلب.
وصار الرئيس منها مرؤوسا والملك منها مستعبدا يتقلب معها في المهالك حتى تتمزق ويتمزق معها هو أيضا. نعوذ بالله من الإنتكاس في الخلق الذي سببه طاعة الشيطان واتباع الأبالسة فليست الإشارة بها إلى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها. نسأل الله عصمته ومعونته على تهذيب هذه النفوس حتى ننتهي فيها إلى طاعة الله التي هي نهاية مصالحنا وبها نجاتنا وخلاصنا إلى الفوزالأكبر والنعيم السرمدي.
سياسة النفس العاقلة
وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة وترك سلطان الشهوة يستولي عليها برجل معه ياقوتة حمراء شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة. وكان بين يديه نار تضطرم فرماها في حباحبها حتى صارت كاسا لا منفعة فيها فخسرت فخسرت منافعها. فقد علمنا الآن أن النفس العاقلة إذا عرفت شرف نفسها وأحست بمرتبتها من الله عزوجل أحسنت خلافته في تربية هذه القوى وسياستها ونهضت بالقوة التي أعطاها الله تعالى إلى محلها من كرامة الله تعالى ومنزلتها من العلو والشرف ولم تخضع للسبعية ولا للبهيمية.
بل تقوم النفس الغضبية التي سميناها سبعية ونقودها إلى الأدب بحملها على حسن طاعتها. ثم تستنهضها في أوقات هيجان هذه النفس البهيمية وحركتها إلى الشهوات حتى يقمع بهذه سلطان تلك وتستخدمها في تأديبها وتستعين بقوة هذه على تأبى تلك. وذلك أن هذه النفس الغضبية قابلة للأدب قوية على قمع الأخرىكما ن. وتلك النفس البهيمية عادمة للأدب غير قابلة له. وأما النفس الناطقة أعني العاقلة فهي كمال قال أفلاطون بهذه الألفاظ: أما هذه فبمنزلة الذهب في اللين والإنعطاف.
وأما تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة والإمتناع فإن أنت آثرت الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوة الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما ىثرت الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوى الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما آثرت فاستعن بقوة الغضب التي تثير وتهيج بالأنفة والحمية وأقهر بها النفس البهيمية. فإن غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت فأنت في طريق الصلاح فتمم عزيمتك واحذر أنت أن تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك؟ فإن لم تفعل ذلك ولم تكن العقبة في الغلبة لك كنت كما قال الحكيم الأول: إني أرى أكثر الناس يدعون محبة الفعال الجميلة ثم لا يحتملون المؤنة فيها على علمهم بفضلها فيغلبهم الترفه ومحبة البطالة.
فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الأفعال الجميلة فرق إذا لم يحتملوا مؤنة الصبر ويصبروا إلى تعلم تمام ما آثروه وعرفوا فضله. واذكر مثل البئر التي تردى فيها الأعمى والبصير فيكونان في الهلكة سواء إلا أن الأعمى أعذر. ومن وصل من هذه الآداب إلى مرتبة يعتد بها واكتسب بها الفضائل التي عددنها فقد وجب عليه تأديب غيره وإفاضة ما أعطاه الله على أبناء جنسه.
فصل في تأديب الأحداث والصبيان خاصة نقلت أكثره من كتاب بروسنس
قد قلنا فيما تقدم أن أول قوة تظهر في الإنسان وأول ما يتكون هي القوة التي يشتاق بها إلى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع إلى اللبن يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف أو يحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة والأذى. ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدا إلى الإزدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات. ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق له الشوق إلى الأفعال التي تحصل له هذه.
ثم يحدث له من الحواس قوة على تخيل الأمور ويرتسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق إليها ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشتاق بها إلى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يمنعه من منافعه. فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته انتقم منها وإلا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبككاء. ثم يحدث له الشوق إلى تمييز الأفعال الإنسانية خاصة أولا أولا حتى يصير إلى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقلا. وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الأخرى إلى أن ينتهي إلى الغاية الأخيرة.
وهي التي لا تراد لغاية أخرى وهو الخير المطلق الذي يتشوقه الإنسان من حيث هو إنسان. فأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه. ولذلك قلنا أول ما ينبغي أن يتفرس فيالصبي ويستدل به على عقله. الحياء فإنه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع إحساسه به يحذره ويتجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه. فإذا نظرت إلى الصبي فوجدته مستحيينا مطرقا بطرفه إلى الأرض غير وقاح الوجه ولا محدق اليك فهو أول دليل نجابته والشاهد لك على أن نفسه قد أحست بالجميل والقبيح. وأن حياءه هو انحصار نفسه خوفا من قبيح يظهر منه وهذا ليس بشيء أكثر من إيثار الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل. وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا تترك ومخالطة الأضداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة.
وإن كانت بهذه الحال من الإستعداد لقبول الفضيلة فإن نفس الصبي ساذجة لم تنتقش بعد بصرة وليس لها رأي ولا عزيمة تميلها من شيء إلى شيء فإذا نقشت بصورة وقبلتها نشأ عليها وأعتادها. فالأولى بمثل هذه النفس أن تنبه أبدا على حب الكرامة ولا سيما ما يحصل له منها بالدين دون المال وبلزوم سننه ووظائفه. ثم يمدح الأخيار عنده ويمدح هو في نفسه إذا ظهر شيء جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يظهر منه ويؤاخذ باشتهائه للمآكل والمشارب والملابس الفاخرة ويزين عنده خلق النفس والترفع عن الحرص في المآكل خاصة وفي اللذات عامة. ويجب إليه إيثار غيره على نفسه بالغذاء والإقتصار على لاشيء المعتدل والإقتصاد في التماسه.
الملابس
ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة النساء اللاتي يتزين للرجال ثم العبيد والخول. وأن الأحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبهه حتى يتربى على ذلك ويسمعه كل من يقرب منه ويتكرر عليه ولم يترك مخالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته لا سيما من أترابه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلاعبه.
وذلك أن الصبي في ابتداء نشوه يكون على الأكثر قبيح الأفعال إما كلها وإما اكثرها فإنه يكون كذوبا ويخبر ويحكي ما لم يسمعه ولم يره ويكون حسودا سروقا نماما لجوجا ذا فضول أضر شيء بنفسه وبكل أمر يلابسه. ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجار حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال. فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلا بما ذكرناه وبذكره. ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوده بالأدب حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمناه ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يوهمه أصحابها، إنه ضرب من الظرف ورقة الطبع. فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جدا. ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه.
فإن خالف في بعض الأوقات ما ذكرته فالأولى أن لا يوبخ عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ولا هم به لا سيما أن ستره الصبي واجتهد في أن يخفى ما فعله عن الناس فإن عاد فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما أتاه. ويحذر من معاودته فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة وحرضته على معاودة ما كان استقبحه وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات التي تدعو إليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا.
آداب المطاعم
والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها آداب المطاعم فيفهم أولا انها إنما تراد للصحة لا للذة، وأن الأغذية كلها إنما خلقت وأعدت لنا لتصح بها أبداننا وتصير مادة حياتنا. فهي تجري مجرى الأدوية ليتداوي بها الجوع والألم الحادث منه. فكما أن الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة فكذلك الأطعمة لا ينبغي أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحة البدن ويدفع ألم الجوع ويمنع من المرض. فيحفر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشره ويقبح عنده صورة من شره غليه وينال منه فوق حاجة بدنه أو مالا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد. ولا يرغب في الألوان الكثيرة. وإذا جلس مع غيره لا يبادر إلى الطعام ولا يديم النظر إلى ألوانه ولا يحدق إليه شديدا.
ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الأكل ولا يوالي بين اللقم بسرعة. ولا يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها. ولا يلطخ يده ولا ثوبه ولا يلحظ من يؤاكله ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام. ويعود أن يؤثر غيره بما يليه إن كان أفضل ما عنده ثم يضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدونه. ويأكل الخبز القفار الذي لا أدم معه في بعض الأوقات وهذه الآداب وإن كانت جميلة بالفقراء فهي بالأغنياء أفضل وأجمل. وينبغي أن يستوفي غذاه بالعشي فإن استوفاه بالنهار كسل واحتاج إلى النوم وتبلد فهمه مع ذلك.
وإن منع اللحم في أوقاته كان أنفع له وقعا في الحركة والتيقظ وقلة البلادة وبعثه على النشاط والخفة. وأما الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها ألبتة إن أمكن. وإلا فليتناول أقل ما يمكن فإنها تستحيل في بدنه فتكثر إنحلاله وتعوده مع ذلك على الشره ومحبة الإستكثار من المآكل. ويعود أن لا يشرب في خلال طعامه الماء. فإما النبيذ وأصناف الأشربة المسكرة فإياها وإياها فإنها تضره في بدنه ونفسه وتحمله على سرعة الغضب والتهور والإقدام على القبائح والقحة وسائر الاخلال المذمومة.
آداب متنوعة
ولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل اللهو وإن كان أهل المجلس أدباء فضلاء. وأما غيرهم فان ضرره واضح فانه يسمع الكلام القبيح والسخافات التي تجري فيه.
وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الأدب التي يتعلمها ويتعب تعبا كافيا. وينبغي أن يمنع من كل فعل يستره ويخفيه فإنه ليس يخفى شيئا إلا وهو يظن أو يعلم أنه قبيح. ويمنع من النوم الكثير فإنه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره. هذا بالليل فأما بالنهار فلا ينبغي أن يتعوده ألبتة. ويمنع أيضا من الفراش الوطيء ويمنع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه ويتعود الخشونة ولا يتعود الخيش والأسراب في الصيف ولا الأوبار والنيران في الشتاء للأسباب التي ذكرناها. ويعود المشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يتعود أضدادها.
ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع في المشي ولا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره ولا يربي شعره. ولا يتزين بملابس النساء ولا يلبس خاتما إلا وقت حاجته إليه. ولا يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه من مآكله وملابسه وما يجري مجراه ولا يشين أحدا، بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره.
ولا يتوصل بشرف إن كان له أو سلطان من أهله إن اتفق إلى غضب من هو دونه أو استهداء من لا يمكنه أن يرده عن هواه أو تطاوله عليه. كمن اتفق له إن كان خاله وزيرا أو عمه سلطانا فتطرق به إلى هضيمة أقرانه وثلم أخوانه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره. ولا يضع رجلا على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه بيده.
فإن هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به القبيح إلى أن لا يحمل رأسه حتى يستعين بيده. ويعود أن لا يكذب ولا يحلف البتة لا صادقا ولا كاذبا. فإن هذا قبيح بالرجال مع الحاجة إليه في بعض الأوقات فأما الصبي فلا حاجة به إلى اليمين. ويعود أيضا قلة الكلام فلا يتكلم إلا جوابا. وإذا حضر من هو أكبر منه اشتغل بالاستماع منه والصمت له. ويمنع من خبيث الكلام وهجينه ومن السب واللعن ولغو القول. ويعود حسن الكلام وظريفه وجميل اللقاء وكريمه ولا يرخص له أن يستمع لاضدادها من غيره. ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان أكبر منه.
وأحوج الصبيان إلى هذا الأدب أولاد الأغنياء والمترفين. وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشفع بأحد فإن هذا فعل المماليك ومن هو خوار ضعيف. ولا يعير أحدا إلا بالقبيح والسيء من الأدب. ويعود أن لا يوحش الصبيان. بل يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه لئلا يتعود الريح على الصبيان وعلى الصديق. ويبغض إليه الفضة والذهب ويحذر منهما أكثر من تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعي. فإن حب الفضة والذهب آفته أكثر من آفات السموم. وينبغي أن يؤذن له في بعض الأوقات أن يلعب لعبا جميلا ليستريح إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد.
ويعود طاعة والديه ومعلميه ومؤديه وإن ينظر اليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم. وهذه الآداب النافعة للصبيان هي للكبار من الناس أيضا نافعة ولكنها للأحداث أنفع لأنها تعودهم محبة الفضائل وينشأون عليها فلا يثقل عليهم تجنب الرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك جمثيع ما ترسمه الحكمة وتحده الشريعة والسنة. ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من الذات القبيحة وتكفهم عن الإنهماك في شيء منها والفكر الكثير فيها.
وتسوقهم إلى مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم إلى معالي الأمور التي وصفناها في أول الكتاب من التقرب إلى الله عز وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الحال في الدنيا وطيب العيش وجميل الأحدوثة وقلة الأعداء وكثرة المداح والراغبين في مودته من الفضلاء خاصة. فإذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه إلى أن يفهم أغراض الناس وعواقب الأمور فهم أن الغرض الأخير من هذه الأشياء التي يقصدها الناس ويحرصون عليها من الثروة وإقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشباه ذلك إنما هو لراحة البدن وحفظ صحته. وأن يبقى على إعتداله مدة ما. وأن لا يقع في الأعراض ولا تفجأه المنية. وأن يهنأ بنعمة الله عليه ويستعد لدار البقاء
والحياة السرمدية. وأن اللذات كلها في الحقيقة هي خلاص من آلام وراحات من تعب. فإذا عرف ذلك وتحققه ثم تعوده بالسيرة الدائمة وعود الرياضات التي تحرك الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البلادة وتبعث النشاط وتذكي النفس. فمن كان ممولا مترفا كانت هذه الأشياء التي رسمتها أصعب عليه لكثرة من يحتف به ويغويه ولموافقة طبيعة الإنسان في أول ما تنشأ هذه اللذات وإجماع جمهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم.
فأما الفقراء فالأمر عليهم أسهل بل هم قريبون إلى الفضائل قادرون عليها متمكنون من نيلها والإصابة منها. وحال المتوسطين من الناس متوسطة بين هاتين الحالتين. وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون أولادهم بين حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من الأحوال التي ذكرناها ومن سماع ما حذرت منه. وكانوا ينفذونهم مع ثقاتهم إلى النواحي البيعدة منهم. وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التنعم ولا الترفه وأخبارهم في ذلك مشهورة. وكثير من رؤسائهم في زماننا هذا ينقلون أولادهم عندما ينشأون إلى بلادهم ليتعودوا بها هذه الطرق المحمودة في تأديب الأحداث فقد عرفت أضدادها.
أعني أن يشتغل بصلاحه وتقويمه فإنه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي الذي لا يطمع في رياضته فإن نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي منهمكة في مطالبها من النزوات. وكما أنه لا سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب كذلك لا سبيل إلى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلا في السن. اللهم إلا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته ذا مالها عائبا على نفسه عازما على الإقلاع والإنابة.
فإن مثل هذا الإنسان من يرجى له النزوع عن أخلاقه بالتدريج والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبةب الأخيار وأهل الحكمة وبالأكباب على التفلسف. وإذ قد ذكرنا الخلق المحمود وما ينبغي أن يؤخذ به الأحداث والصبيان فنحن واصفون جميع القوى التي تحدث لليحوان أولا أولا إلى أن ينتهي إلى أقصى الكمال في الإنسانية فإنك شديد الحاجة إلى معرفة ذلك لتبتديء على الترتيب الطبيعي في تقويم واحد منها فنقول:
الأجسام الطبيعية
إن الأجسام الطبيعية كلها تشترك في الحد الذي يعمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التي تحدث فيها. فإن الجماد منها إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التي لا تقبل تلك الصورة. فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد.
وتلك الزيادة هي الإغتذاء والنمو والإمتداد في الإقطار وإجتذاب ما يوافقه من الأرض والماء وترك ما لا يوافقه ونفض الفضلات التي تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ. وهذه الأشياء التي ينفصل بها النبات من الجماد. وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف بها على الجماد تتفاضل: وذلك أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة كالمرجان وأشباهه. ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبزر. ويكفيه في حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس فلذلك هو في أفق الجمادات وقريب الحال منها. ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الأثمار وحفظ النوع بالبزر الذي يخلف به مثله فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله. ثم تقوى هذه الفضيلة فيه حتى يصير بعضه على بعض حتى يبلغ إلى أفقه ويصير في أفق الحيوان.
وهي كِرَامُ الشجر كالزيتون والرمان والكرم وأصناف الفواكه إلا أنها بعد مختلطة القوى أعني أن قوى ذكورها وإناثها غير متميزة فهي تحمل وتلد المثل ولم تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق الحيوان. ثم تزداد وتمعن في هذا الأفق إلى ان تصير في أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة. وذلك أنها أن قبلت زيادة يسيرة صارت حيوانا وخرجت عن أفق النبات. فحينئذ تتميز قواها ويحصل فيها ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل الحيوان أمورا تتيمز بها عن سائر النبات والشجر كالنخل الذي طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها ولم يبق بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة وهي الإنقلاع من الأرض والسعي إلى الغذاء.
وقد روى في الخبر ما هو كالإشارة أو كالرمز إلى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {أكرموا عماتكم النخل فإنها خلقت من بقية طينة آدم} فإذا تحرك النبات وانقلع من أفقه وسعى إلى غذائه ولم يتقيد في موضعه إلى أن يصير إليه غذاؤه وكونت له آلات أخر يتناول بها حاجاته التي تكمله فقد صار حيوانا.
وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من أول أفقه وتتفاضل فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كان ذلك في النبات فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة الشعور باللذة والأذى فيلتذ بوصوله إلى منافعه ويتألم بوصول مضاره إليه. ثم يقبل الهام الله عز وجل إياه فيهتدي إلى مصالحه فيطلبها وإلى أضداده فيهرب منها. وما كان من الحيوان في أول أفق النبات فإنه لا يتزاوج ولا يخلف المثل بل يتوالد كالديدان والذباب وأصناف الحشرات الخسيسة.
ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات سواء.
ثم تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطي من السلاح بحسب قوته وما يطيق استعماله. فإن كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحه تاما قويا. وإن كانت ناقصة كان ناقصا وإن كانت ضعيفة جدا لم يعط سلاح ألبتة بل أعطى آلة الهرب كشدة العدو والقدوة على الحيل التي تنجيه من مخاوفه. وأنت ترى ذلك عيانا من الحيوان الذي أعطى القرون التي تجري له مجرى الرماح.
والذي أعطى الأنياب والمخالب التي تجري له مجرى السكاكين والخناجر. والذي أعطى آلة الرمى التي تجري له مجرى النبل والنشاب. والذي اعطى الحوافر التي تجري له مجرى الدبوس والطبرزين.
فأما ما لم يعط سلاحا لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية ولأنه لو أعطيه لصار كلا عليه فقد أعطى آلة الهرب والحيل بجودة العدو والخفة والختل والمراوغة كالأرانب وأشباهها. وإذا تصفحت أحوال الموجودات من السباع والوحش والطير رأيت هذه الحكمة مستمرة فيها فتبارك الله أحسن الخالقين لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فأما الإنسان فقد عوض من هذه الآلات كلها بان هدى إلى استعمالها كلها وسخرت هذه كلها له وسنتكلم على ذلك في موضعه. فأما أسباب هذه الأشياء كلها والشكوك التي تعترض في قصد بعضها بعضا بالتلف والأنواع من الأذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها أن أخر الله في الأجل عند بلوغنا إلى الموضع الخاص بها.
مراتب الحيوان
ونعود إلى ذكر مراتب الحيوان فنقول: أن ما أهدى منها إلى الإزدواج وطلب النسل وحفظ الولد وتربيته والإشفاق عليه بالكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته إما باللبن وإما بنقل الغذاء إليه فإنه أفضل مما لا يهتدي إلى شيء منها. ثم لا تزال هذه الأحوال تتزايد في الحيوان حتى يقرب من أفق الإنسان فحينئذ يقبل التأديب ويصير بقبوله للأدب ذا فضيلة يتميز بها من سائر الحيوانات.
ثم تتزايد هذه الفضيلة في الحيوانات حتى يشرف بها ضروب الشرف كالفرس والبازي المعلم. ثم يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذي يحاكي الإنسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقردة وما أشبهها ويبلغ من ذكائها ن تستكفي في التأدب بأن ترى الإنسان يعمل عملا فتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان إلى تعب بها ورياضة لها وهذه غاية أفق الحيوان التي أن تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه وصار في أفق الإنسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور التي تلائمها. فإذا بلغ هذه الرتبة تحرك إلى المعارف واشتاق إلى العلوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقي والإمعان في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب الأخرى التي ذكرناها،
وأول هذه المراتب من الأفق الإنساني المتصل بآخر ذلك الأفق الحيواني مراتب الناس الذين يسكنون في أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب كأواخر الترك من بلاد يأجوج ومأجوج وأواخر الزنج وأشباههم من الأمم التي لا تميز عن القرود إلا بمرتبة يسيره. ثم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات.
ثم يستعد بهذا القبول لإكتساب الفضائل واقتنائها بالإرادة والسعي والإجتهاد الذي ذكرناه فيما تقدم حتى يصل إلى آخر أفقه فإذا صار إلى آخر افقه اتصل بأول أفق الملائكة وهذا أعلى مرتبة الإنسان وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أولها بآخرها. وهو الذي يسمى دائرة الوجود لأن الدائرة هي التي قيل في حدها إنها خط واحد يبتدىء بالحركة من نقطة وينتهي إليها بعينها ودائرة الوجود هي المتأحدة التي جعلت الكثرة وحدة. وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية على موجدها وحكمته وقدرته ووجوده تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره. ولولا أن شرح هذا الموضوع لا يليق بصناعة تهذيب الأخلاق لشرحته وأنت تقف عليه إن بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله.
وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه وفهمته اطلعت على الآلة التي خلقت وندبت إليها وعرفت الأفق الذي يتصل بأفقك وتنقلك في مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقا عن طبق وحدث لك الإيمان الصحيح وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة التي مبدؤها تعلم المنطق فإنه الآلة في تقويم الفهم والعقل الغريزي.
ثم الوصول به إلىمعرفة الخلائق وطباعها ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها إلى العلوم الإلهية وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عزوجل وعطاياه فيأتيك الفيض الإلهي فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولا فأولا من مراتب الموجودات. وعلمت ان كل مرتبة منها محتاجة إلى قبلها في وجودها وعلمت أن الإنسان لا يتم له كماله إلا بعد أن يحصل له ما قبله وإذا صار إنسانا كاملا وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى عليه وصار إما حكيما تاما تأتيه الإلهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكمية والتأييدات العلوية في التصويرات العقلية وإما نبيا مؤيدا يأتيه الوحي على ضروب المنازل التي تكون له عند الله تعالى ذكره.
فيكون حينئذ واسطة بين الملأ الأعلى والملأ الأسفل. وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل إليها من حال الإنسية ومطالعة الآفاق التي ذكرناها. وحينئذ يفهم عن الله عزوجل قوله (فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين) وتصور معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هناك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) وإذا بلغ الكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهل الإنسان لها ونسقنا أحواله التي يترقى فيها وأنه يكون أولا بالشوق إلى المعارف والعلوم فينبغي أن نزيد في بيانه وشرحه فنقول:
الشوق إلى المعارف والعلوم
إن هذا الشوق ربما ساق الإنسان على منهج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي إلى غاية كماله وهي سعادته التامة. وقلما يتفق ذلك وربما اعوج به عن السمت والسنن وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بك إلى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك. فكما أن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت إلى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق إلى أكل الطين وما جرى مجراه مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده. كذلك أيضا النفس الناطقة ربما اشتاقت إلى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها إلى الأشياء التي تعوقها وتقصر بها عن كمالها فيحينئذ يحتاج إلى علاج نفساني روحاني كما احتاج في الحالة الأولى إلى طب طبيعي جسماني. ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين وإلى المؤدبين والمسددين.
فإن وجود تلك الطبائع الفائقة التي تنساق بذاتها منغير توفق إلى السعادة عسرة الوجود ولا توجد إلا في الأزمنة الطوال والمدد البعيدة. وهذا الأدب الحق الذي يؤدينا إلى غايتنا يجب أن تلحظ فيه المبأ الذي يجري مجرى الغاية حتى إذا لحظت الغاية تدرج منها إلى الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدىء من أسفل على طريق التركيب فيسلك فيها إلى أن ينتهي إلى الغاية التي لحظت أولا. وهذا المعنى هو الذي أحوجنا في مبدأ هذا الكتاب وفي فصول أخر منه أن نذكر أشياء عالية لا تليق بهذه الصناعة ليتشوق إليها من يستحقها. وليس يمكن الإنسان أن يشتاق إلى ما لا يعرفه ألبتة. فإذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة فتشوقها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب فيها. وينبغي أن يعلم أن كل إنسان معد نحو فضيلة ما فهو إليها أقرب وبالوصول إليها أحرى. ولذلك لا تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر غلا من اتفق له نفس صافية وطيعية فائقة فينتهي إلى غايات الأمور وعلى غاياتها أعني السعادة القصوى التي لا سعادة بعدها.
الواجب على الحاكم
ولأجل ذلك يجب على مدبر المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته التي تخصه ثم يقسم عنايته بالناس ونظره لهم بقسمين: أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية. والأخر في تسديدهم نحو الصناعات والأعمال الحسية. وإذا سددهم نحو السعادة الفكرية بدأبهم من الغاية الأخيرة على طريق التحليل ووقف يهم عند القوي التي ذكرناها. وإذا سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم من عند هذه القوي وانتهى بهم إلى تلك الغاية.
رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله
خطبةُ الرسالة
بسمِ اللّهِ الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والعاقبةُ للمتّقين، والصلاة والسلام على نبيّه محمّد وآله أجمعين.
اعلم، أنَّ واحدا من الطلبة المتقدّمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجّة الإسلام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي رحمه اللهُ تعالى، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم، واستكمل من فضائل النفس، ثم إنه فكَّر يوما في حال نفسه وخطر على باله، فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم، وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها. فالآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤانسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركه، فقد قال رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: “اللّهمّ إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع” ، فاستمرّت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجّة الإسلام محمّد الغزالي رحمةُ اللّهِ تعالى عليه استفتاء، وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحةً ودعاء، وقال: وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدى عمري إن شاء اللّهُ تعالى، فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه:
اعلم أيها الولد المحب أطال اللّهُ بقاءك بطاعته، وسلك بك سبيل أحبائه أنَّ منشور النصيحة يُكتَبُ من معدن الرسالة. وأنَّ نبينا عليه الصلاة والسلام إن كان قد بلغك منه نصيحةٌ فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك منه فقل لي ما ذا حَصَّلتَ في هذه السنين الماضية.
أيها الولد: من جملة ما نصح به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمته قوله: “علامة إعراض اللّه عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإنّ امرُأٌ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خُلِقَ لهُ لَجَديرٌ أن تطولَ عليه حسرته، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شرّه فليتجهّز إلى النّار” ، وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم.
أيها الولد: النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق مُتَّبِعي الهوى مُرَّةٌ إذ المناهي محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغل في فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المُجرّدَ به سيكون نجاته وخلاصه فيه، وإنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان اللّه العظيم ألا يعلم هذا المغرور أنه حين حَصَّلَ العلم إذا لم يعمل به تكون الحُجّة عليه آكد، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “أشدّ الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه اللّه بعلمه” .
و روي أن الجٌنيد رحمه اللّه رُئِيَ في المنام بعد موته، فقيل له: ما الخَبَرُ يا أبا القاسم؟ قال:
طاحت تلك العبارات، وفَنِيَت تلك الإشارات وما نفعنا إلا رُكَيعاتٍ ركعناها في جوف الليل.
أيها الولد: لا تكن من الأعمال مفلسا، ولا من الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد، مثاله: لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب، فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلّمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل، ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجَبِينِ والكِشكابِ فلا يحصل البرء إلا باستعمالها .
و لو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب، لا تكون مستعدا لرحمة اللّه تعالى إلا بالعمل:
وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى، فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ، جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا* خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا، إِلَّا مَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً. وما تقول في هذا الحديث: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا” . والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل اللّه تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة اللّه قريب من المحسنين، ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا: نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ فأوّل تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل، هل يكون خائنا مفلسا؟ وقال الحسن البصري: يقول اللّه تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم.
أيها الولد: ما لم تعمل لم تجد الأجر.
حكي أن رجلا من بني إسرائيل عَبَدَ اللّهَ تعالى سبعين سنةً فأرادَ اللّهُ تعالى أن يَجلوه على الملائكة فأرسلَ اللّهُ إليه مَلَكا يُخبره أنه مع تلك العبادة لا يَليق به دُخول الجنة، فلما بلغه قال العابد: نحن خُلِقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده، فلما رجع الملك قال: إلهي أنت أعلم بما قال، فقال اللّه تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا” . وقال علي رضي اللّه عنه: (من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن) . وقال الحسن رحمه اللّه تعالى: (طلب الجنة بلا عمل ذَنْبٌ من الذنوب) . وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
“الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتّبع هواه وتمنّى على اللّه تعالى الأماني” .
أيها الولد: كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمّارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال شعرا:
سهر العيون لغير وجهك ضائع … و بكاؤهنّ لغير فقدك باطل
أيها الولد: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.
أيها الولد: أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام، والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال، إني رأيت في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل اللّه بعظمته منه أربعين سؤالا، للّه أوّله يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري، أما أنت أصم لا تسمع.
أيها الولد: العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون.
و اعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدا عن نار جهنم، وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيّام الماضية تقول غدا يوم القيامة، فارجعنا نعمل صالحا، فيقال: يا أحمق أنت من هناك تجيء.
أيها الولد: اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم، إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد، وقال أبو بكر الصدّيق رضي اللّه عنه: هذه الأجساد قفص الطيور، واصطبل الدوابّ، فتفكر في نفسك من أيهما أنت، إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “اهتزّ عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ” . والعياذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال اللّه تعالى:
أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ . فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار، وروي أن الحسن البصري رحمه اللّه تعالى أُعطيَ شربة ماء بارد فأخذ القَدَح وغُشي عليه وسَقط من يده، فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرتُ أُمنيةَ أهلِ النارِ حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه.
أيها الولد: لو كان العلم المُجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عملٍ سواهُ، لكان نداءُ: هل من سائلٍ، هل من مُستغفرٍ، هل من تائبٍ ضائعاُ، بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين ذَكروا عبد اللّه بن عمر عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: “نعم الرّجل هو، لو كان يصلّي باللّيل ” وقال عليه السلام لرجل من أصحابه:” يا فلان لا تُكثر النوم بالليل، فإنّ كثرة النوم بالليل يَدعُ صاحبه فقيرا يوم القيامة “.
أيها الولد: ومن الليل فتهجد به: أمرٌ، وبالأسحار هم يستغفرون: شُكرٌ، والمستغفرون بالأسحار: ذِكرٌ. قال عليه السلام: “ثلاثةُ أصوات يحبّها اللّه تعالى: صوت الدِّيكِ، وصوت الّذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار” . قال سفيان الثوري، رحمة اللّه تعالى عليه: إن اللّه تبارك وتعالى خلق ريحاً بالأسحار تَحمل الأذكارَ والاستغفارَ إلى المَلِك الجَبَّار، وقال أيضا: إذا كان أوّل الليل ينادي منادٍ من تحت العَرشِ: ألا لِيقم العابدون فيقومون ويُصلونَ ما شاء اللّه، ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا لِيَقُم القانتون، فيقومون ويُصلّون إلى السحر، فإذا كان السحر نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون، فإذا طَلع الفَجر نادى منادٍ: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نُشِرُوا من قبورهم.
أيها الولد: روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني لا يكونن الدِّيكُ أكيَسَ منك ينادي بالأسحارِ وأنت نائم، ولقد أحسن من قال شعرا:
لقد هَتَفَتْ في جُنح الليلِ حَمامة … على فَنَنٍ وَهْنَاً وإنّي لَنائم
كذبتُ وبيتُ اللّه لو كنتُ عاشقاً … لما سبقتني بالبكاء الحمائم
و أزعُمُ أنّي هائمٌ ذو صَبابة … لِرَبي فلا أبكي، وتبكي البهائم
أيها الولد: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي.
اعلم: أن الطّاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي، بالقول والفعل. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك ويكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صلّيت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم.
أيها الولد: ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة، وينبغي لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات.
و اعلم، أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيي قلبك بأنوار المعرفة.
و اعلم، بأن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق. كما حكي أن فاقد الذوق كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة العسل كيف تكون، فكتب له في جوابه: يا فلان إني كنت حسبتك مريضا فقط. الآن عرفت أنك مريضٌ وأحمق. لأن هذه اللذة ذوقية. إن تصل إليها تُعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة.
أيها الولد: بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره. وتذكر هاهنا نبدأ منه ونشير إليه فنقول: قد وجب على السالك أربعة أمور:
الأمر الأوّل: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة.
و الثاني: توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلّة.
و الثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حقّ.
و الرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر اللّه تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة.
حكي أن الشبلي رحمه اللّه خدم أربعمائة أستاذ، وقال: قرأت أربعة آلاف حديث، ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه. وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به، وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لبعض أصحابه: “اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل للّه بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها” .
أيها الولد: إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير، وتأمّل في حكاية أخرى:
و ذلك أن حاتِماً الأصَمّ كان من أصحاب الشَّقيقِ البَلْخيِّ رحمة اللّه تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها؟ قال: حصلت ثماني فوائد من العلم وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها، فقال شقيق: ما هي! قال حاتم الأصمّ:
الفائدة الأولى: إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد، فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري، وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا.
الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأمّلت قوله تعالى: وأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة اللّه سبحانه وتعالى وانقادت.
الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه، فتأمّلت في قوله تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه اللّه تعالى، ففرّقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند اللّه تعالى.
الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغترّ بهم، وزعم آخر أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف
و العزّ في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، وتأمّلت في قوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ.
فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حقّ صادق وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل.
الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذمّ بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأمّلت في قوله تعالى: نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا. فعلمت أن القسمة كانت من اللّه تعالى في الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة اللّه تعالى.
الفائدة السادسة: إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأمّلت قوله تعالى:
إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا . فعلمت أنه لا يجوز عداوة آخر غير الشيطان.
و الفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام، ويذل نفسه، وينقص قدره، فتأمّلت في قوله تعالى وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها. فعلمت أن رزقي على اللّه تعالى، وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه.
الفائدة الثامنة: إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله، فتأمّلت في قوله تعالى: ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً [الطلاق: 3] . فتوكّلت على اللّه تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل، فقال شقيق: وفقك اللّه تعالى إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة.
أيها الولد: قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبيّن ما يجب على سالك سبيل الحق.
فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق السيّئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بدّ للسالك من شيخ يؤديه ويرشده إلى سبيل اللّه تعالى، لأن اللّه أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى اللّه عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى اللّه تعالى، وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه وأن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، وإني أبيّن لك بعض علامته على سبيل الإجمال حتى لا يدّعي كل أحد أنه مرشد.
فنقول: من يعرض عن حبّ الدنيا وحبّ الجاه، وكان قد تابع لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيّد
المرسلين صلى اللّه عليه وسلم وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم، وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكّل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأنّي وأمثالها، فهو إذا نور من أنوار النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يصلح للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعزّ من الكبريت الأحمر، ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أمّا احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأمّا احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا لئلا يتّسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجنّ والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشيطنة، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ثم اعلم، أن التصوّف له خصلتان: الاستقامة والسكون عن الخلق، فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة أن يفدي حظّ نفسه لنفسه، وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع، ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء أحدها: محافظة أمر الشرع، وثانيها: الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة اللّه تعالى، وثالثها: ترك رضاء نفسك في طلب رضاء اللّه تعالى، وسألتني عن التوكّل هو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها للّه تعالى ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم. واعلم، أن الرياء يتولّد من تعظيم الخلق، وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقّة لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء.
أيها الولد: والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه منه وكتابة بعضها حرام، اعمل أنت بما تعمل ليكشف لك ما لم تعلم.
أيها الولد: بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان قوله تعالى: ولَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ . واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. ولا تستعجل حتى تبلغ أو أنه يكشف لك وتراه: سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ . فلا تسألني قبل الوقت: وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير لقوله تعالى: أَ ولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا.
أيها الولد: بالله إن تسر تر العجائب في كل منزل، وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح كما قال ذو النون المصري رحمه اللّه تعالى لأحد من تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية.
أيها الولد: إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القيامة، تعمل منها أربعة، وتدع منها أربعة أما اللواتي تدع:
أحدها: أن لا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت لأن فيها آيات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها، نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما: أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية: أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ، واسمع إني أذكر لك هاهنا فائدة. واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم: أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلّة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه تضييع العمر، ثم اعلم، أن مرض الجهل على أربعة أنواع:
أحدها: يقبل العلاج والباقي لا يقبل أما الذي لا يقبل “أحدها” من كان سؤاله واعتراضه عن حسده وبغضه فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا، فالطريق أن لا تشغل بجوابه فقد قيل:
كلّ العداوة قد ترجى إزالتها … إلّا عداوة من عاداك عن حسد
فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه، قال اللّه تعالى: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا ولَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا [النجم: 29] . والحسود بكل ما يقول ويفعل أوقد النار في زرع علمه، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
و الثاني: أن تكون علته من الحماقة وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق، وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لم يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير، فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي أن لا يشتغل بجوابه.
و الثالث: أن يكون مسترشدا وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم” . وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحبّ
الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنّت وامتحان، وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته.
و الرابع: مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظا ومذكرا لأن فيه آفة كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام، يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتّعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين:
الأولى: عن التكلّف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار لأن اللّه تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلّف المتجاوز عن الحدّ يدل على خراب الباطن وغفلة القلب، ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة وموابقها، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية، ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى تذكيرا وإعلامهم الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم التمس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة اللّه تعالى، هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظا كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها فتقول: الحذر الحذر، فرّوا من السيل وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكليف العبارات والنكت والإشارات فلا تشتهي البتة فكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها.
و الخصلة الثانية: أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويظهروا الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولّد من الغفلة، بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعي فيما لا يرضى اللّه تعالى به، والاستعثار بالأخلاق الردية فألق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، ولعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، وينظروا الحرص والرغبة في الطاعة، والرجوع عن المعصية، وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم. فيجب عليهم أن يفروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمله الشيطان، ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و الثالث: مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين، ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالسهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن اللّه تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا بطول بقائهم فقد أحبّ أن يعصى اللّه في أرضه.
و الرابع: مما تدع أن لا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين وأقلّ مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببته ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظالم على عباد اللّه تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا الدين والعاقبة، وإياك وإياك أن يخدعك استهواء الشياطين أو قال بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثيرة من الناس بهذه الوسوسة. وقد ذكرناه في إحياء العلوم فاطلبه ثمة.
و أما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها:
الأول: أن تجعل معاملتك مع اللّه تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا للّه تعالى وهو سيّدك الحقيقي.
و الثاني: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحبّ لنفسه.
و الثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكّي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس، والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكّي نفسك عن الأخلاق الذميمة وتشتغل بمحبة اللّه تعالى وعبادته، والاتّصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه.
أيها الولد: اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيرا. اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها، والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفي، أ ليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “إنّ اللّه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونيّاتكم” . وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفاتي. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدي به فرائض اللّه تعالى وهو يوفّقك حتى تحصله.
و الرابع: أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعدّ ذلك لبعض حجراته، وقال: “اللّهمّ اجعل قوت آل محمّد كفافا” . ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا، وأمّا من كانت صاحبة يقين ما كان يعدّ لها أكثر من قوت يوم ونصف.
أيها الولد: إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك، وأمّا الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا أعقاب صلواتك، اللهمّ إنّي أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمّه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه، اللهمّ كن لنا ولا تكن علينا، اللهمّ اختم بالسعادة آجالنا، وحقّق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومنّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكّلنا واعتمادنا، اللهمّ ثبّتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفّف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفّار يا كريم يا ستّار يا عليم يا جبّار يا اللّه يا اللّه يا اللّه برحمتك يا أرحم الرّاحمين، ويا أوّل الأوّلين، ويا آخر الآخرين ويا ذا القوّة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين والحمد للّه ربّ العالمين.
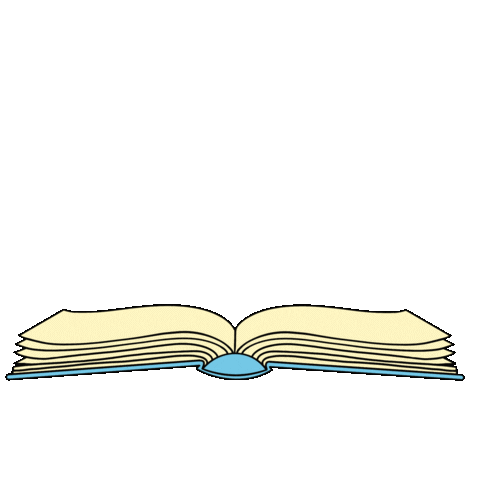
كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين
افلاطون الالهي وارسطوطاليس
للشيخ الامام الملقب بالمعلم الثاني ابي نصر الفارابي
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمدُ لِوَاهِبِ العقل ومبدعه ، ومصور الكل ، ومخترعه ، كَفاءَ احسانه القديم وأفضاله. والصلاة على سيد الانبياء محمد وآله.
فهرس الكتاب
1 ـ غرض الكتاب
2 ـ حد الفلسفة وابداعا
3 ـ موضوعات الفلسفة
4 ـ أرسطو ينشيء علم المنطق
5 ـ اجماع العلوم المختلفة حُجّة ً
6 ـ عيوب الاستقراء
7 ـ اختلاف سيرتي افلاطون وارسطو لم يؤد إلي اختلاف آرائهما السياسية والخلقية
8 ـ منهجا افلاطون وارسطو مختلفان في الظاهر ومتفقان في الغاية
9 ـ لا خلاف بين افلاطون وارسطو في تفضيل الجواهر
10 ـ القسمة التي اعتمدها افلاطون لم يهملها أرسطو
11 ـ لا خلاف بين افلاطون وارسطو حول القياس
12 ـ الخلاف بين افلاطون وارسطو حول البصر لفظي فقط
13 ـ الأخلاق عند ارسطو وافلاطون مكتسبة وليست طباعاً
14 ـ المعرفة عند افلاطون تذكر وعند ارسطو احساس ومع ذلك لا خلاف بينهما
15 ـ العالم حادث عند افلاطون وارسطو
16 ـ المثل قال بها افلاطون وارسطو على السواء
17 ـ قول افلاطون وارسطو بالدينونة
18 ـ الخاتمة
1 ـ غرض الكتاب
اما بعد ، فاني لما رأيت اكثر اهل زماننا قد تحاضّوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه ، وادَّعَوا أنّ بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الاوّل ، وفي وجود الاسباب منه ، وفي امر النفس والعقل ، وفي المجازات على الافعال خيرها وشرّها ، وفي كثير من الامور المدنية والخلقية والمنطقية؛ اردت ، في مقالتي هذه ، ان اشرع في الجمع بين رأييهما ، والابانة عمّا يدلّ عليه فحوى قوليهما ، ليظهر الاتّفاق بين ما كانا يعتقدانه ، ويزول الشك والإرتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما ، وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما ، لأنَّ ذلك من اهمّ ما يقصد بيانه ، وانفع ما يراد شرحه وايضاحه.
2 ـ حد الفلسفة ، وابداع افلاطون وارسطو لها
اذ الفلسفة ، حدها وماهيتها ، انَّها العلم بالموجودات بما هي موجودة . وكان هذان الحكيمان هما مبدعان للفلسفة ، ومنشئان لأوائلها واصولها ، ومتممان لأواخرها وفروعها ، وعليهما المُعوّلُ في قليلها وكثيرها ، واليهما المرجع في يسيرها وخطيرها. وما يصدر عنهما في كل فنّ انما هو الاصل المعتمد عليه ، لخلوّه من الشوائب والكدر ، بذلك نطقت الألسن ، وشهدت العقول؛ ان لم يكن من الكافّة فمن الاكثرين من ذوي الالباب الناصعة والعقول الصافية. ولما كان القول والاعتقاد انما يكون صادقا متى كان للموجود المعبّر عنه مطابقا؛ ثم كان بين قول هذين الحكيمين ، في كثير من انواع الفلسفة ، خلاف ، لم يَخْلُ الامرُ فيه من احدى ثلاث خلال : إمّا ان يكون هذا الحدّ المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح ، واما ان يكون رأي الجميع او الاكثرين واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين سخيفا ومدخولا ، واما ان يكون في معرفة الظانّين فيهما بانّ بينهما خلافا في هذه الاصول تقصير.
3 ـ موضوعات الفلسفة
والحدّ الصحيح مطابق لصناعة الفلسفة؛ وذلك يتبين من استقراء جزئيات هذه الصناعة. وذلك ان موضوعات العلوم وموادّها لا تخلو من ان تكون : اما إلهية ، واما طبيعية ، واما منطقية ، واما رياضية ، او سياسية. وصناعة الفلسفة هي المستنبطة لهذه ، والمخرجة لها ، حتى انه لا يوجد شيء من موجودات العالم الاّ وللفلسفة فيه مدخل ، وعليه غرض ، ومنه علم بمقدار الطاقة الأِنْسِيَّةِ (الانسانية). وطريق القسمة يصرح ويوضح ما ذكرناه ، وهو الذي يؤثر الحكيم افلاطون. فان المقسّم يروم ان لا يشذّ عنه شيء موجود من الموجودات. ولو لم يسلكها افلاطون لما كان الحكيم ارسطوطاليس يتصدّى لسلوكها.
4 ـ ارسطو ينشيء علم المنطق ويتمم سائر الفلسفة التي بدأها افلاطون
غير انه ، لما وجد افلاطون قد احكمها ، وبيّنها ، واتقنها ، واوضحها ، اهتمّ ارسطاطاليس باحتمال الكدّ واعمال الجهد في انشاء طريق القياس؛ وشرع في بيانه وتهذيبه ، ليستعمل القياس والبرهان في جزء جزء مما توجبه القسمة ، ليكون كالتابع والمتمّم والمساعد والناصح. ومن تدرب في علم المنطق ، واحكم علم الآداب الخلقية ، ثم شرع في الطبيعيات والالهيات ، ودرس كتب هذين الحكيمين ، يتبيّن له مصداق ما اقوله ، حيث يجدهما قد قصدا تدوين العلوم بموجودات العالم ، واجتهدا في ايضاح احوالها على ما هي عليه ، من غير قصد منهما لاختراع ، واغراب ، وابداع ، وزخرفة ، وتشويق ؛ بل لتوفية كل منهما قسطه ونصيبه ، بحسب الوسع والطاقة . واذا كان ذلك كذلك ، فالحد الذي قيل في الفلسفة ، انها العلم بالموجودات بما هي موجودة ، حد صحيح ، يبين عن ذات المحدود ويدلّ على ماهيته.
5 ـ اجماع العقول المختلفة حجة
فأما ان يكون رأي الجميع او الاكثرين ، واعتقادهم في هذين الحكيمين انهما المنظوران والامامان المبرّزان في هذه الصناعة ، سخيفا مدخولا؛ فذلك بعيد عن قبول العقل ايّاه واذعانه له؛ اذ الموجود يشهد بضدّه. لانا نعلم يقينا انه ليس شيء من الحجج اقوى وانفع واحكم من شهادات المعارف المختلفة بالشيء الواحد ، واجتماع الآراء الكثيرة ، اذ العقل ، عند الجميع ، حجّة. ولا جل ان ذا العقل ربما يخيّل اليه الشيء بعد الشيء ، على خلاف ما هو عليه ، من جهة تشابه العلامات المستدلّ بها على حال الشيء ، احتيج الى اجتماع عقول كثيرة مختلفة. فمهما اجتمعت ، فلا حجّة اقوى ، ولا يقين احكم من ذلك.
ثم لا يغرّنك وجود أناس كثيرة على آراء مدخولة؛ فانّ الجماعة المقلّدين لرأي واحد ، المدّعين لامام يؤمّهم فيما اجتمعوا عليه ، بمنزلة عقل واحد ، والعقل الواحد ربما يخطئ في الشيء الواحد ، حسب ما ذكرنا ، لا سيما اذا لم يتدبّر الرأي الذي يعتقده مرارا ، ولم ينظر فيه بعين التفتيش والمعاندة. وان حسن الظنّ بالشيء او الاهمال في البحث ، قد يغطي ، ويعمي ، ويخيّل.
واما العقول المختلفة ، اذا اتفقت ، بعد تأمّل منها ، وتدرّب ، وبحث ، وتنقير ومعاندة ، وتبكيت ، واثارة الاماكن المتقابلة ، فلا شيء اصحّ مما اعتقدته ، وشهدت به ، واتفقت عليه. ونحن نجد الالسنة المختلفة متفقة بتقديم هذين الحكيمين؛ وفي التفلسف بهما تضرب الامثال؛ واليهما يساق الاعتبار؛ وعندهما يتناهى الوصف بالحكم العميقة والعلوم اللطيفة ، والاستنباطات العجيبة ، والغوص في المعاني الدقيقة المؤدية في كل شيء الى المحض والحقيقة.
واذا كان هذا هكذا ، فقد بقي ان يكون في معرفة الظانّين بهما ان بينهما خلافا في الاصول ، تقصير. وينبغي ان تعلم ان ما من ظن يخطأ ، او سبب يغلط ، الاّ وله داع اليه ، وباعث عليه. ونحن نبين في هذه المواضع بعض الاسباب الداعية الى الظنّ بان بين الحكيمين خلافا في الاصول؛ ثم نتبع ذلك بالجمع بين رأييهما.
6 ـ عيب الاستقراء
اعلم ، ان مما هو متأكد في الطبائع ـ بحيث لا تقلع عنه (الطبائع) ولا يمكن خلوها عنه ، والتبرؤ منه في العلوم والآراء والاعتقادات ، وفي اسباب النواميس والشرائع ، وكذلك في المعاشرات المدنية والمعائش ـ هو الحكم بالكلّ عند استقراء الجزئيات : اما في الطبيعيات ، فمثل حكمنا بان كل حجر يرسب في الماء ، ولعل بعض الاحجار يطفو؛ وان كل نبات محترق بالنار ، ولعل بعضها لا يحترق بالنار ؛ وان جرم الكل متناه ، ولعله غير متناه. وفي الشرعيات ، مثل ان كل من شوهد فعل الخير منه على اكثر الاحوال ، فهو عدل ، صادق
الشهادة في كثير من الأشياء ، من غير ان يشاهد جميع احواله. [وفي المعاشرات ، مثل السكون والطمأنينة اللتين حدّهما في انفسنا محدود ، انما منه استدلالات من غير ان يشاهد في جميع احواله]. ولما كان امر هذه القضية على ما وصفناه من استحكامه واستيلائه على الطبائع ، ثم وجد افلاطون وارسطوطاليس ، وبينهما في السير والافعال ، وكثير من الاقوال ، خلاف ظاهر ، فكيف يضبط الوهم معهما بتوهم وتحكم بالخلاف الكلّي بينهما؛ مع سوق الوهم الى القول والفعل جميعا تابعين للاعتقاد؛ ولا سيما حيث لا مراء فيه ولا احتشام ، مع تمادي المدة؟
7 ـ اختلاف سيرتي أفلاطون وأرسطو لم يؤدي الي اختلاف آرائهما السياسة والخلقية
ثم ، من افعالهما المباينة ، وسيرهما المختلفة ، تخلّي افلاطون من كثير من الاسباب الدنيوية ، ورفضه لها ، وتحذيره في كثير من اقاويله عنها ، وايثاره تجنبها؛ وملابسة ارسطوطاليس لما كان يهجر افلاطون ، حتى استولى على كثير من الاملاك وتزوّج ، واولد ، وتوزّر للملك الاسكندر ، وحوى من الاسباب الدنيوية ما لا يخفى على من اعتنى بدرس كتب اخبار المتقدمين. فظاهر هذا الشأن يوجب الظنّ بأنّ بين الاعتقادين خلافا في امر الدارين.
وليس الامر كذلك ، في الحقيقة : فان افلاطون هو الذي دوّن السياسات ، وهذبها ، وبيّن السير العادلة ، والعشرة الأنسية المدنية ، وابان عن فضائلها ، واظهر الفساد العارض لأفعال من هجر العشرة المدنية ، وترك التعاون فيها. ومقالاته ، فيما ذكرناه ، مشهورة ، يتدارسها الأمم المختلفة من لدن زمانه الى عصرنا هذا. غير انّه ، لما رأى امر النفس وتقويمها اوّل ما يبتدئ به الانسان ، حتى اذا احكم تعديلها وتقويمها ، ارتقى منها الى تقويم غيرها ؛ ثم ، لم يجد في نفسه من القوة ما يمكنه الفراغ مما يهمّه من امرها ، افنى ايامه في اهمّ الواجبات عليه ، عازما على انه ، متى فرغ من الاهمّ الاولي ، اقبل على الاقرب الادنى ، حسب ما اوصى به في مقالاته في «السياسات والاخلاق».
وان ارسطوطاليس جرى على مثل ما جرى عليه افلاطون في اقاويله «ورسائله السياسية». ثم لما رجع الى امر نفسه خاصّة ، احس منها بقوة ورحب ذراع وسعة صدر وتوسع اخلاق وكمال امكنه معها تقويمها ، والتفرّغ للتعاون ، والاستمتاع بكثير من الاسباب المدنية.
فمن تأمل هذه الاحوال ، علم انه لم يكن ، بين الرأيين والاعتقادين ، خلاف ، وان التباين الواقع لهما كان سببه نقص في القوى الطبيعية في احدهما ، وزيادة فيها في الآخر ، فلا غير؛ على حسب ما لا يخلو منه كل الاثنين من اشخاص الناس ، اذ الاكثرون قد يعلمون ما هو آثر وأصوب وأولى؛ غير انهم لا يطيقونه ، ولا يقدرون عليه؛ وربما اطاقوا البعض وعجزوا عن البعض.
8 ـ منها افلاطون وارسطو في البحث مختلفان في الظاهر ولكنهما متفقان في الغاية
ومن ذلك ايضا ، تباين مذهبهما في تدوين العلوم ، وتأليف الكتب.
وذلك ان افلاطون كان يمنع ، في قديم الايام ، عن تدوين العلوم وايداع بطون الكتب دون الصدور الزكية والعقول المرضية. فلما خشي على نفسه الغفلة والنسيان ، وذهاب ما يستنبطه ، وتعسّر وقوفه عليه ، حيث استغزر علمه وحكمته ، وتبسط فيها؛ فاختار الرموز والالغاز ، قصدا منه ، لتدوين علومه وحكمته ، على السبيل الذي لا يطّلع عليه الاّ المستحقّون لها ، والمستوجبون للاحاطة بها ، طلبا وبحثا وتنقيرا واجتهادا. واما ارسطوطاليس ، فكان مذهبه الايضاح ، والتدوين ، والترتيب ، والتبليغ ، والكشف ، والبيان ، واستيفاء كل ما يجد اليه السبيل من ذلك.
وهذان سبيلان ، على ظاهر الامر ، متباينان. غير ان الباحث عن علوم ارسطوطاليس ، والدارس ، لكتبه ، والمواظب عليها ، لا يخفى عليه مذهبه في وجوه الاغلاق والتعمية والتعقيد ، مع ما يظهره من قصد البيان والايضاح. من ذلك ما يوجد في اقاويله من حذف المقدّمة الضرورية من كثير من القياسات الطبيعية والالهية والخلقية التي اوردها؛ مما دلّ على مواضعها المفسّرون لها. ومن ذلك حذف كثير من النتائج ، وحذف الواحد من كل زوجين ، والاقتصار على الواحد منهما؛ مثل قوله في «رسالته الى الاسكندر» ، في سياسات المدن الجزئية : «من آثر اختيار العدل في التعاون المدني ، فخليق ان يميّزه مدبّر المدينة في العقوبة». وتمام هذا القول هكذا : من آثر اختيار العدل على الجور ، فخليق ان يميّزه مدبّر المدينة في العقوبة والثواب. يعني ان من آثر العدل ، فخليق ان يثاب ، كما ان من آثر الجور ، فخليق ان يعاقب.
ومن ذلك ، ذكره لمقدمتي قياس ما ، واتباعهما نتيجة قياس آخر ، وذكره لمقدمتي قياس ، واتباعه نتيجة لوازم تلك المقدّمات ، مثل ما فعله في كتاب «القياس» ، عند ذكر اجزاء الجواهر انها جواهر. ومن ذلك ، (إشباعه) القول في تعديد جزئيات الشيء الواضح ، ليرى ، من نفسه ، البلاغ والجهد في الاستيفاء؛ ثم تجاوزه عن الغامض من غير اشباع في القول ، ولا توفيته في الخط.
ومن ذلك ، النظم والترتيب والرسم الذي في كتبه العلمية ، حيث تظنّ ان ذلك طباع له ، لا يمكنه التحوّل عنه. فاذا تؤمل رسائله وجد كلامه فيها منشأ ومنظوما على رسوم وترتيبات مخالفة لما في تلك الكتب. وتكفينا «رسالته» المعروفة الى افلاطون ، في جواب ما كان افلاطون كتب اليه به ، يعاتبه على تأليفه الكتب وترتيبه العلوم ، واخراجها في تأليفاته الكاملة المستقصاة. فانه يصرح ، في هذه «الرسالة الى افلاطون» ، ويقول : «اني وان دوّنت هذه العلوم والحكم المضمونة بها ، فقد رتّبتها ترتيبا لا يخلص اليها الاّ اهلها ، وعبّرت عنها بعبارات لا يحيط بها الاّ بنوها». فقد ظهر ، مما وصفناه ، ان الذي سبق الى الاوهام من التباين في المسلكين في امر ، يشتمل عليه حكمان ظاهران متخالفان ، يجمعها مقصود واحد.
9 ـ لا خلاف بين افلاطون وارسطو في تفضيل الجواهر
ومن ذلك ايضا ، امر الجواهر ، وان التي منها اقدم ، عند ارسطوطاليس غير التي منها اقدم ، عند افلاطون. فان اكثر الناظرين في كتبهما يحكمون بخلاف بين رأييهما في هذا الباب. والذي حداهم الى هذا الحكم ، وهذا الظن ، هو ما وجدوا من اقاويل افلاطون في كثير من كتبه ، مثل كتاب «طيماوس» ، وكتاب «بوليطيا الصغير» ، دلالة على ان افضل الجواهر واقدمها واشرفها ، هي القريبة
من العقل والنفس ، البعيدة عن الحس والوجود الكياني. ثم وجدوا كثيرا من اقاويل ارسطوطاليس في كتبه ، مثل كتابه في «المقولات» ، وكتابه في «القياسات الشرطية» ، يصرح بان اولى الجواهر ، بالتفضيل والتقديم ، الجواهر الأول ، التي هي الاشخاص. فلما وجدوا هذه الاقاويل ، على ما ذكرناه من التفاوت والتباين ، لم يشكوا في ان بين الاعتقادين خلافا .
والامر كذلك لان من مذهب الحكماء والفلاسفة ان يفرقوا بين الاقاويل والقضايا في الصناعات المختلفة ، فيتكلّمون على الشيء الواحد في صناعة بحسب مقتضى تلك الصناعة؛ ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعينه ، في صناعة اخرى ، بغير ما تكلموا به اولا. وليس ذلك ببديع ولا مستنكر؛ اذ مدار الفلسفة على القول من حيث ومن جهة ما. كما قد قيل انه لو ارتفع من حيث ومن جهة ما ، بطلت تلك العلوم والفلسفة. ألا ترى أن الشخص الواحد ، كسقراط مثلا ، يكون داخلا تحت الجوهر ، من حيث هو انسان ، وتحت الكم من حيث هو ذو مقدار ، وتحت الكيف من حيث هو ابيض او فاضل او غير ذلك؛ وفي المضاف ، من حيث هو اب او ابن؛ وفي الوضع ، من حيث هو جالس او متّك. وكذلك سائر ما اشبهه.
فالحكيم ارسطوطاليس ، حيث جعل اولى الجواهر ، بالتقديم والتفضيل ، اشخاص الجواهر ، انما جعل ذلك في صناعة «المنطق وصناعة الكيان» ، حيث راعى احوال الموجودات القريبة الى المحسوس الذي منه يؤخذ جميع المفهومات ، وبها قوام الكلي المتصور. واما الحكيم افلاطون ، فانه حيث جعل اولى الجواهر ، بالتقديم والتفضيل ، الكليات ، فانه انما جعل ذلك فيما «بعد الطبيعة» وفي «اقاويله الالهية» ، حيث كان يراعي الموجودات البسيطة الباقية ، التي لا تستحيل ولا تدثر.
فلما كان بين المقصودين فرق ظاهر ، وبين الفريقين بون بعيد ، وبين المبحوث عنهما خلاف ، فقد صحّ ان هذين الرأيين ، من الحكيمين ، متفقان لا خلاف بينهما؛ اذا الاختلاف انما يكون حاصلا ان حكما على الجواهر من جهة واحدة وبالاضافة الى مقصود واحد بحكمين مختلفين. فلما لم يكن ذلك كذلك ، فقد اتضح ان رأييهما يجتمعان على حكم واحد في تقديم الجواهر وتفضيلها.
10 ـ القسمة التي اعتمدها افلاطون لم يهملها ارسطو
ومن ذلك ، ما يظن بهما في امر القسمة والتركيب في توفية الحدود.
ان افلاطون يرى ان توفية الحدود انما يكون بطريق القسمة ، وارسطوطاليس يرى ان توفية الحدود انما يكون بطريق البرهان والتركيب.
وينبغي ان تعلم ان مثل ذلك مثل الدرج الذي يدرج عليه ، وينزل منه : فان المسافة واحدة وبين السالكين خلاف. وذلك ان ارسطوطاليس ، لما رأى ان اقرب الطرق واوثقها في توفية الحدود ، هو بطلب ما يخص الشيء وما يعمه ، مما هي ذاتية له وجوهرية ، وسائر ما ذكره في «الحرف» الذي يتكلم فيه على توفية الحدود ، من كتبه فيما «بعد الطبيعة» ، وكذلك في كتاب «البرهان» ، وفي كتاب «الجدل» ، وفي غير ذلك من المواضع ، مما يطول ذكره؛ واكثر كلامه لم يخل من قسمة ما ، وان كان غير مصرح بها ، فانه حين يفرق بين العاميّ والخاصّ ، وبين الذاتي وغير الذاتي ، فهو سالك ، بطبيعته وذهنه وفكره ، طريق القسمة ، وانما يصرح ببعض اطرافها. ولا جل ذلك لم يطرح طريق القسمة رأسا ، لكنه يعدّه من التعاون على اقتضاء اجزاء المحدود. والدليل على ذلك ، قوله ، في كتاب «القياس» ، في آخر المقالة الاولى : «فاما القسمة التي تكون بالاجناس جزء صغير من هذا المأخذ ، فانه سهل ان يعرف» ، وسائر ما يتلوه. وهو لم يعد المعاني التي يرى افلاطون استعمالها ، حين يقصد الى اعمّ ما يجده مما يشتمل على الشيء المقصود تحديده ، فيقسمه بفصلين ذاتيين ، ثم يقسم
كل قسم منهما كذلك ، وينظر في اي الجزءين يقع المقصود تحديده؛ ثم لا يزال يفعل كذلك الى ان يحصل امر عاميّ قريب من المقصود تحديده ، وفصل يقوّم ذاته ويفرده عمّا يشاركه. وهو في ذلك لا يخلو من تركيب ما حيث يركّب الفصل على الجنس؛ وان لم يقصد ذلك من اول الامر. فاذا كان لا يخلو من ذلك فيما يستعمله. وان كان ظاهر سلوكه ذلك خلاف ظاهر سلوكه هذه ، فالمعاني واحدة. وايضا ، فسواء طلبت جنس الشيء وفصله ، او طلبت الشيء في جنسه وفصله. فظاهر ان لا خلاف بين الرأيين في الاصل ، وان كان بين المسلكين خلاف. ونحن لا ندّعي انه لا بون ، بوجه من الوجوه وجهة من الجهات ، بين الطريقين ، لانه يلزمنا ، عند ذلك ، ان يكون قول ارسطوطاليس ومأخذه وسلوكه ، هي باعينها قول افلاطون ومأخذه وسلوكه. وذلك محال وشنيع ، ولكنّا ندّعي انه لا خلاف بينهما في الاصول والمقاصد ، على ما بيّناه او سنبيّنه بمشيئة اللّه وحسن توفيقه.
11 ـ لا خلاف بين افلاطون وارسطو حول القياس
ومن ذلك ايضا ، ما انتحله امونيوس وكثير من الاسكلائيين
وآخرهم تامسطيوس فيمن يتبعه ، من ان القياس المختلط من الضروري والوجودي اذا كانت المقدمة الكبرى منهما ضرورية ، كانت النتيجة وجودية لا ضرورية. ونسبوا ذلك الى افلاطون ، وادّعوا انه يأتي بقياسات ، في كتبه ، توجد مقدماتها الكبرى ضرورية ونتائجها وجودية ، مثل القياس الذي يأتي به في كتاب «طيماوس» ، حيث يقول : «الوجود افضل من لا وجود ، والافضل تشتاقه الطبيعة ابدا». ويزعمون ان النتيجة اللازمة لهاتين المقدمتين ، وهي ان الطبيعة تشتاق الوجود ، ليست ضرورية ، من جهات : منها انه لا ضرورة في الطبيعة ، وان الذي في الطبيعة من الوجود هو الوجود الذي على الأكثر؛ ومنها ان الطبيعة قد تشتاق الى الوجود عند المضاف اللاحق لوجود ما ، هي اللازمة عنه. وزعموا ان المقدمة الكبرى من هذا القياس ضرورية ، لقوله : «ابدا». وارسطوطاليس يصرح في كتاب «القياس» : ان القياس الذي تكون مقدماته مختلطة من الضروري ومن الوجودي ، وتكون الكبرى هي الضرورية ، فان النتيجة تكون ضرورية. وهذا خلاف ظاهر.
فنقول : لو لا انه لا يوجد لافلاطون قول يصرح فيه ان امثال هذه النتائج تكون ضرورية او وجودية البتة ، وانما ذلك شيء يدّعيه الناظرون ، ويزعمون انه قد يوجد لافلاطون قياسات على هذا السبيل ، مثل ما حكيناه عنه ، لكان بينهما خلاف ظاهر. الاّ ان الذي دعاهم
الى هذا الاعتقاد هو قلّة التمييز وخلط صناعة المنطق بالطبيعة وذلك اذ ، لما هم وجدوا القياس مركّبا من مقدّمتين وثلاثة حدود : اوّل ، واوسط ، وآخر ، ووجدوا لزوم الحد الأول للاوسط ضروريا ، ولزوم الاوسط للاخر وجوديا ، ورأوا الحد الاوسط ـ وكان هو العلة في لزوم الحد الأول للاخر ، والواصل له به ـ ثم وجدوا حاله نفسه عند الآخر حال الوجود ، قالوا : اذا كان حال الاوسط الذي هو العلة والسبب في وصول الأول بالآخر حال الوجود ، فكيف يجوز ان يكون حال الأول عند الآخر حال الاضطرار؟ وانما سوّغ لهم هذا الاعتقاد ، لنظرهم في مجرّد الامور والمعاني ، وازورارهم عن شرائط المنطق وشرائط المقول على الكل. ولو علموا وتفكروا وتأملوا حال المقول على الكل وشرطه ، وان معناه هو ان كل ما هو «ب» ، وكل ما يكون «ب» ، فهو اتمّ ، لوجدوا ان هو بشرط المقول على الكل بالضرورة. ولما عرض لهم الشكّ ، ولما ساغ لهم ما اعتقدوه وايضا فان القياسات التي يأتون بها عن افلاطون ، اذا تؤمّل حقّ التأمل فيها ، وجدوا اكثرها واردا في صور القياس المؤتلف من الموجبتين في الشكل الثاني. ومهما نظر في واحد واحد من مقدماتها ، تبيّن وهن ما ادّعوه فيها. وقد لخّص الاسكندر الافروديسي معنى المقول على الكل ،
وفاصل عن ارسطو فيما ادّعوه. وشرحنا نحن اقاويله ايضا عن كتاب «انولوطيقا» في هذا الباب ، وبيّنا معنى المقول على الكل ، ولخصنا امره ، شافيا ، وفرّقنا فيه بين الضروري القياسي وبين الضروري البرهاني ، بحيث يكون فيه غنية لمن تأمله عن كل ما يورثه لبثا في هذا الباب. فقد ظهر ان الذي ادّعاه ارسطوطاليس في هذا القياس ، هو على ما ادّعاه ، وان افلاطون لا يوجد له قول يصرح فيه بما يخالف قول ارسطو .
ومما اشبه ذلك هو ما ادّعوه على افلاطون انه يستعمل الضرب من القياس في الشكل الأول والثالث ، الذي المقدمة الصغرى منه سالبة. وقد بيّن ارسطو مرّة في «انولوطيقا» انه غير منتج. وقد تكلّم المفسّرون في هذا الشكل وحلّلوه ، وبيّنوا امره. ونحن ايضا ، شرحنا في تفاسيرنا وبينا ان الذي اتى به افلاطون في كتاب «السياسة» ، وكذلك ارسطوطاليس في كتاب «السماء والعالم» مما يوهم انها سوالب ، ليست بسوالب ، لكنها موجبات معدولة؛ مثل قوله : السماء لا خفيف ولا ثقيل ، وكذلك سائر ما اشبهها؛ اذ الموضوعات فيها موجودة ، والموجبات المعدولة ، مهما وقعت في القياس ، بحيث لو وقعت هناك سوالب بسيطة ، كان الضرب غير منتج ، لامتنع القياس من ان يكون منتجا.
ومن ذلك ايضا ، ما اتى به ارسطوطاليس في الفصل الخامس من الكتاب «باري هرمينياس» ، وهو ان الموجبة التي المحمول فيها ضدّ من
الاضداد ، فان سالبته اشدّ مضادة من الموجبة التي المحمول فيها ضدّ ذلك المحمول. فان كثيرا من الناس ظنوا ان افلاطون يخالفه في هذا الرأي ، وانه يرى ان الموجبة التي المحمول فيها ضد المحمول في الموجبة الاخرى ، اشدّ مضادة. واحتجوا على ذلك بكثير من اقاويله السياسية والخلقية؛ منها ما ذكره في كتاب «السياسة» : ان الاعدل متوسّط بين الجور والعدل. وهؤلاء ، فقد ذهب عليهم ما نحاه افلاطون في كتاب «السياسة» ، وما نحاه ارسطوطاليس في «باري هرمينياس» ، وذلك ان الغرضين المقصودين متباينان. فان ارسطو انما بيّن معاندة الاقاويل ، وانها اشدّ واتمّ معاندة. والدليل على ذلك ما اورده في الحجج ، وبيّن ان من الامور ما لا يوجد فيها مضادة البتة ، وليس شيء من الامور الاّ ويوجد فيها سوالب معاندة له. وايضا ، فان كان واجبا في غير ما ذكرنا ، ان يجري الامر على هذا المثال ، فقد ترى ان ما قيل في ذلك صواب؛ وذلك انه قد يجب ، اما ان يكون اعتقاد النقيض هو الضد في كل موضع ، واما ان يكون في موضع من المواضع هذه. الاّ ان الأشياء التي ليس يوجد فيها ضد اصلا ، فان الكذب فيها هو الضد المعاند للحق. ومثال ذلك ، من ظنّ بانسان انه ليس بانسان ، فقد ظن ظنا كاذبا. فان كان هذان الاعتقادان هما الضدان ، فسائر الاعتقادات انما الضد فيها هو اعتقاد النقيض. واما افلاطون ، حيث بيّن ان الاعدل متوسّط بين العدل والجور ، فانه انما قصد بيان المعاني السياسية ومراتبها ، لا معاندة الاقاويل فيها. وقد ذكر ارسطو في «نيقوماخيا الصغير في السياسة» شبها بما بيّنه افلاطون. فقد تبيّن
لمتأمل هذه الاقاويل والناظر فيها بعين النصفة ، انه لا خلاف بين الرأيين ، ولا تباين بين الاعتقادين .
وبالجملة ، فليس يوجد الى الآن لافلاطون اقاويل يبين فيها المعاني المنطقية التي زعم كثير من الناس ان بينه وبين ارسطوطاليس فيها خلافا. وانما يحتجون على ما يزعمون ببعض اقاويله السياسية والخلقية والالهية ، حسب ما ذكرناه.
12 ـ الابصار عند افلاطون يتم بخروج شيء من البصر الي الاشياء ، وعند ارسطو بشيء يخرج من الاشياء الي البصر ، ومع ذلك الخلاف لفظي
ومن ذلك حال الابصار ، وكيفيته؛ وما ينسب الى افلاطون من ان رأيه مخالف لرأي ارسطو : ان ارسطو يرى ان الابصار انما يكون بانفعال من البصر؛ وافلاطون يرى ان الابصار انما يكون بخروج شيء من البصر وملاقاته المبصر وقد اكثر المفسرون من الفريقين الخوض في هذا الباب؛ وارادوا من الحجج والشناعات والالزامات؛ وحرّفوا اقاويل الائمّة عن سننها المقصودة بها ، وتأوّلوا تأويلات انساغت لهم معها الشناعات ، وجانبوا طريق الانصاف والحق. وذلك ان اصحاب
ارسطوطاليس ، لما سمعوا قول اصحاب افلاطون في الابصار ، وانه انما يكون بخروج شيء من البصر ، قالوا ان الخروج انما يكون للجسم ، وهذا الجسم الذي زعموا انه يخرج من البصر ، امّا ان يكون هواء او ضوءا او نارا. وان كان هواء ، فان الهواء قد يوجد فيما بين البصر والمبصر ، فما حاجة الى خروج هواء آخر؟ وان كان ضياء ، فان الضياء ايضا قد يوجد في الهواء الذي بين البصر والمبصر ، فالضياء الخارج من البصر فضل لا يحتاج اليه. وايضا ، فانه وان كان ضياء ، فلم احتيج معه الى الضياء الراكد بين البصر والمبصر؟ ولم لا يغني هذا الضياء الخارج من البصر عن الضياء الذي يحتاج اليه في الهواء؟ ولم لا يبصر في الظلمة ، ان كان الذي يخرج من البصر هو ضياء؟ وايضا ، ان قيل ان الضياء الذي يخرج من البصر يكون ضعيفا ، فلم لا يقوى اذا اجتمعت ابصار كثيرة بالليل على النظر الى شيء واحد ، كما نرى من ذلك من قوة الضوء عند اجتماع السرج الكثيرة؟ وان كان نارا ، فلم لا يحمي ولا يحرق ، مثل ما تفعله النار؟ ولم لا ينطفي في المياه ، كما تنطفي النار؟ ولم (لا) ينفذ الى اسفل كما ينفذ الى فوق ، وليس من شأن النار ان تنفذ الى الاسفل؟ وايضا ، ان قيل ان الذي يخرج عن البصر شيء آخر غير هذه الأشياء ، فلم لا يتلاقى ولا يتصادم عند مقابلة المناظر ، فيمنع الناظرين المتقابلين عن الادراك النظري؟ هذه
__________________
وما اشبهها من الشناعات التي وقعت لهم ، عند تحريفهم لفظ الخروج عن مقصود القول ، وجريهم الى الخروج الذي يقال في الاجسام.
ثم ان اصحاب افلاطون ، لمّا سمعوا اقوال اصحاب ارسطوطاليس في الابصار ، وانه انما يكون بالانفعال ، حرّفوا هذه اللفظة بان قالوا : ان الانفعال لا يخلو من تأثر واستحالة ، وتغير في الكيفية .. وهذا الانفعال ، اما ان يكون في العضو الباصر ، او في الجسم المشفّ الذي بين البصر والمبصر. فان كان في العضو لزم ان تستحيل الحدقة ، في آن واحد بعينه ، من الوان بلا نهاية؛ وذلك محال؛ اذ الاستحالة انما تكون ، لا محالة ، في زمان ومن شيء واحد بعينه ، الى شيء واحد بعينه محدود. وان كان يحصل في بعضه دون بعض ، لزم ان تكون تلك الاجزاء مفصّلة متميّزة؛ وليست كذلك. وان كان ذلك الانفعال يلحق الجسم المشفّ ، اعني الهواء الذي بين البصر والمبصر ، لزم ان يكون الموضوع الواحد بالعدد قابلا للضدّين في وقت واحد معا ، وذلك محال. هذه وما اشبهها من الشناعات التي اوردوها.
ثم ان اصحاب ارسطو احتجوا على صحة ما ادعوه ، فقالوا : لو لم تكن الالوان وما يقوم مقامها ، محمولة في الجسم المشفّ بالفعل ، لما ادرك البصر الكواكب والأشياء البعيدة جدا ، في لحظة بلا زمان. فان الذي ينتقل لا بدّ من ان يبلغ المسافة القريبة قبل بلوغه المسافة البعيدة. ونحن نلحظ الكواكب ، مع بعد المسافة ، في الزمان الذي نلحظ فيه ما هو اقرب منها ، ولا يغادر ذلك شيئا. فظهر ، من هذه الجهة ، ان الهواء المشفّ يحمل الوان المبصرات ، فتؤدّي الى البصر.
واحتجّ اصحاب افلاطون على صحة ما ادعوه من ان شيئا ينبثّ ويخرج من البصر الى المبصر فيلاقيه ، بان المبصرات ، متى كانت متفاوتة بالمسافات ، ادركنا ما هو اقرب دون ما هو ابعد ، والعلة في ذلك ان الشيء الخارج من البصر يدرك بقوّته ما يقرب منه ، ثم لا يزال يضعف ، فيكون ادراكه اقلّ واقلّ ، حتى تفنى قوّته ، فلا يدرك ما هو بعيد عنه جدا البتة . ومما يؤكد هذه الدعوى ، انّا متى مددنا ابصارنا الى مسافة بعيدة ، واوقعناها على مبصر ينجلي بضوء نار قريبة منه ، ادركنا ذلك المبصر ، وان كانت المسافة التي بيننا وبينه مظلمة. فلو كان الامر على ما قاله ارسطو واصحابه ، لوجب ان يكون جميع المسافة التي بيننا وبين المبصر مضيئا ليحمل الالوان فتؤدي الى البصر. فلما وجدنا الجسم المتجلي من بعد مبصرا ، علمنا ان شيئا خرج من البصر وامتدّ ، وقطع الظلمة ، وبلغ المبصر الذي تجلى بضوء ما ادركه.
ولو كان كلا الفريقين ارخوا اعينهم قليلا ، وتوسطوا النظر وقصدوا الحق ، وهجروا طريق العصبية ، لعلموا ان الافلاطونيّين انما ارادوا بلفظ الخروج معنى غير معنى خروج الجسم من المكان.
وانما اضطرهم الى اطلاق لفظ «الخروج» ضرورة العبارة وضيق اللغة ، وعدم لفظ يدل على اثبات القوى من غير ان يخيل الخروج الذي للاجسام. وان اصحاب ارسطوطاليس ايضا ارادوا بلفظ «الانفعال» معنى غير معنى الانفعال الذي يكون في الكيفية مع الاستحالة والتغير. وظاهر ان الشيء الذي يشبه بشيء ما ، تكون ذاته وانيّته غير المشبه به. ومتى نظرنا بعين النصفة في هذا الامر ، علمنا ان هاهنا قوة واصلة بين البصر والمبصر؛ وان من شنع على اصحاب افلاطون في قولهم ان قوة ما تخرج من البصر فتلاقي المبصر ، فان قوله ان الهواء يحمل لون المبصر ، فتؤديه الى البصر ليلاقيه مماسا ، ليس بدون قولهم في الشناعة. فان كان ما يلزم اقاويل اولئك في اثبات القوة وخروجها ، يلزم قول هؤلاء في حمل الهواء الالوان وابدائها الى الابصار. فظاهر ان هذه واشباهها معان لطيفة دقيقة ، تنبّه لها المتفلسفون وبحثوا عنها ، واضطرّهم الامر الى العبارة عنها بالالفاظ القريبة من تلك المعاني؛ ولم يجدوا لها الفاظا موضوعة مفردة يعبر عنها حقّ العبارة ، من غير اشتراك يعرض فيها. فلما كان ذلك كذلك ، وجدوا العائبون مقالا ، فقالوا : واكثر ما يقع من المخالفة انما يقع في امثال هذه المعاني للاسباب التي ذكرناها. وذلك لا يخلو من احد امرين : اما لتخلف ، واما لمعاندة. فاما ذو الذهن الصحيح والرأي السديد والعقل الرصين المحكم الثابت ، اذا لم يتعمّد التمويه او تعصّب او مغالبة ، فقلّما يعتقد خلاف ان العالم اطلق لفظا على سبيل الضرورة ، عند ما رام بيان امر غامض وايضاح معنى لطيف فلا يخلو المتبصّر له عن اشتباه توقعه الالفاظ المشتركة والمستعارة.
13 ـ الاخلاق عند افلاطون وارسطو مكتسبة وليست طباعاً :
ومن ذلك ايضا ، امر اخلاق النفس ، وظنّهم بان رأي ارسطو مخالف لرأي افلاطون. وذلك ان ارسطو يصرح في كتاب «نيقوماخيا» ان الاخلاق كلها عادات تتغير ، وانه ليس شيء منها بالطبع؛ وان الانسان يمكنه ان ينتقل من كل واحد منها الى غيره بالاعتياد والدربة. وافلاطون يصرح في كتاب «السياسة» وفي كتاب «بوليطيا» خاصة بان الطبع يغلب العادة؛ وان الكهول حيثما طبعوا على خلق ما ، يعسر زوالهم عنه؛ وانهم متى قصدوا زوال ذلك الخلق عنهم ازدادوا فيه تماديا. ويأتي على ذلك بمثال من الطريق : اذا نبت فيه الدغل والحشيش والشجر معوجّة ، متى قصد خلاء الطريق منها او ميل الشجر الى جانب آخر ، فانها اذا خلّيت سبيلها اخذت من الطريق اكثر مما كانت اخذت قبل ذلك.
وليس يشكّ احد ممن يسمع هاتين المقالتين ان بين الحكيمين في امر الاخلاق خلافا.
وليس الامر ، في الحقيقة ، كما ظنوا. وذلك ان ارسطو ، في كتابه المعروف «بنيقوماخيا» انما يتكلم على القوانين المدنية ، على ما بيناه في مواضع عن شرحنا لذلك الكتاب. ولو كان الامر فيه ايضا على ما قاله فرفوريوس ، وكثير ممن بعده من المفسّرين ، انه يتكلم على الاخلاق ، فان كلامه على القوانين الخلقية والكلام القانوني ، ابدا يكون كليا
ومطلقا ، لا بحسب شيء آخر. ومن البيّن ان كل خلق ، اذا نظر اليه مطلقا ، علم انه يتنقّل ويتغيّر ، ولو بعسر ، وليس شيء من الاخلاق ممتنعا عن التغيّر والتنقّل ، فان الطفل الذي نفسه تعدّ بالقوة ، ليس فيه شيء من الاخلاق بالفعل ، ولا من الصفات النفسانية. وبالجملة ، فان ما كان فيه بالقوة ففيه تهيّؤ لقبول الشيء وضدّه. ومهما اكتسب احد الضدين يمكن زواله عن ذلك الضد المكتسب الى ضده ، الى ان تنقص البنية ويلحقه نوع من الفساد ، مثل ما يعرض لموضوع الاعدام والملكات ، فيتغير بحيث لا يتغالبان عليه. وذلك نوع من الفساد وعدم التهيؤ. فاذا كان ذلك كذلك ، فليس شيء من الاخلاق ، اذا نظر اليه مطلقا بالطبع ، لا يمكن فيه التغيّر والتبدّل.
واما افلاطون ، فانه ينظر في انواع السياسات ، وايّها انفع ، وايّها اشد ضررا. فينظر في احوال قابلي السياسات وفاعليها ، وايّها اسهل قبولا ، وايّها اعسر. ولعمري ان من نشأ على خلق من الاخلاق واتفقت له تقويته ، يمكن بها من نفسه على خلق من الاخلاق ، فان زوال ذلك عنه يعسر جدا. والعسر غير الممتنع. وليس ينكر ارسطو ان بعض الناس يمكن فيه التنقّل من خلق الى خلق اسهل ، وفي بعضهم اعسر ، على ما صرح به في كتابه المعروف «بنيقوماخيا الصغير» ، فانه عدّ اسباب عسر التنقل من خلق الى خلق ، واسباب السهولة ، كم هي ، وما هي ، وعلى ايّ جهة كل واحد من تلك الاسباب ، وما العلامات ، وما الموانع. فمن تأمل تلك الاقاويل حق التأمل ، واعطى كل شيء حقه ، عرف ان لا خلاف بين الحكيمين في الحقيقة؛ وانما ذلك شيء يخيله الظاهر من الاقاويل عند ما ينظر واحد واحد منها على انفراد ، من غير ان يتأمل المكان الذي فيه ذلك القول ، ومرتبة العلم الذي هو منه. وهاهنا اصل عظيم الغناء في تصور العلوم ، وخصوصا في امثال هذه الموانع ، وهو انه كما المادّة ، مهما كانت متصورة بصورة ما ثم حدثت فيها صورة أخرى ، صارت مع صورتها جميعا مادة للصورة الثالثة الحادثة فيها ، كالخشب الذي له صورة يباين بها سائر الاجسام ، ثم يجعل منها الواحا ، ثم يجعل من الالواح سريرا. فان صورة السرير ، من حيث حدثت في الالواح مادة لها ، وفي الالواح ، التي هي مادة بالاضافة الى صورة السرير ، صور كثيرة ، مثل الصور اللوحية والصور الخشبية والصور النباتية وغيرها من الصور القديمة. كذلك مهما كانت النفس المتخلّقة ببعض الاخلاق ، ثم تكلفت اكتساب خلق جديد ، كان الاخلاق التي معها كالاشياء الطبيعية لها ، وهذه المكتسبة الجديدة ، اعتيادية ، ثم ان مرّت على هذه ودامت على اكتساب خلق ثالث ، صارت تلك بمنزلة الطبيعية ، وذلك بالاضافة الى هذه الجديدة المكتسبة.
فمهما رأيت افلاطون او غيره يقول : ان من الاخلاق ما هي طبيعية ، ومنها ما هي مكتسبة ، فاعلم ما ذكرناه ، وتفهمه من فحوى كلامهم ، لئلا يشكل عليك الامر؛ فظن ان من الاخلاق ما هي طبيعية
بالحقيقة ، لا يمكن زوالها. فان ذلك شنيع جدا. ونفس اللفظ يناقض معناه اذا تؤمّل فيه جدا.
14 ـ المعرفة عند افلاطون تذكر وعند ارسطو احساس ، ومع ذلك لا فرق بينهما
ومن ذلك ايضا ، ان ارسطوطاليس قد اورد في كتاب «البرهان» شكّا ان الذي يطلب علما ما ، لا يخلو من احد الوجهين : فانه ، اما ان يطلب ما يجهله ، او ما يعلمه. فان كان يطلب ما يجهله ، فكيف يوقن في تعلمه انه هو الذي كان يطلبه؟ وان كان يطلب ما يعلمه ، فطلبه علما ثانيا فضل لا يحتاج اليه. ثم احدث الكلام في ذلك الى ان قال : ان الذي يطلب علم شيء من الأشياء ، انما يطلب في شيء آخر ما قد وجد في نفسه على التحصيل ، مثل ان المساواة وغير المساواة موجودتان في النفس ، والذي يطلب الخشبة ، هل هي مساوية او غير مساوية ، انما يطلب ما لها منها على التحصيل. فاذا وجد احدهما فكأنه يذكر ما كان موجودا في نفسه؛ ثم ان كانت مساوية ، فبالمساواة؛ وان كانت غير مساوية ، فبغير المساواة.
وافلاطون بيّن في كتابه المعروف ب «فاذن» ان التعلّم تذكر ، واتى على ذلك الحجج يحكيها عن سقراط في مسائلاته ومجاوباته في امر المساوي والمساواة؛ وان المساواة هي التي تكون في النفس ، وان المساوي ، مثل الخشبة او غيرها مما تكون مساوية لغيرها متى احس بها
الانسان ، تذكّر المساواة التي كانت في النفس؛ فعلم ان هذا المساوي انما كان مساويا بمساواة شبيهة بالتي في النفس. وكذلك سائر ما يتعلّم ، انما يتذكر ما في النفس. واللّه اعلم .
وقد ظنّ اكثر الناس ، من هذه الاقاويل ، ظنونا مجاوزة عن الحد. اما القائلون ببقاء النفس بعد مفارقتها البدن ، فقد افرطوا في تأويل هذه الاقاويل ، وحرّفوها عن سننها ، واحسنوا الظنّ بها ان اجروها مجرى البراهين؛ ولم يعلموا ان افلاطون انما يحكي هذا عن سقراط على سبيل من يروم تصحيح امر خفيّ بعلامات ودلائل. والقياس بعلامات لا يكون برهانا ، كما علّمناه الحكيم ارسطو في «انولوطيقا الأولى والثانية». ـ واما المدافعون لها ، فقد افرطوا ايضا في التشنيع ، وزعموا ان ارسطو مخالف له في هذا الرأي ، واغفلوا قوله في اوّل كتاب «البرهان» حيث ابتدأ فقال : كل تعليم وكل تعلّم فانما يكون عن معرفة متقدمة الوجود. ثم قال بعد قليل : وقد يتعلم الانسان بعض الأشياء وقد كان علمه من قبل قديما ، وبعض الأشياء تعلّمها يحصل من حيث تعلّمها معا. مثال ذلك : جميع الأشياء الموجودة تحت الأشياء الكلية.
فليت شعري ، هل يغادر معنى هذا القول ما قاله افلاطون شيئا ، سوى ان العقل المستقيم والرأي السديد والميل الى الحق والانصاف معدوم في الاكثرين من الناس! فمن تأمّل حصول المقدّمات الأولى وحال التعلّم تأمّلا شافيا ، علم انه لا يوجد بين رأيي الحكيمين ، في هذا المعنى ، خلاف ولا تباين ولا مخالفة. ونحن نومئ الى طرف منه يسير بمقدار ما يتبين به هذا المعنى ليزول الشك الواقع فيه.
فنقول : من البيّن الظاهر ان للطفل نفسا عالمة بالقوة ، ولها الحواس آلات الادراك. وادراك الحواس انما يكون للجزئيات؛ وعن الجزئيات تحصل الكليات ، والكليات هي التجارب على الحقيقة. غير ان من التجارب ما يحصل عن قصد. وقد جرت العادة ، بين الجمهور ، بان يسمّى التي تحصل من الكليات عن قصد متقدّمة التجارب. فاما التي تحصل من الكليات للانسان لا عن قصد ، فاما ان لا يوجد لها اسم عند الجمهور ، لانهم لا يعنونه ؛ واما ان يوجد لها اسم عند العلماء ، فيسمّونها اوائل المعارف ومبادئ البرهان وما اشبهها من الاسماء.
وقد بيّن ارسطو في كتاب «البرهان» ان من فقد حسّا ما فقد فقد علما ما. فالمعارف انما تحصل في النفس بطريق الحس . ولما كانت المعارف انما حصلت في النفس عن غير قصد اولا فاولا ، فلم يتذكر الانسان ، وقد حصل جزء جزء منها. فلذلك قد يتوهم اكثر الناس انها لم تزل في النفس ، وانها تعلم طريقا غير الحس. فاذا حصلت من هذه التجارب في النفس ، صارت النفس عاقلة ، اذ العقل ليس هو شيئا غير التجارب. ومهما كانت هذه التجارب اكثر ، كانت النفس اتمّ عقلا. ثم ان الانسان ، مهما قصد معرفة شيء من الأشياء ، اشتاق الى الوقوف على حال من احوال ذلك الشيء ، وتكلّف الحاق ذلك الشيء في حالته تلك بما تقدم معرفته وليس ذلك الا طلب ما هو موجود في نفسه من ذلك الشيء ، مثل انه متى اشتاق الى معرفة شيء من الأشياء ، هل هو حيّ ام ليس بحي. وقد تقدم فحصل في نفسه معنى الحي ومعنى غير الحي . فانه يطلب بذهنه او بحسه او بهما جميعا احد المعنيين ، فاذا صادفه ، سكن عنده واطمأن به والتذّ بما زال عنه من اذى الحيرة والجهل. وهذا ما قاله افلاطون : ان التعلم تذكر ، وان التفكر هو تكلّف العلم ، والتذكر تكلف الذكر. والطالب مشتاق متكلّف؛ فمهما وجد مهمّا قصد معرفته دلائل وعلامات ومعاني ما كان في نفسه قديما ، فكأنه يتذكر عند ذلك ، كالناظر الى جسم يشبه بعض اعراضه بعض اعراض جسم آخر كان قد عرفه وغفل عنه ، فيتذكره بما ادركه من شبيهه. وليس للعقل فعل مخصّ به دون الحس سوى ادراك جميع الأشياء والاضداد ، وتوهّم احوال الموجودات على غير ما هي عليه. فان الحس يدرك من حال الموجود المجتمع مجتمعا ، ومن حال الموجود المتفرق متفرقا ، ومن حال الموجود القبيح قبيحا ، ومن حال الموجود الجميل جميلا ، وكذلك سائرها. واما العقل ، فانه قد يدرك من حال كل موجود ما قد ادركه الحسّ ، وكذلك ضدّه ، فانه يدرك من حال الموجود المجتمع مجتمعا ومتفرقا معا ، ومن حال الموجود المتفرق متفرقا ومجتمعا معا ، وكذلك سائر ما اشبهها.
فمن تامل ما وضعناه على سبيل الايجاز بما قد بالغ الحكيم ارسطو في وصفه ، في آخر كتاب «البرهان» وفي كتاب «النفس» ، وقد شرحه المفسرون واستقصوا امره ، علم ان الذي ذكره الحكيم في اول كتاب البرهان» وحكيناه في هذا القول ، قريب مما قاله افلاطون في كتاب «فاذن» ، الا ان بين الموضوعين خلافا ، وذلك ان الحكيم ارسطو يذكر ذلك عند ما يريد ايضاح امر العلم والقياس. واما افلاطون فانه يذكره عند ما يريد ايضاح امر النفس. ولذلك اشكل على اكثر من ينظر في اقاويلهما. وفيما اوردناه كفاية لمن قصد سواء السبيل.
15 ـ العالم حادث عند افلاطون وارسطو ، ومن قال ان ارسطو يقول بقدم العالم مخطيء
ومن ذلك ايضا امر العالم وحدوثه؛ وهل له صانع هو علته الفاعلية ، ام لا. ومما يظن بارسطوطاليس انه يرى ان العالم قديم ، وبافلاطون انه يرى ان العالم محدث.
فاقول : ان الذي دعى هؤلاء الى هذا الظن القبيح المستنكر بارسطوطاليس الحكيم ، هو ما قاله في كتاب «طوبيقا» انه قد توجد قضية واحدة بعينها يمكن ان يؤتى على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة ، مثال ذلك : هذا العالم قديم ام ليس بقديم. وقد وجب على هؤلاء المختلفين ، اما اولا ، فبأنّ ما يؤتى به على سبيل المثال لا يجري مجرى الاعتقاد؛ وايضا فان غرض ارسطو في كتاب «طوبيقا» ليس هو بيان امر العالم ، لكن غرضه امر القياسات المركبة من المقدمات الذائعة. وكان قد وجد اهل زمانه يتناظرون في امر العالم : هل هو قديم ام محدث ، كما كانوا يتناظرون في اللذة ، هل هي خير ام شرّ ، وكانوا يأتون على كلا الطرفين من كل مسألة بقياسات ذائعة. وقد بيّن ارسطو في ذلك الكتاب وفي غيره من كتبه ، ان المقدّمة المشهورة لا يراعي فيها الصدق والكذب ، لان المشهور بما كان كاذبا ، ولا يطرح في الجدل لكذبه ، وربما كان صادقا ، فيستعمل لشهرته في الجدل ، ولصدقه في البرهان. فظاهر انه لا يمكن ان ينسب اليه الاعتقاد بان العالم قديم بهذا المثال الذي اتي به في هذا الكتاب.
ومما دعاهم الى ذلك الظن ايضا ، ما يذكره في كتاب «السماء والعالم» ان الكل ليس له بدء زماني ، فيظنون عند ذلك انه يقول بقدم العالم ، وليس الامر كذلك. اذ قد تقدم فبيّن في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والالهية ، ان الزمان انما هو عدد حركة الفلك ، وعنه يحدث. وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء. ومعنى قوله «ان العالم ليس له بدء زماني» ، انه لم يتكوّن اولا فاولا باجزائه ، كما يتكوّن البيت مثلا ، او الحيوان الذي يتكون اولا فاولا باجزائه ، فان اجزاءه يتقدم بعضها بعضا في الزمان . والزمان حادث عن حركة الفلك. فمحال ان يكون لحدوثه بدء زماني. ويصخ بذلك انه انما يكون عن ابداع الباري ، جل جلاله ، اياه دفعة بلا زمان؛ وعن حركته حدث الزمان.
ومن نظر في اقاويله في الربوبية في الكتاب المعروف «باثولوجيا» لم يشبه عليه امره في اثباته الصانع المبدع لهذا العالم. فان الامر في تلك الاقاويل اظهر من ان يخفي. وهناك تبين ان الهيولى ابدعها الباري ، جل ثناؤه ، لا عن شيء؛ وانها تجسمت عن الباري ، سبحانه ، وعن ارادته؛ ثم ترتبت. وقد بيّن في «السماع الطبيعي» ان الكل لا يمكن حدوثه بالبخت والاتفاق؛ وكذلك في العالم جملته. يقول في كتاب «السماء والعالم» : ويستدل على ذلك بالنظام البديع الذي يوجد لاجزاء العالم بعضها مع بعض».
وقد بين هناك ايضا امر العلل ، كم هي ، واثبت الاسباب الفاعلة. وقد بين هناك ايضا امر المكوّن والمحرّك ، وانه غير المتكوّن وغير المتحرّك. وكما ان افلاطون بين في كتابه المعروف «بطيماوس» ان كل متكوّن فانما يكون عن علة مكوّنة له اضطرارا ، وان المتكوّن لا يكون علة لكون ذاته. كذلك ارسطوطاليس بين في كتاب «اثولوجيا» ان الواحد موجود في كل كثرة ، لان كل كثرة لا يوجد فيها الواحد لا يتناهى ابدا البتة . وبرهن على ذلك براهين واضحة ، مثل قوله ان كل واحد من اجزاء الكثير ، اما ان يكون واحدا واما ان لا يكون واحدا ، فان لم يكن واحدا لم يخل من ان يكون اما كثيرا واما لا شيء ؛ وان كان لا شيء لزم ان لا يجتمع منها كثرة ، وان كان كثيرا فما الفرق بينه وبين الكثرة؟ ويلزم ايضا من ذلك ان ما (لا) يتناهى اكثر مما لا يتناهى. ثم بيّن ان ما يوجد فيه الواحد من هذا العالم فهو لا واحد الا بجهة وجهة؛ فاذا لم يكن في الحقيقة واحدا ، بل كان كل واحد فيه موجودا ، كان الواحد غيره وهو غير الواحد. ثم بيّن ان الواحد الحق هو الذي افاد سائر الموجودات الواحدية. ثم بيّن ان الكثير بعد الواحد ، لا محالة. وان الواحد تقدّم الكثرة. ثم بيّن ان كل كثرة تقرب من الواحد الحق كان اول كل كثرة مما يبعد عنه؛ وكذلك بالعكس. ثم يترقى ، بعد تقديمه هذه المقدمات ، الى القول في اجزاء العالم ، الجسمانية منها والروحانية؛ ويبين بيانا شافيا انها كلها حدثت عن ابداع الباري لها؛ وانه ، عز وجل ، هو العلة الفاعلة ، الواحد الحق ، ومبدع كل شيء ، على حسب ما بيّنه افلاطون في كتبه في الربوبية ، مثل «طيماوس» و «بوليطيا» وغير ذلك من سائر اقاويله. وايضا فان «حروف ارسطوطاليس فيما بعد الطبيعة» انما يترقى فيها من الباري ، جل جلاله ، في حرف «اللام» ، ثم ينحرف راجعا في بيان صحة ما تقدم من تلك المقدمات ، الى ان يسبق فيها ، وذلك مما لا يعلم انه يسبقه اليه من قبله ولم يلحقه من بعده الى يومنا هذا. فهل تظن بمن هذا سبيله انه يعتقد نفي الصانع وقدم العالم؟ .
ولا مونيوس رسالة مفردة في ذكر اقاويل هذين الحكيمين في اثبات الصانع ، استغنينا ، لشهرتها ، عن احضارنا اياها في هذا الموضوع. ولو لا ان هذا الطريق الذي يسلكه في هذه المقالة هو الطريق الاوسط ، فمتى ما تنكّبناه كنا كمن ينهى عن خلق ويأتي بمثله؛ لا فرطنا في القول وبيّنا انه ليس لاحد من اهل المذاهب والنحل والشرائع وسائر الطرائق ، من العلم بحدوث العالم واثبات الصانع له وتلخيص امر الابداع ، ما لارسطوطاليس ، وقبله لافلاطون ، ولمن يسلك سبيلهما. وذلك ان كل ما يوجد من اقاويل العلماء ، من سائر المذاهب والنحل ، ليس يدل على التفضيل الا على قدم الطبيعة وبقائها ومن احبّ الوقوف على ذلك ، فلينظر في الكتب المصنفة في المبدءات والاخبار المرويّة فيها ، والآثار المحكيّة عن قدمائهم ، ليرى الاعاجيب عن قولهم بانه كان في الاصل ماء ، فتحرك ، واجتمع زبد ، وانعقد منه الارض ، وارتفع منه الدخان ، وانتظم منه السماء. ثم ما يقوله اليهود والمجوس وسائر الامم ، مما يدل جميعه على الاستحالات والتغاير ، التي هي اضداد الابداع. وما يوجد لجميعهم مما سيؤول اليه امر السماوات والارضين من طيها ولفها وطرحها في جهنم وتبديدها ؛ وما اشبه ذلك مما لا يدل شيء منه علي التلاشي المحض. ولو لا ما انقذ اللّه اهل العقول والاذهان بهذين الحكيمين ، ومن سلك سبيلهما ممن وضّحوا امر الابداع بحجج واضحة مقنعة ، وانه ايجاد الشيء لا عن شيء ، وان كل ما يتكوّن من شيء ما فانه يفسد ، لا محالة ، الى ذلك الشيء؛ والعالم مبدع من غير شيء ، فمآله الى غير شيء؛ فيما شاكل ذلك من الدلائل والحجج والبراهين التي توجد كتبهما مملوّة منها ، وخصوصا ما لهما في الربوبية وفي مبادئ الطبيعة ، لكان الناس في حيرة ولبس. غير ان لنا في هذا الباب طريقا نسلكه يتبين به امر تلك الاقاويل الشرعية ، وانها على غاية السداد والصواب. وهو ان الباري ، جل جلاله ، مدبر جميع العالم ، لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل ، ولا يفوت عنايته شيء من اجزاء العالم ، على سبيل الذي بيناه في العناية ، من ان العناية الكلية شائعة في الجزئيات ، وان كل شيء من اجزاء العالم واحواله موضوع با وقف المواضع واتقنها ، على ما يدل عليه كتب التشريحات ومنافع الاعضاء وما اشبهها من الاقاويل الطبيعية ، وكل امر من الامور التي بها قوامه موكول الى من يقوم بها ضرورة على غاية الاتقان والاحكام الى ان يترقى من الاجزاء الطبيعية الى البرهانيات والسياسيات والشرعيات. والبرهانيات موكولة الى اصحاب الاذهان الصافية والعقول المستقيمة ، والسياسيات موكولة الى ذوي الآراء السديدة؛ والشرعيات موكولة الى ذوي الالهامات الروحانية. واعمّ هذه كلها الشرعيات ، والفاظها خارجة عن مقادير عقول المخاطبين. ولذلك لا يؤاخذون بما لا يطيقون تصوره.
فان من تصوّر في امر المبدع الأول انه جسم ، وانه يفعل بحركة وزمان ، ثم لا يقدر ، بذهنه ، على تصوّر ما هو الطف من ذلك واليق به ، ومهما توهّم انه غير جسيم ، وانه يفعل فعلا بلا حركة وزمان ، لا يثبت في ذهنه معنى متصوّر البتّة. وان أجبر على ذلك زاد غيّا وضلالا؛ وكان فيما يتصوره ويعتقده معذورا مصيبا. ثم يقدر بذهنه على ان يعلم انه غير جسيم ، وان فعله بلا حركة؛ غير انه لا يقدر على تصور انه لا في مكان؛ وان اجبر على ذلك وكلّف تصوّره تبلّد ، فانه يترك على حاله ولا يساق الى غيرها. وكذلك لا يقدر الجمهور على معرفة شيء يحدث لا عن شيء ، ويفسد لا الى شيء؛ فلذلك ما قد خوطبوا بما قدروا على تصوّره وادراكه وتفهّمه ، لا يجوز ان ينسب شيء من ذلك فيما هو في موضعه الى الخطأ والوهي؛ بل كل ذلك صواب مستقيم. فطرق البراهين الحقيقة منشأها من عند الفلاسفة الذين مقدّمهم هذان الحكيمان ، اعني افلاطون وارسطوطاليس.
واما طريق البراهين المقنعة المستقيمة العجيبة النفع ، فمنشؤها من عند اصحاب الشرائع الذين عوّضوا بالابداع الوحي والالهامات. ومن كان هذا سبيله ومحلّه من ايضاح الحجج واقامة البراهين على وحدانية الصانع الحق ، وكان اقاويله في كيفية الابداع وتلخيص معناه باقاويل هذين الحكيمين ، فمستنكر ان يظن بهما فسادا يعتري ما يعتقدانه ، وان رأييهما مدخولان فيما يسلكانه.
16 ـ المثل قال بها افلاطون وارسطو (في كتاب اثالوجيا) ولذا لا يوجد تباين بينهما
ومن ذلك ، الصور والمثل التي تنسب الى افلاطون انه يثبتها ، وارسطو على خلاف رأيه فيهما. وذلك ان افلاطون ، في كثير من اقاويله ، يومئ الى ان للموجودات صورا مجردة في عالم الاله؛ وربما يسميها «المثل الالهية» ؛ وانها لا تدثر ولا تفسد ، ولكنها باقية ، وان
الذي يدثر ويفسد انما هي هذه الموجودات التي هي كائنة. وارسطو ذكر في «حروفه» فيما بعد الطبيعة ، كلاما شنّع فيه على القائلين «بالمثل» «والصور» التي يقال انها موجودة قائمة في عالم الاله ، غير فاسدة؛ وبيّن ما يلزمها من الشناعات ، انه يجب ان هناك خطوطا وسطوحا وافلاكا ، ثم توجد حركات من الافلاك والادوار ، وانه يوجد هناك علوم ، مثل علم النجوم وعلم الالحان ، واصوات مؤتلفة واصوات غير مؤتلفة ، وطب وهندسة ، ومقادير مستقيمة وأخر معوجة ، واشياء حارة وأشياء باردة ، وبالجملة كيفية فاعلة ومنفعلة ، وكليات وجزئيات ، ومواد وصور ، وشناعات اخر ، ينطق بها في تلك الاقاويل ، ما يطول بذكرها هذا القول. وقد استغنينا ، لشهرتها ، عن الاعادة ، مثل ما فعلنا بسائر الاقاويل حيث اومأنا اليها والى اماكنها ، وخلّينا ذكرها بالنظر فيها والتأويل لها لمن يلتمسها من مواضعها فان الغرض المقصود من مقالتنا هذه ايضاح الطرق التي ، اذا سلكها طالب الحق ، لم يضل فيها ، وامكنه الوقوف على حقيقة المراد باقاويل هذين الحكيمين ، من غير ان ينحرف عن سواء السبيل الى ما تخيّله الالفاظ المشكلة.
وقد نجد ان ارسطو ، في كتابه في الربوبية المعروف ب «اثولوجيا» يثبت الصور الروحانية ، ويصرح بانها موجودة في عالم الربوبية. فلا تخلو هذه الاقاويل ، اذا اخذت على ظاهرها ، من احدى ثلاث حالات: اما ان يكون بعضها متناقضة بعضها؛ واما ان يكون بعضها لارسطو وبعضها ليس له؛ واما ان يكون لها معان وتأويلات تتّفق بواطنها وان اختلف ظواهرها ، فتتطابق عند ذلك وتتفق. فاما ان يظن بارسطو ، مع براعته وشدّة يقظته وجلاله هذه المعاني عنده ، اعني الصور الروحانية ، انه يناقض نفسه في علم واحد ـ وهو العلم الربوبي ـ فبعيد ومستنكر. واما ان بعضها لارسطو وبعضها ليس له ، فهو ابعد جدا ، اذ الكتب الناطقة بتلك الاقاويل اشهر من ان يظنّ ببعضها انه منحول. فبقي ان يكون لها تأويلات ومعان ، اذا كشف عنها ، ارتفع الشك والحيرة.
فنقول انه ، لما كان الباري ، جلّ جلاله ، بانيّته وذاته ، مباينا لجميع ما سواه ، وذلك لانه بمعنى اشرف وافضل واعلى ، بحيث لا يناسبه في انيّته ولا يشاكله ولا يشابهه حقيقة ولا مجازا ، ثم مع ذلك لم يكن بدّ من وصفه واطلاق لفظ فيه من هذه الالفاظ المتواطئة عليه ، فان من الواجب الضروري ان يعلم ان مع كل لفظة نقولها في شيء من اوصافه ، معنى بذاته بعيد من المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة. وذلك كما قلنا بمعنى اشرف واعلى ، حتى اذا قلنا انه موجود؛ علمنا مع ذلك ان وجوده لا كوجود سائر ما هو دونه. واذا قلنا انه حي ؛ علمنا انه حي بمعنى اشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه. وكذلك الامر في سائرها. ومهما استحكم هذا المعنى وتمكّن من ذهن المتعلّم للفلسفة التي بعد الطبيعيات ، سهل عليه تصوّر ما يقوله افلاطون وارسطوطاليس ومن سلك سبيلهما.
فنرجع الآن الى حيث فارقناه؛ فنقول : لما كان اللّه تعالى حيّا موجدا لهذا العالم بجميع ما فيه ، فواجب ان يكون عنده صور ما يريد ايجاده في ذاته ، جلّ اللّه من اشتباه.
وايضا ، فان ذاته ، لما كانت باقية ، لا يجوز عليه التبدّل والتغيّر. فما هو بحيّزه ايضا كذلك باق غير داثر ولا متغير. ولو لم يكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجد الحي المريد ، فما الذي كان يوجده؟ وعلى اي مثال ينحو بما يفعله ويبدعه؟ أما علمت انّ من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد ، لزمه ان يقول بان ما يوجده انما يوجده جزافا وتنحّسا وعلى غير قصد؛ ولا ينحو نحو غرض مقصود بارادته. وهذا من اشنع الشناعات.
فعلى هذا المعنى ينبغي ان تعرف وتصوّر اقاويل أولئك الحكماء فيما اثبتوه من الصور الالهية؛ لا على انها اشباح قائمة في اماكن اخر خارجة عن هذا العالم. فانها متى تصوّرت على هذا السبيل ، يلزم القول بوجود عوالم غير متناهية ، كلها كأمثال هذا العالم. وقد بيّن الحكيم ارسطو ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة في كتبه في «الطبيعيات» . وشرح المفسّرون اقاويله بغاية الايضاح. وينبغي ان
__________________
هذا تفسير خاطيء لمعني المثل عند افلاطون. انها بنظر الفارابي صور في ذات الله علي مثالها خلق الموجودات الحسية. ولكنها في الواقع تشكل عالماً قائماً بذاته كما يستفاد من كتب افلاطون.
هنا يشير الفارابي الي النقد الذي وجهه أرسطو إلي نظرية المثل. وقد انتقدها مراراً ليس في الكتب الطبيعية كما يقول الفارابي بل في كتاب الاخلاق الي نيقوماخس.
تتدبّر هذا الطريق الذي ذكرناه مرارا كثيرة في الاقاويل الالهية؛ فانه عظيم النفع وعليه المعوّل في جميع ذلك ، وفي اهماله الضرر الشديد. وان تعلم ، مع ذلك ، ان الضرورة تدعو الى اطلاق الالفاظ الطبعية والمنطقية المتواطئة على تلك المعاني اللطيفة الشريفة ، العالية عن جميع الاوصاف ، المتباينة عن جميع الامور الكيانية الموجودة بالوجود الطبيعي. فانه ان قصد لاختراع الفاظ اخر واستئناف وضع لغات ، سوى ما هي مستعملة ، لما كان يوجد السبيل الى الفاظه ، ويتصوّر منها غير ما باشرته الحواسّ. فلما كانت الضرورة تمنع وتحول بيننا وبين ذلك ، اقتصرنا على ما يوجد من الالفاظ ، واوجبنا على انفسنا الاخطار بالبال ان المعاني الالهية التي يعبر عنها بهذه الالفاظ ، هي بنوع اشرف وعلى غير ما نتخيّله ونتصوّره.
ومما يجري هذا المجرى ، اقاويل افلاطون في كتاب «طيماوس» من كتبه في امر النفس والعقل؛ وان لكل واحد منهما عالما سوى عالم الآخر ، وان تلك العوالم متتالية ، بعضها اعلى وبعضها اسفل. وسائر ما قال مما اشبه ذلك. ومن الواجب ان نتصور منها شبه ما ذكرناه ، انه انما يريد بعوالم العقل حيّزه وكذلك بعوالم النفس. لا ان للعقل مكانا وللنفس مكانا وللباري تعالى مكانا ، بعضها اعلى وبعضها اسفل ، كما يكون للاجسام. فان ذلك مما يستنكره المبتدئون بالتفلسف ، فكيف المرتاضون بها؟ وانما يريد بالاعلى والاسفل الفضيلة والشرف ، لا المكان السطحي. وقوله «عالم العقل» انما هو ، على ما يقال ، عالم الجهل وعالم العلم وعالم الغيب؛ ويراد بذلك حيز كل واحد منها.
وكذلك ما قاله من افاضة النفس على الطبيعة ، وافاضة العقل على النفس؛ انما اراد به افاضة العقل بالمعونة في حفظ الصور الكلية عند احساس النفس بمفصّلاتها ، والتفصيل عند احساسها بمجتمعاتها وتحصيلاتها ما يودعه اياها من الصور الدائرة الفاسدة. وكذلك سائر ما يجري مجراها من معونة العقل للنفس. واراد بافاضة النفس للطبيعة ، ما تفيدها من المعونة ، والانسياق نحو ما ينفعها ، مما به قوامها؛ ومنه التذاذها والتلطف بها وسائر ما اشبه ذلك.
واراد برجوع النفس الى عالمها ، عند الاطلاق من محبسها ، ان النفس ما دامت في هذا العالم فانها مضطرة الى مساعدة البدن الطبيعي ، الذي هو مجلها ، كانها تشتاق الى الاستراحة . فاذا رجعت الى ذاتها ، فكانها اطلقت من محبس مؤذ الى حيزها الملائم المشاكل لها. وعلى هذه الجهة ينبغي ان يقاس كل ما سوى ما ذكرناه من تلك الرموز. فان تلك المعاني ، بدقتها ولطفها ، تمنعت عن العبارة عنها بغير تلك الجهة التي استعملها الحكيم افلاطون ومن سلك سبيله. وان العقل ، على ما بيّنه الحكيم ارسطو ، في كتبه في «النفس»،
وكذلك الاسكندر ، وغيره من الفلاسفة ، هو اشرف اجزاء النفس ، وانه هي بالفعل ناجزة ، وبه تعلم الالهيات ، ويعرف الباري ، جل ثناؤه. فكأنه اقرب الموجودات اليه شرفا ولطفا وصفاء؛ لا مكانا وموضعا. ثم تتلوه النفس ، لانها كالمتوسطة بين العقل والطبيعة ، اذ لها حواس طبيعية؛ فكأنها متحدة من احد طرفيها بالعقل ، الذي هو متحد بالباري ، جل وعز ، على السبيل الذي ذكرناه؛ ومن الطرف الآخر متحدة بالطبيعة؛ وكانت الطبيعة تتلوها كيانة لا مكانا. فعلى هذا السبيل ، وعلى ما يشاكلها مما يعسر وصفها قولا ، ينبغي ان تعلم ما يقوله افلاطون في اقاويله. فانها مهما أجريت هذا المجرى ، زالت الظنون والشكوك التي تؤدي الى القول بان بينه وبين ارسطو اختلافا في هذا المعنى. الا ترى ان ارسطو ، حيث يريد ان يبيّن من امر النفس والعقل والربوبية حالا ، كيف يجرؤ ويتشدّق في القول ، ويخرج مخرج الالغاز على سبيل التشبيه؟
وذلك في كتابه المعروف «باثولوجيا» ، حيث يقول : «اني ربما خلوت بنفسي كثيرا ، وخلعت بدني ، فصرت كاني جوهر مجرد بلا جسم؛ فاكون داخلا في ذاتي وراجعا اليها ، وخارجا من سائر الأشياء سواي؛ فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا ، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء ما بقيت متعجبا. فاعلم عند ذلك ، اني من العالم الشريف جزء صغير؛ فاني لمحيّا فاعل؛ فلما ايقنت بذلك ترقّيت
بذهني من ذلك العالم الى العالم الالهي ، فصرت كأني هناك متعلق بها؛ فعند ذلك يلمع لي من النور والبهاء ما يكلّ الألسن عن وصفه ، والاذان عن سمعه ؛ فاذا استغشي في ذلك النور وبلغت طاقتي ، ولم اقو على احتماله ، هبطت الى عالم الفكرة؛ فاذا صرت الى عالم الفكرة ، حجبت عني الفكرة ذلك النور ، وتذكرت ، عند ذلك ، اخي يرقليطوس ، من حيث امر بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة بالصعود الى عالم العقل». ـ هذا في كلام له طويل ، يجتهد فيه ويروم بيان هذه المعاني اللطيفة؛ فيمنعه العقل الكياني عن ادراك ما عنده وايضاحه.
فمن اراد ان يقف على يسير ما أومئوا اليه ، فان الكثير منه عسير وبعيد. فليحفظ ما ذكرناه بذهنه ، ولا يتبع الالفاظ متابعة تامّة ، لعله يدرك بعض ما قصد بتلك الرموز والالغاز. فانهم قد بالغوا واجتهدوا ، ومن بعدهم الى يومنا هذا ، ممن لم يكن قصدهم الحق؛ بل كان كدّهم العصبية وطلب العيوب؛ فحرفوا وبدلوا ، ولم يقدروا ، مع الجهد والعناية والقصد التامّ ، على الكشف والايضاح. فانّا ، مع شدة العناية بذلك ، نعلم انّا لم نبلغ من الواجب فيه الاّ ايسر اليسير ، لان الامر في نفسه صعب ممتنع جدا.
17 ـ قول افلاطون وارسطو بالدينونة
ومما يظن بالحكيمين ، افلاطون وارسطو ، انهما لا يريانه ولا يعتقدانه ، امر المجازاة والثواب والعقاب. وذلك وهم فاسد بهما. فان ارسطو صرح بقوله ان المكافأة واجبة في الطبيعة. ويقول في «رسالته» التي كتبها الى والدة الاسكندر ، حين بلغها بغيه وجزعت عليه وعزمت على التشكك بنفسها. واول تلك الرسالة : «فاما شهود اللّه في ارضه التي هي الانفس العالمة ، فقد تطابقت على ان الاسكندر العظيم من افضل الاخيار الماضين؛ واما الآثار الممدوحة ، فقد رسمت له في عيون اماكن الارض واطراف مساكن الانفس ، بين مشارقها ومغاربها ؛ ولن يؤتي اللّه احدا ما اتاه الاسكندر ، (الاّ) من اجتباء واختيار؛ والخير من اختاره اللّه تعالى. فمنهم من شهدت عليه دلائل الاختيار؛ ومنهم من خفيت تلك فيه. والاسكندر اشهر الماضين والحاضرين دلائل ، واحسنهم ذكرا واحمدهم حيوة ، واسلمهم وفاة. يا والدة اسكندر ، ان كنت مشفقة على العظيم اسكندر ، فلا تكسبنّ ما يبعدك عنه ، ولا تجلبي على نفسك ما يحول بينك وبينه ، حين الالتقاء في زمرة الاخيار ، واحرصي على ما يقرّبك منه؛ ».
فهذا ، وما يتلوه من كلامه ، يدل دلالة واضحة على انه كان يوجب المجازاة معتقدا …
واما افلاطون ، فانه اودع آخر كتابه في «السياسة» القصة الناطقة بالبعث والنشور والحكم ، والعدل ، والميزان ، وتوفية الثواب والعقاب على الاعمال ، خيرها وشرها.
الخاتمة
فمن تأمل ما ذكرناه من اقاويل هذين الحكيمين ، ثم لم يعرّج على العناد الصراع ، اغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة ، والاوهام المدخولة ، واكتساب الوزر ، بما ينسب الى هؤلاء الافاضل ، مما هم منه براء وعنه بمعزل.
وعند هذا الكلام نختم القول فيما رمنا بيانه ، من الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون وارسطوطاليس.
والحمد للّه حقّ حمده ، والصلاة على النبي محمد ، خير خلقه ، وعلى الطاهرين من عشرته ، والطيبين من ذريته آمين.
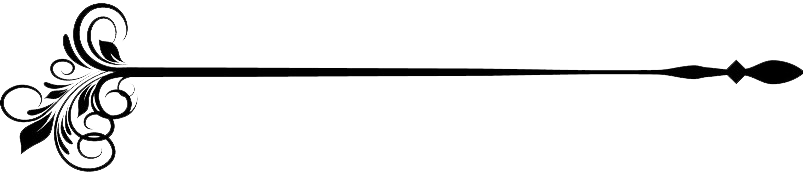
.رسالة الطير للغزالي . في ذكر العنقاء
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها، وزعمت أنه لا بدّ لها من مَلِكٍ: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخَبَرَ عن استيطانها في مواطن الغَرب وتَقَرُرِها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها، والاستظلال بظلها، والمثول بفنائها، والاستسعاد بخدمتها، فتناشدوا وقالوا:
قوموا إلى الدّار من ليلى نُحَييها … نعم ونسألهم عن بعض أهليها
و إذا الأشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزَعمت بلسان الطَلب: بأي نواحي الأرض أبغي وصالكم، وأنتم ملوك ما لمقصدهم نَحْوُ.
و إذا هم بمنادي الغيب ينادي من وراء الحُجُبِ: ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .
لازموا أماكنكم ولا تفارقوا مساكنكم، فإنكم إن فارقتم أوطانكم، ضاعفتهم أشجانكم، فدُونَكُم والتعرض للبلاء والتحلل ِبالفَنَاء:
إن السلامة من سُعْدَى وجارتِها … أن لا تَحِلَّ على حالٍ بِواديها
فلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقا وقلقا وتحيرا وأرَقَا، وقالوا من عند آخرهم:
و لو داواك كلّ طبيبِ إنسٍ … بغير كلامِ ليلى ما شفاكا
و زعموا:
إنّ المحبّ الّذي لا شيء يُقنعه … أو يَستقرّ ومن يَهوى به الدار
ثم نادى لهم الحنين، ودب فيهم الجنون، فلم يتلعثموا في الطلب اهتزازا منهم إلى بلوغ الأرب.
فقيل لهم: بين أيديكم المهامة الفيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأماكن القَرِّ ومساكن الحَرِّ، فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية، فالأحرى بكم مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع، وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول، ولا يبالون، بل رحلوا وهم يقولون:
فريد عن الخلّان في كلّ بلدة … إذا عَظُمَ المطلوب قَلَّ المُساعد
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد ألجمها بلجام الشوق وقوّمها بقوام العشق وهو يقول:
ِانظر إلى ناقتي في ساحة الوادي … شديدة بالسّرى من تحت مَيّاد
إذا اشتكت من كلال البَيْنِ أوعدها … روح القدوم فتحيا عند ميعادي
لها بوجهك نور تستضيء به … و في نَوالك من أعقابها حادي
فرحلوا من محجة الاختبار، فاستدرجَتْهم بِحَدِّ الاضطرار، فهلك من كان من بلاد الحر في بلاد البرد، ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحر، وتصرفت فيهم الصواعق. وتحكمت عليهم العواصف حتى خَلُصَت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك، ونزلوا بفنائه واستظلوا بجنابه، والتمسوا من يُخبرَ عنهم المَلِكَ وهو في أمنع حِصنٍ من حِمى عِزِّه، فأُخْبِرَ بهم فتقدمَ إلى بعض سكان الحضرة أن يسألهم: ما الذي حملهم على الحضور؟ فقالوا: حضرنا ليكون مليكنا، فقيل لهم: أتعبتم أنفسكم فنحن المَلِكُ شئتم أو أبيتم، جئتم أو ذهبتم، لا حاجة بنا إليكم، فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجلوا وخابت ظنونهم فتعطلوا فلما شملهتم الحَيرة، وبهرتهم العزة، قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد تخاذلت القوى وأضعفنا الجوى، فليتنا تُركنا في هذه الجزيرة لِنَمُوتَ عن آخرنا، وأنشؤوا يقولون هذه الأبيات:
أسُكّانُ رامةَ هل من قِرى … فقد دَفع اللّيلُ ضَيفا قَنوعا
كفاهُ من الزّاد إن تُمَهدوا … له نَظَرا وكلاما وسِيعا
هذا وقد شملهم الداء، وأشرفوا على الفناء، ولجؤوا إلى الدعاء:
ثُمْلٌ نشاوى بكأس الغرام … فكلّ غدا لأخيه رضيعا
فلما عمّهم اليأس، وضاقت بهم الأنفاس تداركتهم أنفاس الإيناس وقيل لهم: هيهات فلا سبيل إلى اليأس، فلا ييأس من روح اللّه إلا القوم الخاسرون، فإن كانَ كمالُ الغِنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم أوجب السماحة والقبول، فبعد أن عرفتم مقداركم في العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكم فهُوُ دارُ الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيدُ الكُلِّ وسَابِقُهُمْ: “أحيني مسكينا”. ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالمَلك العنقاء أن يتخذه قرينا، فلما استأنسوا بعد أن استَيْأسُوا، وانتعشوا بعد أن تَعَبَّسُوا ووثِقوا بفيض الكرم واطمأنوا إلى دُرُورِ النِعَمِ سألوا عن رفقائهم فقالوا: ما الخَبَرُ عن أقوام قَطَعَتْ بهم المهامة والأودية، أمطلول دماؤهم أم لهم دِيةٌ؟ فقيل: هيهات هيهات: ومَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .
اجتبتهم أيادي الاجتباء بعد أن أبادتهم سطوةُ الابتلاء: ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ . قالوا: فالذين غرقوا في لجج البحار، ولم يصلوا إلى الدار ولا إلى الدَّيّار. بل التقمتهم لهوات التّيار. قيل: هيهات. ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتا بَلْ أَحْياءٌ . فالذي جاء بكم وأمَاتَهُم أحياهُم، والذي وكّل بكم داعية الشوق حتى استقللتم العناء والهلاك في أريحية الطلب دَعَاهُم وحَمَلَهم وأدناهم وقَرَّبَهم، فهم
في حُجب العزة وأستار القدرة: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ . قالوا: فهل لنا إلى مشاهدتهم سبيل؟ قيل: لا، فإنكم في حِجاب العزة وأستار البشرية، وأسر الأجل وقيده، فإذا قضيتم أوطاركم وفارقتم أوكاركم، فعند ذلك تزاورتم وتلاقيتم، قالوا: والذين قعد بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ قيل: هيهات ولَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ . ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهناهم فطردناهم. أأنتم بأنفسكم جئتم أم نحن دعوناكم؟ أأنتم اشتقتم أم نحن شوّقناكم؟ نحن أقلقناكم فحملناكم وحملناهم في البر والبحر، فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضمان الكفاية كَمُلَ اهتزازُهم وتَمَّ وُثوقهم فاطمأنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكين، وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين، ولَتَعْلَمُنَّ نبأه بعد حين.
فصل
أتُرى هل كانَ بين الراجعِ إلى تلك الجزيرة وبين المبتدئ من فرق؟ إنما قال: جئنا ملكنا من كان مبتدئا، أما من كان راجعا إلى عيشه الأصلي يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . فرجَع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول: لم دُعِيتُ لا بل فيقول لِمَ حُمِلتُ إلى تلك البلاد وهي بلاد القُرْبَةِ، والجواب على قدر السؤال، والسؤال على قدر التفقّه، والهموم بقدر الهمم.
فصل
من يَرْتَاعُ لمثل هذه النُكَتِ فليُجدد العهد بطور الطيرية، وأريحية الروحانية، فكلام الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور، وتجديد العهد بملازمة الوضوء، ومراقبة أوقات الصلاة، وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الحلو في غفلة لا بدّ من أحد الطريقين، فاذكروني أذكركم، أو نسوا اللّه فنَسِيَهُم.
فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكرني، ومن سلك النسيان: ومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وابن آدم في كل نَفَسٍ مُصححٌ أحدى هاتين النِسبتين ولا بُد يتلوه يوم القيامة أحد السيماءين. أما يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، أنقذك اللّه بالتوفيق، وهداك إلى التحقيق، وطوى لك الطريق، إنه بذلك حقيق. والحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين.
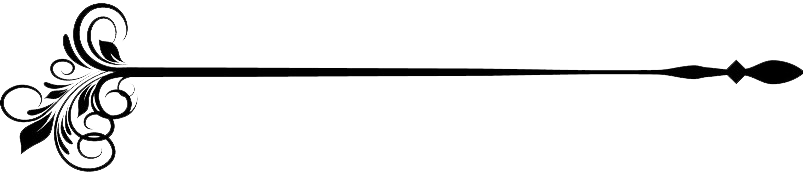
.من كتاب الحجاب. لأبي عثمانَ عمرو بنُ بَحْر الجاحظ
.قال أبو عثمان.
أطال الله بقاك، وجعلني من كلِّ سوءٍ فداك، وأسعدك بطاعته، وتَوَلَّاك بكرامته، ووالى إليك مَزيدَه.
اعلم أنه يقال — أكرمك الله — إن السعيد من وُعظ بغيره، وإن الحكيم من أحكمته تجاربه. وقد قيل: كفاك أدبًا لنفسك ما كَرِهتَ من غيرك. وقيل: كفاك من سُوءِ الفعل سماعه. وقيل: إن من يقظة الفهم للواعظ ما يدعو النفس إلى الحذَر من الخطأ والعقل إلى تصفيته من القَذى. وكانت الملوك إذا أتت ما يَجِل عن المُعاتَبة عليه ضُربت لها الأمثال وعُرِّضَ لها بالحديث. وقال الشاعر:
الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالعَصَا
وَالحُرُّ تَكْفِيهِ المَلَامَة
وقال آخر: «ويَكفِيك سَوءاتِ الأُمورِ اجتِنابُها.» وقال المتلمس:
لِذِي الحِلْمِ قَبْلَ اليَوْمِ مَا تُقْرَعُ العَصَا
ومَا عُلِّمَ الإنْسَانُ إلَّا لِيَعْلَمَا
وقال بعضهم: في خَفِيِّ التعريض ما أغنى عن شنيعِ التصريح.
وقد جَمعتُ في كتابي هذا ما جاء في الحجاب من خبر وشعر ومُعاتَبة وعَذْل وتصريح وتعريض. وفيه ما كفى وبالله التوفيق. وقد قُلتُ:
كَفَى أَدَبًا لِنَفْسِكَ مَا تَرَاهُ
لِغَيْرِكَ شَائِنًا بَيْنَ الأَنَامِ
ما جاء في الحجاب والنهي عنه: رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: ثلاثٌ من كُنَّ فيه من الولاة اضطَلع بأمانته وأمره! إذا عدل في حُكمه، ولم يحتجب دون غيره، وأقام كتاب الله في القريب والبعيد. ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وجَّه عليَّ بن أبي طالب عليه السلامُ إلى بعض الوجوه، فقال له فيما أوصاه به: إنِّي قد بعثتُك وأنا بكَ ضَنِينٌ، فابرُزْ لِلناس، وقَدِّمِ الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والنساء قبل الرجال، ولا تُدخِلَن أحدًا يَغلِبك على أمرك، وشاوِرِ القرآن فإنه إمامُك. ولا ينبغي أن يكون الحاجب جهولًا ولا عييًّا ولا غبيًّا ولا ذَهولًا ولا مُتشاغلًا ولا خاملًا ولا مُحتقرًا ولا جهمًا ولا عبوسًا. فإنه إن كان جهولًا أدخل على صاحبه الضرر من حيث يقدر المنفعة، وإن كان عييًّا لم يؤد إلى صاحبه ولم يؤد عنه، وإن كان غبيًّا جَهِل مكان الشريف فأَحلَّه غير منزلته وحطِ عن مرتبته وقدم الوضيع عليه وجهل ما عليه وما له، وإن كان ذهولًا متشاغلًا أخلَّ بما يحتاج إليه صاحبه في وقته وأضاع حقوق الغاشِين لبابه واستدعى الذمَّ من الناس له وأذن عليه لمن لا يحتاج إلى لقائه ولا ينتفع بمكانه، وإذا كان خاملًا محتقرًا أحل الناس صاحبه في محله وقضَوا عليه به، وإن كان جهمًا عبوسًا تلقى كل طبقة من الناس بالمكروه، فترك أهل النصائح نصائحهم وأَخلَّ بذوي الحاجات في حوائجهم وقَلَّت الغاشية لباب صاحبه فرارًا من لقائه.
وقد أوصى أحد الولاة عالمه حين ولَّاه مصر: إن الناس قد أكثروا عليك، ولعلك لا تحفظ، فاحفظ عني ثلاثًا. قال: قُل يا أمير المؤمنين. قال: انظر من تجعلُ حاجِبَك ولا تَجعلْه إلا عاقلًا فهِمًا مُفهمًا، صَدوقًا لا يُورِد عليك كَذِبًا، يُحسِن الأداء إليك والأداء عنك، ومُرْ ألَّا يقف على بابك أحدٌ من الأحرار إلا أخبرك حتى تكون أنت الآذِن له أو المانع، فإن لم تفعل كان هو الأمير وأنت الحاجب، وإذا خَرجتَ إلى أصحابك فَسلِّم عليهم يأنسوا بك، وإذا هَممتَ بعقوبةٍ فتأنَّ فيها فإنك على استدراكها قبل فَوتِها أَقدرُ منك على انتزاعها بعد فوتها.
وقال سهل بن هارون للفضل بن سهل: إن الحاجب أحدُ وجهَي المَلِك يعتبر عليه برأفته ويَلحقه ما كان في غِلظته وفظاظته، فاتخذ حاجبك سهل الطبيعة معروفًا بالرأفة مألوفًا منه البر والرحمة، وليكن جميل الهيئة حسن البسطة ذا قَصدٍ في نيَّته وصالحِ أفعاله، ومُرْه فليَضعِ الناس على مراتبهم وليأذنْ لهم في تفاضُلِ منازلِهم وليُعطِ كلًّا بَسطةً من وجهه ولْيَستعطِفْ قلوب الجميع إليه حتى لا يغشى الباب أحدٌ وهو يخاف أن يقصر به عن مَرتبتِه ولا أن يُمنَع في مدخلٍ أو مجلسٍ أو موضعِ إذنٍ شيئًا يستحقه، ولا يمنع أحدًا مَرتبتَه وليَضعْ كُلًّا عند منزلته وتعهده، فإن قَصَّر مُقصِّر قام بحُسنِ خلافتِه وبتزيينِ أمره.
وقال كسرى أنو شروان في كتابه المُسمَّى «شاهي»: ينبغي أن يكون صاحب إذن الخاصَّة رجلًا شريف البيت بعيد الهِمة بارع الكرم متواضعًا طَلْقًا مُعتدِل الجسم بهي المنظر ليِّن الجانب، ليس ببذِخ ولا بطِر ولا مرِح، ليِّن الكلام طالبًا للذكر الحَسن مشتاقًا إلى مُحادَثة العلماء ومُجالَسة الصلحاء، مُحبًّا لكل ما زيَّن عمله، مُعاندًا للسعاة، مُجانبًا للكذابين، صدوقًا إذا حدَّث، وفيًا إذا وعد، متفهمًا إذا خُوطب، مُجيبًا بالصواب إذا رُوجع، منصفًا إذا عامل، آنسًا مؤانسًا، محبًّا للأخيار، شديد الحُنو على المملكة، أديبًا له لطافة في الخدمة وذكاء في الفهم وبسطة في المنطق ورفق في المحاورة وعلم بأقدار الرجال وأخطارها. وقال في حاجب العامَّة: ينبغي أن يكون حاجب العامَّة رجلًا عبْد الطاعة، دائم الحراسة للملكة، مَخُوف اليد حسن الكلام مروعًا غير باطش إلا بالحق، لا أنيس ولا مأنوس، دائم العُبوس شديدًا على المُريب، غيرَ مُستخِف بخاصَّة الملك ومن يهوى ويُقرِّبه من بطانته.
من عُوتب على حجابه أو هُجي به: روى إسحاق الموصلي عن ابن كُناسة قال: أُخبِرتُ أن هانئ بن قبيصة وفد على يزيد بن معاوية فاحتجب عنه أيامًا، ثم إن يزيد ركب يومًا فتَلقَّاه هانئ فقال: يا يزيد، إن الخليفة ليس بالمُحتجِب المُختلي ولا المُتطرِّف المُنتحي، ولا الذي ينزل على الغُدران والفَلَوات ويخلو للذَّات والشهوات، وقد وليت أمرنا فأقم بين أَظهُرنا وسَهِّل إذننا واعمَل بكتاب الله فينا، فإن كُنتَ قد عَجَزتَ عمَّا ههنا فاردُد علينا بَيعَتنا لنبايع من يعمل بذلك فينا ويُقِيمه لنا، ثم عليك بخلواتك وصيدك وكلابك! قال: فغضب يزيد وقال: والله لولا أن أسُنَّ بالشام سُنة العراق لأَقمتُ أَوَدك. ثم انصرف وما هاجه بشيء وأَذِن له ولم تتغيَّر منزلته عنده وترك كثيرًا مما كان عليه.
الموصلي قال: كان سعيد بن سلم واليًا على إرمينية، فورد عليه أبو دُهمان الغلابي فلم يصل إليه إلا بعدَ حين، فلما وصل قال وقد مثل بين السِّماطَين: والله إني لأعرف أقوامًا لو علموا أن سَفَّ التراب يُقيم من أَوَد أصلابهم لجعلوه مُسكةً لأرماقهم، إيثارًا للتنزُّه عن العيش الرقيق الحواشي، والله إني لبَعيدُ الوثبة بَطيءُ العَطفة، إنه والله ما يثنيني عليك إلا مثل ما يصرفني عنك، ولأن أكون مملقًا مقربًا أَحبُّ إليَّ من أن أكون مكثرًا مبعدًا، والله ما نسأل عملًا لا نضبطه ولا مالًا إلا ونحن أَكثرُ منه، وإن الذي صار في يدك قد كان في يد غيرك فأمسَوا والله حديثًا إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر، فتَحبَّبْ إلى عباد الله بحُسن البشر ولِين الحِجاب فإن حُبَّ عبادِ الله موصولٌ بحب الله وهم شهداء الله على خلقه وأمناؤه على من اعوجَّ عن سبيله.
إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: استبطأني جعفر بن يحيى وشكا ذلك إلى أبي، فدَخلتُ عليه — وكان شديد الحجاب — فاعتَذرتُ إليه وأعلمته أنني أَتيتُ إليه مرارًا للسلام فحجبني نافذٌ غلامُه. فقال لي وهو مازح: متى حجَبك فنله. فأتيته بعد ذلك للسلام فحجبني، فكَتبتُ إليه رقعة فيها:
جُعِلْتُ فِدَاءَكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ
إلى حُسْنِ رَأْيكَ أشْكُو أُناسًا
يَحُولُون بَيني وبَيْنَ السَّلَامِ
فَمَا إنْ أُسَلِّمُ إلَّا اخْتِلاسًا
وأَنْفَذْتُ أمْرَكَ فِي نَافِذٍ
فَمَا زَادَهُ ذَاكَ إلَّا شِماسًا
وسألتُ نافذًا أن يُوصلَها ففعل، فلما قرأها ضَحِك حتى فَحَص برجلَيه وقال: لا تحجُبه أيَّ وقتٍ جاء. فصِرتُ لا أُحجب.
وحُجب أحمد بن أبي طاهر ببابِ بعضِ الكتاب فكتب إليه: ليس الحر من نفسه عِوض، ولا من قدْره خطر، ولا لبذل حريته ثمن، وكلُّ ممنوع فمُستغنًى عنه بغيره، وكلُّ مانع ما عنده ففي الأرض عِوضٌ عنه ومندوحةٌ عنه. وقد قيل: أرخص ما يكون الشيء عند غلائه. وقال بشار: «والدُّرُّ يُترك من غلائه.» ونحن نعوذ بالله من المطامع الدنيَّة والهمة القصيرة، ومن ابتذال الحرية، فإن نفسي والله أبيَّة ما سقطت وراء همة، ولا خذلها ناصرٌ عند نازلة، ولا استرقَّها طمع، ولا طُبعت على طَبَع، وقد رأيتك ولَّيتَ عِرضك من لا يصونه، ووكَّلْت ببابك من يَشِينه، وجعلتَ ترجُمان كرمك من يُكثر من أعدائك، وينقص من أوليائك، ويسيء العبارة عن معروفك، ويُوجِّه وفود الذم إليك، ويُضغِن قلوب إخوانك عليك؛ إذ كان لا يعرف لشريف قدْرًا، ولا لصديق منزلةً، ويُزيل المراتب عن جهاتها ودرجاتها، فيحُط العلي إلى مرتبة الوضيع، ويرفع الدنيء إلى مرتبة الرفيع، ويقبل الرُّشا، ويُقدم على الهوى، وذلك إليك منسوبٌ وبرأسك معصوب، يَلزمُك ذنبه ويَحِل عليك تقصيره.
وحدَّثني عبد الله بن أبي مروان الفارسي قال: ركبت مع ثُمامة بن أشرس إلى أبي عباد الكاتب في حوائج كتب إليَّ فيها أهل أرمينية من المعتزلة والشيعة، فأتيناه فأعظم ثُمامة وأَقعدَه في صَدر المجلس وجلس قُبالته — وعنده جماعةٌ من الوجوه — فتَحدَّثْنا ساعةً ثم كلمه ثُمامة في حاجتي وأَخرجتُ كُتب القوم فقرأها — وقد كانوا كتبوا إلى أبي عباد كُتبًا وكانوا أصدقاءه أيام كونه بأرمينية — فقال لي: بكِّر إليَّ غدًا حتى أكتب جواباتها إن شاء الله. فقلتُ: جعلني الله فِداك، تأمر الحاجبَ إذا جئتُ أن يأذن لي. فغَضِب من قولي واستشاط مني فقال: متى حُجِبتُ أنا؟ أَوَلي حاجب أو لأحد عليَّ حجاب؟ قال عبد الله: وقد كنت أتيته فحجبني بعض غلمانه، فحلف بالأيمان المُغلَّظة أن يقلع عينَي من يحجُبني، ثم قال: يا غلام، لا تُبقِ في الدار غلامًا ولا مُنقطِعًا إلينا إلا أحضَرتُمونيه الساعة. فأتى بغلمانه وهم نحوٌ من ثلثمائة، فقال: أَشِر إلى من شئت منهم. فغمزني ثُمامة. فقلتُ: جُعلتُ فِداك، لا أعرف الغلام بعينه. فقال: ما كان لي حاجبٌ قط ولا احتَجبتُ؛ وذلك لأنه سبق مني قول، لأني كنت وأنا بالري وقد مات أبي وخلَّف لي بها ضياعًا فاحتَجتُ إلى ملاقاة الرجال والسلطان فيما كان لنا، فكنت أنظر إلى الناس يدخلون ويصلون وكنت أُحجَب أنا وأُقصَى، فتتقاصر إليَّ نفسي ويضيق صدري، فآليتُ على نفسي إن صِرتُ إلى أَمرٍ من السلطان ألَّا أحتجب أبدًا.
وحدَّثني الزبير بن بكار قال: استأذن نافع بن جبير بن مطعم على معاوية فمنعه الحاجب فدَقَّ أنفه، فغضب معاوية — وكان جُبير عنده — فقال معاوية: يا نافع، أتفعل هذا بحاجبي؟ قال: وما يمنعني منه وقد أساء أدبه وأسأتَ اختياره، ثم أنا بالمكان الذي أنا به منك؟ فقال جُبير: فَضَّ الله فاك، ألا تقول وأنا بالمكان الذي أنا به من بني عبد مناف …! فتبسم معاوية وأعرض عنه.
ووفد رجل من الأساورة على بعض ملوكهم فأقام ببابه حَولًا لا يصل إليه، فكلم الحاجب فأوصل له رقعةً فيها أربعةُ أسطر، الأول فيه: الأمل والضرورة أقدماني عليك. وفي الثاني: ليس على المُعدِم صبرٌ على المطالبة. وفي الثالث: رجوعٌ بلا فائدة شماتة العدو والقريب. وفي الرابع: إمَّا «نعم» مُثمِرة، وإمَّا «لا» مُؤيِسَة. ولا مَعنًى للحجاب بينهما.
وأنشدني أحمد بن أبي فنن بن محمد بن حمدون بن إسماعيل:
ولَقَدْ رَأَيْتُ بِبَابِ دَارِكَ جَفْوَةً
فِيهَا لِحُسْنِ صَنِيعَةٍ تَكْدِيرُ
مَا بَالُ دَارِكَ حِينَ تَدْخُلُ جَنَّةً
وبِبَابِ دَارِكَ مُنْكَرٌ ونَكِيرُ
وأنشدني أبو علي الدرهمي اليمامي في أبي الحسن علي بن يحيى:
لَا يُشْبِهُ الرَّجُلُ الكَرِيمُ نِجَارُهُ
ذَا اللَّبِ غَيْرَ بَشَاشَةِ الحُجَّابِ
وبِبَابِ دَارِكَ مَنْ إذَا مَا جِئْتُهُ
جَعَلَ التَّبَرُّمَ والعَبُوسَ ثَوَابِي
أَوْصَيْتَهُ بِالإذْنِ لِي فَكَأَنَّمَا
أَوْصَيْتَهُ مُتَعَمِّدًا بِحِجَابِي
وأنشدني أبو علي البصير فيه أيضًا:
فِي كُلِّ يَوْمٍ لِي بِبَابِكَ وَقْفَةٌ
أَطْوِي إلَيْهَا سَائِر الأَبْوَابِ
فإذَا حَضَرْتُ رَغِبْتُ عَنْكَ فَإنَّهُ
ذَنْبٌ عُقُوبَتُهُ عَلَى البَوَّابِ
وأنشدني أبو علي اليمامي، وعاتب بعض أهل العسكر في حاجته فلم يأذن له الحاجب بعد ذلك، فكتب إليه:
صَارَ العِتَابُ يَزِيدُنِي بُعْدًا
ويَزِيدُ مَنْ عَاتَبْتُهُ صَدًّا
وإذَا شَكَوْتُ إلَيْهِ حَاجِبَهُ
أَغْرَاهُ ذَاكَ فَزَادَنِي رَدًّا
وأنشدت لابن أبي عيينة المهلبي، واسمه عبد الله بن محمد، يعاتب رجلًا من قومه:
أَتَيْتُكَ زَائِرًا لِقَضَاءِ حَقٍّ
فَحَالَ السِّتْرُ دُونَكَ والحِجَابُ
ولَسْتُ بِسَاقِطٍ فِي قِدْرِ قَوْمٍ
وإنْ كَرِهُوا كَمَا يَقَعُ الذُّبَابُ
ورَائِي مَذْهَبِي عَنْ كُلِّ نَاءٍ
بِجَانِبِه إذَا عَزَّ الذَّهَابُ
وأنشدني ابن أبي فنن:
مَا ضَاقَتِ الأَرْضُ عَلَى رَاغِبٍ
فِي طَلَبِ الرِّزْقِ ولَا رَاهِبِ
بَلْ ضَاقَتِ الأَرْضُ عَلَى صَابِرٍ
أَصْبَحَ يَشْكُو جَفْوَةَ الحَاجِبِ
مَنْ شَتَمَ الحَاجِبَ فِي ذَنْبِهِ
فَإنَّمَا يَقْصِدُ لِلصَّاحِبِ
فارْغَبْ إلَى اللهِ وإحْسَانِهِ
لَا تَطْلُبِ الرِّزْقَ مِنَ الطَّالِبِ
قيل لِحُبَّةَ المدنية: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم لا يُجدي عليه. قيل لها: فما الذل؟ قالت: وقوف الشريف بباب الدنيء ثُم لا يؤذن له. قيل لها: فما الشرف؟ قالت: اعتقاد المنن في أعناق الرجال تبقى للأعقاب في الأحقاب.
وقيل لعروة بن عُدَي بن حاتم وهو صبي في وليمةٍ كانت لهم: قف بالباب فاحجب من لا تعرف وأدخل من تعرف. فقال: والله لا يكون أول شيء أستكفيه منع الناس من الطعام.
والحمدُ لله ربِّ العالمين
